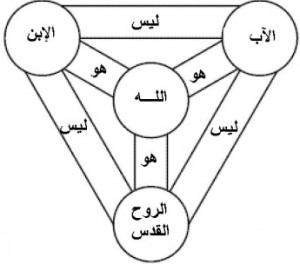ناس طيبون أو أناس جدد – سي إس لويس
ناس طيبون أو أناس جدد – سي إس لويس

ناس طيبون أو أناس جدد
نعم، لقد عنى الرب حقاً ما قاله. فإن أولئك الذين يضعون أنفسهم في يديه سيصيرون كاملين، كما أنه هو كامل… كامل في المحبة والحكمة والفرح والجمال والخلود. ولن يكتمل التغيير في هذا الحياة، لأن الموت جزء مهم من العلاج. أما المدى الذي سيكون التغيير قد بلغة قبل الوفاة في أي مسيحي بعينه فأمر غير مؤكد.
واعتقد ان اللحظة الحاضرة مُناسبة تماماً للنظر في سؤال غالباً ما يُطرح: إذا كانت المسيحية صحيحة فلماذا ليس جميع المسيحيين، كما هو واضح، أحسن خُلقاً من غير المسيحيين أجمعين؟ فما يكمن وراء هذا السؤال منطقي جداً في جزء منه، وغير منطقي البتة في الجزء الآخر. أما الجزء المنطقي فهو هذا: إذا كان الاهتداء إلى المسيحية لا يُحدث أي تحسين في أفعال الإنسان الخارجية (إذا ظلّ متصلفاً أو حاقداً أو حاسداً أو جشعاً كما كان من قبل) فأعتقد ان علينا أن نشك في حقيقة “اهتدائه” باعتبار كونه وهمياً إلى أبعد حد.
وبعد اهتداء المرء اهتداءً أصيلاً، فكلما حسب أنه أحرز تقدماً ما، يكون هذا هو المحك الذي ينبغي استخدامه. ذلك أن المشاعر الرقيقة والتبصرات الجديدة والاهتمام الزائد بأمور “الدين” لا تعني شيئاً ما لم تجعل سلوكنا الفعلي أفضل، تماماً كما أن “الشعور بالتحسن” في حال المرض لا يكون دليلاً خير إذا أشار ميزان الحرارة إلى أن حرارة المرء آخذه في الارتفاع. وعلى هذا النحو، فالعالم الخارجي على حق تماماً في الحكم على المسيحية بنتائجها. وقد علّمنا المسيح أن نحكم بحسب النتائج. فالشجرة تُعرف من ثمرها؛ أو كما نقول: “التجربة أكبر برهان”.
وعندما نُسيء نحن المسيحيين التصرف، أو نُخفق في أن نُحسن التصرف، نجعل المسيحية تبدو أمراً لا يُصدق في نظر العالم الخارجي. لقد ظهرت في زمن الحرب ملصقات كُتب عليها: “الكلام الطائش يُكلفك حياتك”. وكذلك صحيح بالمثل أن الحياة الطائشة تُكلف كلام انتقاد. ذلك أن عيشنا حياة طائشة يُطلق للعالم الخارجي عنان الكلام؛ ونحن نوفر لأهل العالم أساساً للتكلم بطريقة تُلقي الشك على حقيقة المسيحية عينها.
غير أن هناك طريقة أخرى في تطلب النتائج قد يكون العالم الخارجي غير منطقي فيها إلى أبعد حدّ. فربما لا يكتفون بأن يطلبوا وجوب تحسن حياة كل إنسان إذا صار مسيحياً، بل قد يطلبون أيضاً قبل أن يؤمنوا بالمسيحية أن يروا العالم مقسوماً بوضوح إلى معسكرين، مسيحي وغير مسيحي، وإن يكون جميع أهل المعسكر الأول في أية لحظة من اللحظات أشرف وألطف بكل جلاء من أهل المعسكر الثاني أجمعين. غير أن هذا غير عقلاني على أساس بضعة أسباب.
(1) في المقام الأول، الوضع في العالم الواقعي أكثر تعقيداً من ذلك. فليس في العالم من هم مسيحيون مئة بالمئة، ومن هم غير مسيحيين مئة بالمئة. فهناك أناس (وما أكثرهم) يكفون تدريجياً عن أن يكونوا مسيحيين ولكنهم ما يزالون يدعون أنفسهم بهذا الاسم، وبعضهم رجال دين. وهنالك آخرون يصيرون مسيحيين بالتدريج مع أنهم لا يدعون أنفسهم بهذا الاسم.
وهنالك أناس لا يقبلون كامل التعليم المسيحي عن المسيح، إلا أنهم منجذبون إليه بشكل قوي جداً بحيث يُعتبرون من خاصته بمعنى أعمق مما يفهمونه هم أنفسهم. وبين أتباع الأديان الأخرى أناس يرشدهم تأثير الله السري إلى التركيز على ما يوافق المسيحية في أديانهم، وهكذا ينتمون إلى المسيح على غير علم منهم. فإن بوذياً حسن النية مثلاً قد يُرشد إلى التركيز أكثر فأكثر على التعليم البوذي المتعلق بالرحمة، وإلى إبقاء التعاليم البوذية بشأن أمور أخرى في الناحية الخلفية (رغم أنه قد يقول إنه ما زال يؤمن بها).
وربما كان كثيرون من الوثنيين قبل ولادة المسيح بزمن طويل في هذا الموقع عينه. وثمة بالطبع في كل حين ناس كثيرون مُشوشو الذهن ولديهم كثير من المعتقدات المتضاربة مختلطة بعضها ببعض. وعليه، فليس من نفع كثير في محاولة إصدار أحكام على المسيحيين بصورة تعميمية. ثمة بعض النفع في مقارنة الخيل والجمال، أو حتى الرجال والنساء، على وجه الإجمال، لأنه في ذلك المجال يعرف المرء هؤلاء الواحد من الآخر بشكل واضح ومحدد. ثم إن حيواناً ما لا يتحول (لا تدريجياً ولا فجأة) من جمل إلى حصان.
ولكن حين نقارن المسيحيين عموماً بغير المسيحيين عموماً، لا نكون في العادة مفكرين أبداً في أناس حقيقيين نعرفهم، بل فقط في فكرتين غامضتين استمددناهما من الروايات والصحف. فإذا شئت أن تقارن بين المسيحي الرديء والملحد الصالح، يجب عليك أن تفكر في عينتين حقيقيتين قابلتهما فعلاً. فما لم ننزل إلى ساحة الحقائق الواقعية على هذا النحو، نكن كل ما نعمله هو إضاعة وقتنا سدىً.
(2) هَبنا نزلنا إلى ساحة الواقع ونحن لا نتحدث الآن عن مسيحي خيالي وغير مسيحي خيالي، بل عن شخصين حقيقيين في جوارنا. ففي هذه الحالة أيضاً ينبغي لنا أن نحرص على طرح السؤال الصحيح. إذ نقول: إذا كانت المسيحية صحيحة، فعندئذٍ لا بد أن يترتب على ذلك:
(أ) أن كل مسيحي سيكون ألطف وأشـرف مما كان من شأنه أن يكون لو كان غير مسيحي؛
(ب) أن أي إنسان يصير مسيحياً سيكون أحسن خلقاً مما كان قبلاً.
وعلى المنوال نفسه تماماً: إذا كانت دعايات معجون الأسنان المُبيض صحيحة، فعندئذ يترتب على ذلك حتماً:
(أ) أن أي شخص يستعمل هذا المعجون ستكون له أسنان أحسن مما كان ممكناً أن يكون له لم يستعمله؛
(ب) أن أي شخص يبدأ باستعماله ستتحسن أسنانه.
ولكن إشارتي إلى أنني أنا الذي أستعمل مُبيض الدعاية بعينه (وقد ورثث أيضاً رداءة الأسنان من والديّ كليهما) ليس لي مجموعة أسنان جيدة كالتي يملكها زنجي شاب قوي الصحة لم يستعمل قط أي معجون أسنان، إشارتي تلك في حد ذاتها لا تبرهن أن الدعايات باطلة: فالآنسة ليلي المسيحية المؤمنة قد يكون لديها لسان أسلط من لسان رضوان راضي غير المؤمن وذلك في ذاته لا يبين لنا هل تفعل المسيحية فعلها.
فالسؤال هو: كيف سيكون لسان الآنسة ليلى لو لم تكن مسيحية، وكيف سيكون لسان رضوان إذا صار مسيحياً بالحق. ذلك أن الآنسة ليلى ورضوان، من جراء أسباب طبيعية وتنشئة باكرة خاصة، لديهما مزاجان معيّنان: وتُصرح المسيحية بأنها تضع كلا المزاجين تحت إدارة جديدة، إذا سمح لها صاحباهما بأن تفعل ذلك. فما يجوز لك أن تسأله بحق هو هذا: هل تُحسن تلك الإدارة الحالة المعنية إذا سُمح لها باستلام الزمام؟ يعلم الجميع أن الإدارة قد قامت في حالة رضوان راضي بعمل “أفضل” مما قامت في حالة الآنسة ليلى. إنما ليس هذا بيت القصيد.
فلكي تحكم على إدارة مصنع ما، يجب عليك أن تأخذ في الحسبان لا الإنتاج وحده بل المُنشآت أيضاً. فبالنظر إلى مُنشآت المصنع “أ” قد يكون من العجيب أن يُنتج أي شيء على الإطلاق. وبالنظر إلى التجهيزات الممتازة في المصنع “ب”، قد يكون إنتاجه، ولو عالياً، أدنى بكثير مما كان ينبغي أن يكون. ولا ريب أن المدير الصالح في المصنع “أ” سيُركب مكنات جديدة بأسرع ما يمكن، ولكن ذلك يستغرق وقتاً. وفي أثناء ذلك، لا يبرهن الإنتاج المتدني أن صاحبه فاشل.
(3) والآن، لنبعد قليلاً إلى العمق. إن المدير سيُركب مكنات جديدة: فقبل أن يُنهي المسيح عمله في الآنسة ليلى، ستكون “فاضلة” حقاً. ولكن لو تركنا الأمر عند هذا الحد، لبدا كأن هدف المسيح الوحيد هو أن يدفع الآنسة ليلى صُعداً إلى المستوى نفسه الذي طالما كان رضوان على أحسن ما يُرام، وكما لو كانت المسيحية شيئاً يحتاج إليه الأردياء فيما يستطيع الطيبون أن يستغنوا عنه، وكما لو كانت دماثة الخُلق هي كل ما يطلبه الله.
ولكن هذه غلطة من شأنها ان تكون فاتكة. فالحق أن رضوان راضين في نظر الله، يحتاج إلى الخلاص كاحتياج الآنسة ليلى إليه تماماً. وبمعنى ما (سأشرح بعد قليل بأي معنى) لا تكاد دماثة الخُلق تتعلق بهذه المسألة.
لا يمكنك أن تتوقع من الله أن ينظر إلى طبع رضوان الهادئ ومزاجه الودود كما ننظر إليهما نحن تماماً. فهما ناتجان من أسباب طبيعية يخلقها الله نفسه. ولكونهما مزاجيين فقط، فإنهما يتلاشيان إذا أصيب رضوان بعسر هضم. ففي الواقع أن الدماثة هي عطية الله لرضوان، لا عطية رضوان لله.
وبالطريقة عينها، سمح الله لأسباب طبيعية، تعمل في عالم أفسدته قرون الخطية، بأن تُنتج لدى الآنسة ليلى ضيق خلق وتوتر الأعصاب اللذين إليهما يعُزى معظم رداءتها. وهو ينوي، في حينه، أن يُقوم حال ذلك الجانب. غير أن ذلك، في نظر الله، ليس الجانب الحاسم في القضية. فإنه لا يُثير أية صعوبات، وليس هو ما يهتم به الله بشدة. ذلك أن ما يترقبه ويتوقعه ويعمل لأجله هو أمر ليس سهلاً حتى عليه، لأنه بسبب طبيعة الحال حتى هو لا يُمكن أن يُنتجه بمجرد فعل من أفعال قدرته.
إنه يترقبه ويتوقعه لدى الآنسة ليلى ورضوان راضي كليهما. وهو أمر يمكن أن يُعطياه إياه بملء حريتهما، أو يرفضا أن يعطياه إياه بملء حريتهما، أو يرفضا أن يعطياه إياه بملء حريتهما: أيلتفتان راجعين إليه، وبذلك يتممان القصد الوحيد الذي لأجله قد خُلقا، أم لا يفعلان ذلك؟ إن حرية الإرادة تتذبذب في داخلهما كإبرة البوصلة. ولكن إبرتهما تستطيع أن تختار. يمكنها أن تدل إلى جهة شمالها الحقيقية؛ ولكن لا داعي لأن تفعل ذلك. فهل تترجح الإبرة دائرياً، ثم تستقر وتُشير إلى الله؟
إن الله قادر على مساعدة الإبرة للقيام بذلك، غير أنه لا يقدر أن يرغمها. إنه لا يقدر، إن صح التعبير، أن يمد يده ويُركز الإبرة على الوضع الصحيح، لأنه إذ ذاك تتعطل حرية الإرادة تماماً. فهل تُشير إلى الشمال؟ على هذا السؤال يتوقف كل شيء. هل يُقدم الآنسة ليلى ورضوان طبيعتها إلى الله؟ أما مسألة كون الطبيعتين اللتين يُقدمانهما، أو يتمسّكان بهما، حسنتين أو سيئتين في تلك اللحظة، فأمر ثانوي الأهمية. وفي وسع الله أن يُعنى بهذه المسألة.
لا تُسئ فهم ما أقول. فلا ريب أن لله يعد الطبع الرديء أمراً سيئاً يُرثى له. ولا ريب أنه يعد الطبع اللطيف أمراً صالحاً، صالحاً كالخُبز أو ضوء الشمس أو الماء. غير أن هذه هي الأمور الصالحة التي يسخو هو بها ونتلقاها نحن. فهو خلق أعصاب رضوان المتينة وهضمه السويّ، وما وراءهما من أسباب أو علل كثيرة. ولا يُكلف الله شيئاً، حسب علمنا، أن يخلق أشياء حسنة: ولكن تطويع الإرادات العاصية كلفه أن يُصلب. ولأنها إرادات، ففي وسعها، لدى الطيبين والخبثاء على السواء، أن ترفض طلبه. ثم أن الطيبة لدى رضوان، لأنها كانت مجرد جزء من طبيعته، ستتبدد تماماً في النهاية.
فالطبيعة نفسها سوف تمضي وتزول كلياً. والأسباب الطبيعية تتضافر معاً لدى رضوان لتُنتج نموذجاً سيكولوجياً حسناً، تماماً كما تتآلف معاً عند الغروب لتُنتج نموذج ألوان جميلاً. وعما قريب (لأنه هكذا تعمل الطبيعة أصلاً) سوف تتفرق ثانية ويضمحل النموذج في كلتا الحالين. وقد أُتيحت لرضوان الفرصة كي يُحول (أو بالحري كي يُسمح لله بأن يُحول) ذلك النموذج الوقتي إلى بهاء روح أبدي، غير أنه لم ينتهزها.
وهنا نقع على تناقض ظاهري. فما دام رضوان لا يرجع إلى الله، فهو يظن أن دماثته ملك له؛ وما دام يظن ذلك فهي ليست ملكه. ولكن عندما يدرك أن دماثته ليست من نتاجه بل هي عطية من عند الله، وعندما يُعيدها إلى الله، فعندئذ تماماً تبدأ بأن تصير بالحقيقة ملكاً له. وذلك لأن رضوان يبدأ الآن بأن يكون له نصيب في خلقه شخصياً من جديد. والأشياء الوحيدة التي يمكننا أن نصونها هي تلك الأشياء التي نقدمها لله بملء الحرية. وما نحاول أن نُبقيه لأنفسنا فمن المؤكد أننا سنخسره هو بذاته.
وعليه، فلا ينبغي أن نُفاجاً إذا وجدنا بين المسيحيين بالحق أشخاصاً ما زالوا خُبثاء. حتى إن هنالك سبباً (إذا فكرت في الأمر مليّاً) يحملنا على ترجيح رجوع الأشخاص الخُبثاء إلى المسيح بأعداد تفوق الطيبين إليه. وقد كان ذلك هو ما اعترض عليه الناس بشأن المسيح في أثناء حياته على الأرض: أنه على ما بدا يجتذب إليه “أناساً بالغي الرداءة”. وعلى هذا ما زال الناس يعترضون، وسيظلون دائماً يعترضون.
أفلا ترى السبب؟ لقد قال المسيح: “طوبى للمساكين (أي الفقراء)” وأيضاً “ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله!” ولا شك أنه عنى بالدرجة الأولى الفقراء مادياً والأغنياء ماديً.
ولكن إلا يصحُّ كلامه أيضاً على نوع آخر من الغنى والفقر؟ إن واحداً من أخطار امتلاك كثير من المال هو أنك قد تكتفي إلى أبعد الحدود بأنواع السعادة التي يمكن أن يوفرها لك المال، وهكذا يفوتك أن تدرك احتياجك لله. فإذا بدا أن كل شيء يأتيك بمجرد توقيع الشيكات، يمكن أن تنسى أنك في كل لحظة تعتمد على الله كليّاً. وواضح تماماً أن الهبات الطبيعية يصحبها خطر مماثل. فإن كانت لك أعصاب متينة وذكاء وصحة وشعبية ونشأة صالحة، يُرجح أن تكتفي إلى أبعد حد بخُلقك الذي أنت عليه. ولعلك تسأل: “لماذا آتي بالله إلى المسألة؟” إذ إن مستوى معيناً من السلوك الحسن يتأتى لك بسهولة معقولة.
فأنت لست واحداً من أولئك الخلائق التُعساء الذين يعقون دائماً في أحابيل الجنس، أو الإدمان على الكحول، أو الهياج العصبي، أو حدة الطبع. والجميع يقولون إنك إنسان طيب، وأنت توافقهم (بيني وبينك!).
فمن المرجح جداً أن تحسب أن هذه الطيبة كلها هي من صُنع يديك، ولعلك بسهولة لا تشعر باحتياجك إلى أي نوع من الصلاح أفضل. وغالباً ما يتعذر الإتيان بأولئك الأشخاص، الذين يملكون جميع هذه الأنواع الطبيعية من الصلاح، إلى إدراك احتياجهم إلى المسيح أصلاً، حتى يأتي يوم فيه يخذلهم صلاحهم الطبيعي وتتزعزع أركان اكتفائهم الذاتي. بعبارة أخرى: صعبُ على من كانوا “أغنياء” بهذا المعنى أن يدخلوا ملكوت الله.
إنما الحال تختلف كثيراً بالنسبة إلى الأشخاص الخُبثاء: الصغار، الأدنياء، الجبناء، المعوجين، قليلي الحياء، المعتزلين، أو ذوي الأهواء الجامحة، الشهوانيين، غير المتزنين. فإذا قام هؤلاء بأية محاولة لإتيان الصلاح أصلاً، يعلمون على وجه السرعة بأنهم يحتاجون إلى معونة.
فإما أن يتلقوا المعونة من المسيح، وإما لا ينفعهم أي شيء. إما يحملون الصليب ويتبعون المسيح، وإما يستولي عليهم اليأس المطبق. هؤلاء هم الخراف الضالة؛ وهو قد جاء خصوصاً كي يجدهم ويردهم. هؤلاء هم “المساكين”، أو الفقراء (بمعنى حقيقي ورهيب جداً): وهو قد طوّبهم، أو باركهم. إنهم “التشكيلة الرهيبة” التي يعاشرها المسيح المُحب، وما زال الفريسيون بالطبع يقولون، كما قالوا منذ البداية: “إن كان في المسيحية شيء ما، فهؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يكونوا مسيحيين حقاً”.
ولكل واحد منا ها هنا إما تحذير وإما تشجيع. فإذا كنت إنساناً طيباً، إذا وافتك الفضيلة بسهولة، فحذار! إن مَن أعطي الكثير يُطلب منه كثير. فإن توهمت أن ما كان بالحقيقة هبات الله من خلال الطبيعة هو فضائل أو حسنات شخصية فيك، وإن كنت مكتفياً بمجرد كونك لطيفاً وشريفاً، فأنت ما زلت متمرداً عاصياً: وجميع هذه الهبات لن تؤول إلا إلى جعل سقوطك أرهب، وفسادك أدهى، وقدوتك السيئة أكثر هولاً. ولقد كان إبليس فيما مضى ملاكاً رئيساً، وكانت هباته الطبيعية أسمى بكثير من هباتك، كسُمو هباتك على هبات الشمبانزي!
وكلن إذا كنت مخلوقاً بئساً، سمَّمتك تربية سيئة في بيت من البيوت حافل بالمحاسدات المبتذلة والمخاصمات التافهة، مُبتلى على رُغمك بشذوذ جنسي مقيت، تقض مضجعك يوماً بعد يوم عقدة نقص تجعلك خشناً مع أفضل أصدقائك وتسخط عليهم، فلا تيأسّ! إن الله عليم بحالك تماماً.
وأنت واحد من المساكين (الفقراء) الذين طوبهم أو باركهم. وهو يعلم أي مكنة رديئة تحاول أن تُشغلها. فواظب على ما تحاوله، وابذل ما في وسعك. إنه ذات يوم (ربما في العالم الآتي، ولكن ربما أقرب من ذلك بكثير) سوف يرمي بتلك المكنة في كومة النفايات ويعُطيك مكنة جديدة. وعندئذ سوف تُذهلنا جميعاً، إذ لن تكون أنت نفسك بأدنى حد، ما دمت قد تعلمت تشغيل المكنة في مدرسة قاسية (بعض الآخرين سيكونون أولين؛ وبعض الأولين سيكونون آخرين!)
إن “الطيبة” أو الدماثة (أي الشخصية السليمة الكاملة) هي أمرُ ممتاز. وعلينا أن نسعى بكل وسيلة في طاقتنا، طبية وتربوية واقتصادية وسياسية، لإنتاج عالم ينشأ فيه أكبر عدد ممكن من الناس “الطيبين”، مثلما ينبغي أن نحاول إنتاج عالم فيه يتوفر للجميع ما يأكلونه. ولكن يجب ألا نفترض أنه حتى لو نجحنا في جعل كل امرئ طيباً نكون قد خلّصنا نفوس الجميع. فإن عالماً من الناس الطيبين، الراضين بطبيعتهم الذاتية، غير الناظرين إلى أبعد من ذلك، المبتعدين عن الله بعيداً، سيكون في أمس الحاجة إلى الخلاص مثله مثل عالم تعس، بل إن خلاصة قد يكون أصعب بكثير.
ذلك أن مجرد التحسين ليس فداءً، مع أن الفداء دائماً يُحسن الناس في الزمان والمكان الحاليين، وسوف يحسنهم في النهاية إلى درجة لا يمكننا تصورها بعد. فقد صار الله إنساناً ليحول الخلائق أبناءً: ليس فقط كي يُنتج أناساً من النوع القديم أفضل، بل ليُنتج إنساناً من نوع جديد. ولا يُشبه ذلك تعليم حصان أن يثب أفضل ثم أفضل، بل يشبه تحويل الحصان إلى كائن مُجنح.
وبالطبع، ما أن يصير له جناحان، حتى يُحلق حتماً فوق حواجز ما كان ممكناً قط أن يقفز فوقها، وبذلك يتغلب على الحصان الطبيعي في رياضته الخاصة. ولكن قد تمر فترة زمنية، فيما الجناحان ما يزالان في أول عهدهما بالنمو، لا يستطيع فيها الحصان أن يفعل ذلك: وفي تلك المرحلة قد يبدو منظر الحصان غريباً جداً لوجود ذينك النتوءين على كتفيه، ولا سيما لأن أحد لن يقدر أن يُنبئ عند النظر إليهما بأنهما سيكونان جناحين.
ولكن ربما نكون فعلاً قد استفضنا كثيراً في هذا النقطة. فإذا كان ما تريده حجة ضد المسيحية (وأنا أذكر جيداً كيف التمست بشوق حججاً من هذا النوع لما بدأت أخشى ان تكون المسيحية صحيحة) يمكنك بسهولة أن تعثر على مسيحي غرّ وغير مُرض فتقول: “هو ذا إنسانكم الجديد الذي تتباهون به! أعطوني واحدا ً من النوع القديم”.
ولكنك إن كنت قد بدأت ترى المسيحية معقولة على أسس أخرى، فستعرف في قلبك أن قولك هذا لا يعدو كونه هروباً من المسألة. فماذا يمكنك أن تعرف على الإطلاق عن نفوس الآخرين، عن تجاربهم وفُرصهم وصراعاتهم؟ ثمّة في الكون كله نفس واحدة تعرفها حقاً، ألا وهي النفس الوحيدة التي مصيرها بيدك. وإذا كان الله موجوداً فأنت، بمعنى ما، وحدك في حضرته.
وليس في وسعك أن تدفعه بعيداً عنك بتحزراتك عن جارك المُجاور أو بذكرياتك عما قرأته في الكتب. فأية قيمة لتلك الثرثرة والإشاعات (أو يمكنك حتى تذكرها؟) عندما تضمحل تلك الغمامة المخدرة التي نسميها “الطبيعة” أو “العالم الطبيعي”، وتغدو الحضرة التي ما برحت واقفاً فيها كل حين ملموسة ومباشرة ووقعاً لا سبيل إلى اجتنابه؟