الإيمان – سي إس لويس
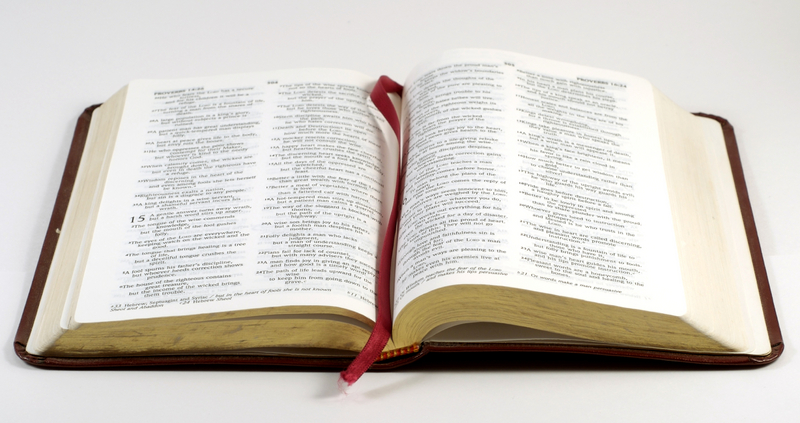
الإيمان – سي إس لويس
أريد أن أبدأ بقول شيء أود أن يلاحظه كل فرد بدقة وانتباه. وهذا هو: إن لم يعن هذا الفصل لك شيئاً، وإن بدا لك أنه يحاول أن يجيب عن أسئلة لم تطرحها قط، فاصرف نظرك عنه حالاً، ولا تقلق بشأنه أبداً. ففي المسيحية أمور معينة يمكن فهمها من الخارج، قبل أن تصير مسيحياً حقيقياً. ولكن فيها أمور أكثر بكثير لا يمكنك أن تفهمها إلا بعد أن تكون قد قطعت شوطاً ما على الطريق المسيحي وهي الأمور عملية محض، ولو كانت تبدو كذلك.
إنها توجيهات للتصدي لمفارق طُرق وعقبات معيّنة في أثناء الرحلة، وهي غير ذات معنى إلا بعد وصول المرء إلى تلك الأماكن. فكلما وجدت أية عبارة في الكتابات المسيحية لا تعني لك شيئاً فلا تقلق، بل دعها وشأنها. إذ سوف يأتي يوم، ربنا بعد عدة سنين، فيه تفهم فجأة ما تعنيه، وإذا تيسّر للمرء فهمها الآن، فإنها تضر به فحسب.
وبالطبع أن هذا كله يضع عقبة أمامي وأمام أي شخص آخر على السواء. فقد يكون ما أحاول تفسيره في هذا الفصل أبعد من منالي. وربّما حسبتُ أنني وصلت إلى هناك وأنا لم أصل بعد. فليس في وسعي إلاّ أن أطلب من المسيحين المُتنورين أن يراقبوني عن كثب، ويقولوا لي أين أخطئ؛ ومن الآخرين أن يقبلوا ما أقوله بشيء من التحفُّظ، على أنه أمر أعرضه لأنه قد يكون مفيداً، لا لأني متيقن بأنني على حق. إنني أسعى إلى التكلم عن الإيمان بالمعنى الثاني، وهو الأسمى.
وكنت قد قلت آنفاً إن مسألة الإيمان، بهذا المعنى، تنطرح بعد أن يكون الشخص قد بذل أقصى جهده لممارسة الفضائل المسيحية فتبين له أنه مُخفق وأدرك أنه حتى لو نجح لكان يرد إلى الله ما هو لله أصلاً. وبكلمة أخرى، فهو يكتشف إفلاسه. والآن، تقول مرة أخرى إن ما يعنى الله ليس هو أفعالنا على وجه التحديد. فما يهمه أن نكون خلائق من نوع أو صنف معين: الخلائق الذين قصد لنا أن نكونهم، خلائق مرتبطين به بطريقة معيّنة.
ولست أُضيف: “ومرتبطين بعضهم ببعض بطريقة معيّنة”، لأن ذلك مشمول ضمناً: فإذا كنت على علاقة صحيحة به، فلا بد حتماً أن تكون على علاقة صحيحة بجميع الخلائق المُماثلين لك، تماماً كما يحصل حين تكون قضبان العَجَلة مُثبتة في مكانها الصحيح داخل المحور والإطار، إذ لا بد ان تكون حينذاك في مواقعها الصحيحة أحدها من الآخر.
وما دام الإنسان يفكّر في الله في ممتحِن أعدَّ له ورقة أسئلة عليه الإجابة عنها، أو في فريق آخر في صفقة أو اتّفاقية ما، ما دام يفكّر في مطالب ومطالب مقابلة بينه وبين الله، فلا يكون قد دخل بعد في علاقة صحيحة به تعالى. إنه يُسيء فهم ماهيته وماهية الله. ولا يمكنه أن يدخل في علاقة صحيحة قبل أن يكتشف حقيقة إفلاسنا جميعاً.
وعندما أقول “يكتشف”، أعني بالحقيقة “يكتشف”، لا أن يقول ذلك كالببغاء. فإن أي ولد طبعاً، إذا تلقى تربية دينية معينة، سيتعلم سريعاً أن يقول إنه ليس لدينا شيء نقدمه إلى الله لا يكون له أصلاً، وإننا نجد أنفسنا مُخفقين في أن نقدم حتى ذلك دون أن نحتفظ بشيء ما في المقابل. غير أنني أتكلم عن اكتشاف هذا الأمر حقاً: إن أتبين أنه صحيح من طريق التجربة أو الاختبار.
إنما لا يمكننا من ذلك القبيل، أن نكتشف عجزنا عن حفظ قانون الله إلا ببذل أقصى جهدنا فعلاً (ومن ثم بفشلنا). وما لم نحاول ذلك حقاً، فمهما قلنا تبقى في قعر عقولنا دائماً الفكرة القائلة بأننا إن بذلنا جهداً أوفر في المرة التالية فسننجح في أن نكون صالحين تماماً. وهكذا، من جهة، فإن طريق الرجوع إلى الله هو طريق جهاد خلقي، أي بذل جهد مُضاعف بعد جهد. ولكن من جهة أخرى ليس بذل الجهد هو ما سيوصلنا إلى مقصدنا أبداً.
فكل ذلك الجهاد سيُفضي بك إلى اللحظة الحاسمة التي فيها تلتفت إلى الله وتقول: “لابد أن تتولى أنت الأمر، فأنا لا أقدر عليه”. وأناشدكم ألا تبدأوا تسألون أنفسكم: “هل بلغت هذه اللحظة؟” فلا تقعد وتباشر مراقبة ذهنك لترى هل هي آتية. إن هذا يضع قدميك تماماً على الطريق الخطأ. فعندما تحصل أهم الأمور في حياتنا، يكاد يكون في الغالب تماماً، في اللحظة عينها، ألا ندري بما يجري. فالإنسان لا يقول لنفسه دائماً: “مرحى! إنني أنمو”. فغالباً حين ينظر إلى الوراء، يدرك حينئذٍ فقط ما قد جرى، ويميّزه على أنه ما يدعوه الناس “نمواً”.
وفي وسعك أن تتبين هذا في القضايا اليسيرة أيضاً. فالإنسان الذي يبدأ بتشوق وتوتر مراقبة نفسه ليتبين هل يوشك أن ينام يُرجّح له جداً أن يظل مستيقظاً تماماً. وكذلك أيضاً ما أتحدث عنه الآن ربما لا يحدث لكل إنسان في لحظة خاطفة مفاجئة، مثلما حدث للرسول بولس أو أغسطينوس أو جان بنيان؛ بل قد يكون تدريجياً للغاية بحيث لا يستطيع أمرؤُ أن يُحدد ساعة معينة، ولا حتى سنة معينة. وما يهم فعلاً هو طبيعة التحول في ذاته، لا ما نشعر به عند حدوثه. إنه التحول عن كوننا واثقين بجهودنا الشخصية إلى الحالة التي فيها نيأس من القيام بأي شيء بأنفسنا ونضع الأمر كله في يد الله.
في علمي أن التعبير “نضع الأمر كله في يد الله” يمكن أن يُساء فهمه، ولكن ينبغي أن يبقى على حاله الآن. فالمعنى المقصود من وضع المسيحي للأمر كله في يد الله أنه يضع كامل ثقته في المسيح، واثقاً بأن المسيح سوف يُشركه بطريقة ما في الطاعة البشرية الكاملة التي عاشها منذ ولادته حتى صلبه، وبأن المسيح سيجعل الإنسان أشبه به، وبمعنى ما يسد نقصاته. وبتعبير مسيحي، فإن المسيح سيُشركنا في “بنوته”، أي يجعلنا “أبناء الله” مثل شخصه. (سأحاول في الباب الرابع تحليل معنى هذه الكلمات أكثر قليلاً).
وإن شئت التعبير عن الأمر بطريقة أخرى، أقول إن المسيح يعرض أن يقدم لنا شيئاً مقابل لا شيء، بل إنه يقدم لنا كل شيء مقابل لا شيء. وبمعنى ما، فإن قوام الحياة المسيحية كلها هو قبول هذه العطية الرائعة جداً. إنما الصعوبة كامنة في بلوغنا النقطة التي فيها ندرك أن كل ما فعلناه وما يمكن أن نفعله هو لا شيء. وما كنا نوده هو لو يحسب لنا الله علاماتنا الجيدة ويغض النظر عن السيئة. وهنا أيضاً يمكننا، بطريقة ما، أن نقول إننا لن نستطيع دحر أية تجربة أبداً قبل أن نكف عن محاولة دحرها، مُعلنين استسلامنا.
إلا أنك أيضاً لن تستطيع أن “تكف عن المحاولة” بالطريقة الصحيحة والسبب الصحيح، إلا بعد أن تكون قد بذلت أقصى جهدك فعلاً. ثم إن تسليم المسيح كل شيء، بمعنى آخر بعد، لا يعني بالطبع أن تكف عن المحاولة. فأن تثق به يعني أن تحاول القيام بكل ما يقوله طبعاً.
ولا يكون أي معنى لقولك إنك تثق بشخص إن كنت لا تقبل نصيحته. وعليهن فإن كنت حقاً قد سلمته ذاتك، يترتب على ذلك حتماً أنك تحاول أن تطيعه. ولكن المحاولة هنا تكون بطريقة جديدة، بطريقة أقل قلقاً وتوجسا. ليس أن تقوم بهذه الأمور لكي تخلص، بل لأنه قد مد إليك يد الخلاص فعلاً. ليس أن تأمل بالذهاب إلى السماء مكافأة لك على أفعالك، بل أن ترغب حتماً في التصرف بطريقة معينة لأن ومضة أولى طفيفة من السماء باتت داخلك فعلاً.
ولطالما تجادل المسيحيون فيما يؤدي إلى الموطن المسيحي: أهو الأعمال الصالحة أم الإيمان بالمسيح؟ وليس من حقي في الواقع ان أتكلم في هذه المسألة الصعبة، إنما يبدو الأمر في نظري شبيهاً بالسؤال: أي شفرتي المقص أكثر ضرورة؟ فالجهد الخُلقي الجدي هو الشيء الوحيد الذي يوصلك إلى حيث تُعلن استسلامك. والإيمان بالمسيح هو الشيء الوحيد الذي ينقذك من اليأس إذ ذاك؛ ومن ذلك الإيمان به لا بد أن تأتي الأعمال الصالحة حتماً. وثمة مقولتان ساخرتان تُحرّفان الحق اتهمت فئتان مسيحيتان مختلتان في الماضي من قِبَل باقي المسيحيين بأنهما تؤمنان بهما.
فلعل هاتين المقولتين تجعلان الحق أوضح. فإن فئة اتهمت بأنها تقول: “الأعمال الصالحة هي كل ما يهم. وأفضل عمل صالح هو المحبة. وخير تعبير عن المحبة هو التصدق بالمال. وأفضل مكان نُقدم له المال هو الكنيسة. فأعطونا إذاً 10,000 جنيه، ونحن نتكفّل بآخرتكم السعيدة”.
أما الرد على هذا الهراء فيكون بالطبع أن الأعمال الصالحة إذا أُديت بذلك الدافع، ووراءها الفكرة القائلة بأن السماء يمكن أن تُشترى شراءً، فلن تكون أعمالاً صالحة البتة، بل مجرد مُضاربات تجارية. أما الفئة الأخرى فقد اتُهمت بأنها تقول: “الإيمان هو كل ما يهم. وعليه، فإذا كان لديك إيمان، فلا يهم ماذا تفعل. امضى في الخطية، يا بني، واقض وقتاً طيباً، والمسيح سيتكفل بألا يُبدل ذلك مصيرك في شيء آخر الأمر”. أما الرد على هذا الهراء فهو هذا: إن كان ما تدعوه “إيمانك” بالمسيح لا ينطوي على أدنى مراعاة منك لما يقوله، فهو لا يكون إيماناً البتة، وليس إيماناً أو ثقة به، بل مجرد قبول عقلي لنظرية ما مختصة به.
ويبدو في الحقيقة أن الكتاب المقدس يحسم المسألة حيث يضع الأمرين كليهما معاً في عبارة واحدة مدهشة. فالنصف الأول هو: “تمموا خلاصكم بخوف ورعدة”، مما يُظهر كأن كل شيء يتوقف علينا وعلى أعمالنا الصالحة. ولكن النصف الثاني يمضي ليقول: “لأن الله هو العامل فيكم”، مما يُظهر كأن الله يقوم بكل شيء فيما لا نفعل نحن شيئاً.
وأخشى أن يكون هذا من الأمور التي نثور عليها في المسيحية. ولئن تحيّرت، فلن أدهش. فأنت ترى أننا نحاول الآن أن نستوعب الأمر، وأن نفصل في حُجرتين ضابطتين للماء بين ما يفعله الله تماماً وما يفعله الإنسان تماماً، في حين ان الله والإنسان يعملان معاً.
وطبعاً، نبدأ بالتفكير في ذلك كما لو أن إنسانين يعملان معاً، بحيث يمكنك أن تقول: “هو فعل ذلك، وأنا فعلت هذا”. غير أن طريقة التفكير هذه تنهار. فالله ليس كذلك، إذ أنه في داخلك وخارجك على السواء. هكذا، فحتى لو تسنى لنا أن نعرف مي يقوم بماذا، فلست أعتقد أن لغة البشر تستطيع أن تعبر عن ذلك حق التعبير.
وفي محاولة التعبير عنه، تقول مختلف الكنائس أشياء مختلفة. ولكنك ستجد أنه حتى أولئك الذين يصرّون أشد الإصرار على أهمية الأعمال الصالحة يقولون لك إنك تحتاج إلى الإيمان؛ وحتى أولئك الذين يصرون أشد الإصرار على وجوب الإيمان يقولون لك أن تعمل أعمالاً صالحة. وعلى كل حال، هذا هو الحد الذي يمكنني الذهاب إليه.
وأعتقد أن من شأن جميع المسيحيين أن يوافقوني إذا قلت إنه ولو بدت المسيحية أول الأمر معنية كلها بالأخلاق، وكذلك بالواجبات والقواعد والذنب والفضيلة، فهي مع ذلك تمضي بك قُدماً، خارج ذلك كله، إلى ما هو أبعد. ولدي لمحة على بلد لا يتحدث أهله عن هذه الأمور، إلا على سبيل الدعابة على الأرجح. وكل شخص هناك مملوء إلى التمام بما يمكننا أن ندعوه صلاحاً كما أن المرأة مملوءة نوراً.
غير أنهم لا يدعون ذلك صلاحاً، بل لا يدعونه أي شيء. فهم لا يفكرون فيه. إنهم مشغولون تماماً بالنظر إلى المصدر الذي منه ينبعث الصلاح. ولكن ذلك البلد قريب من المحطة التي عندها تمر الطريق فوق محيط عالمنا. فلا تستطيع عينا إي إنسان أن تريا بعيداً ما وراء ذلك، وإن كانت عيون كثيرين تستطيع أن ترى أبعد مما ترى عيناي.
