الأخلاق المتعلقة بالجنس – سي إس لويس
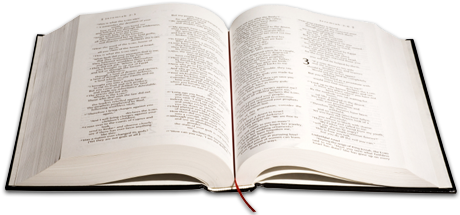
الأخلاق المتعلقة بالجنس – سي إس لويس
ينبغي لنا أن ننظر في المفهوم الأخلاقي المسيحي للجنس وهو، ما يدعوه المسيحيون فضيلة العفاف. وعلينا ألا نخلط بين قاعدة العفاف المسيحية والقاعدة الاجتماعية الخاصة “بالاحتشام” (بأحد معاني الكلمة)، أي اللياقة أو التأدب. فقاعدة الاحتشام الاجتماعية تُقرر أي مقدار من جسد الإنسان يليق كشفه، وأية مواضيع يمكن التطرق إليها، وبأي كلام، بحسب عوائد اجتماعية معينة. وعليه فبينما تبقى قاعدة العفاف هي إياها بالنسبة إلى جميع المسيحيين في كل زمان، فإن قاعدة الحشمة تتغير.
فالشابة في جزر المحيط الهادئ، وهي بالكاد تستر عريها، والسيدة الغربية المحافظة الي تغطي كامل جسدها بثوبها، يمكن أن تكونا كلتاهما “محتشمتين” أو متأدبتين، أو لائقتين، بحسب معاير مجتمعيهما، وكلتاهما، رغم كل ما يمكن أن نستنتجه من لباسهما، قد تكون عفيفة على السواء (أو غير عفيفة على السواء). وبعض الكلمات التي استخدمتها النساء العفيفات في أيام شكسبير، ما كانت لتستخدمها في القرن التاسع عشر إلا النساء المتهتكات.
وعندما يُخالف الناس قاعدة الحشمة الجارية في زمانهم ومكانهم، فإذا فعلوا ذلك لإثارة الشهوة لدى أنفسهم أو لدى الآخرين، فهم عندئذ ينتهكون أصول العفاف. ولكنهم إذا خالفوا الحشمة بدافع الجهل أو قلة الاحتراز، فإن ذنبهم يقتصر على سوء الأدب. ولكن حين يخالفونها، كما يحدث غالباً، بدافع التحدي كيف يُفاجئوا الآخرين أو يُربكونهم، لا يكون بالضرورة غير أعفاء، غير أنهم يكونون مُسيئي التصرف: لأن من الشائن أن يطلب المرء متعته بإحراج الآخرين وإزعاجهم.
ولست أعتقد أن وجود معيار حشمة متشدد أو متزمت يُبرهن في شيء على العفة أو يُعين على تعزيزه بأي مقدار، ومن هنا أحسب أن تلطيف قاعدة الحشمة أو تيسيرها، وهو ما يحصل في أيامي، هو أمر خير. غير أنها، في مرحلتها الحالية، تشكو من هذا العائق: أن ذوي الأعمار المختلفة والمشارب المتباينة لا يقرون جميعهم بالمعيار نفسه، ولا نكاد نعرف موقعنا الفعلي.
فبينما الحال على هذا المنوال، أعتقد أن على كبار السن، أو المحافظين على العوائد، أن يحترسوا جيداً من حسبان الشباب أو “المتحررين” فاسدين خُلقياً حينما لا يُراعون المألوف (حسب المعيار القديم)؛ وفي مقابل ذلك، ينبغي للشبان ألا يدْعوا شيوخهم مُتزمتين أو طهوريين مُدققين لأنهم لا يتقبلون المعيار الجديد بسهولة. ومن شأن الاستعداد الحقيقي لظن كل خير تستطيعه في الآخرين، وجعلهم مستريحين بقدر ما تستطيع، أن يحل معظم المشاكل.
إن العفة هي الفضيلة الأقل شعبية بين الفضائل المسيحية. فلا مناص منها؛ إذا تقول القاعدة المسيحية: “إما الزواج، مع الأمانة الكلية لشريك الحياة؛ وإما الامتناع الكلي عن الجنس” وهذا صعب ومعاكس جداً لغرائزنا، بحيث يكون من البديهي أن تكون إما المسيحية وإما غريزتنا الجنسية، على ماهي عليه الآن، قد ضلت السبيل. نعم، إما هذه وإما تلك. ولكوني مسيحياً، فأنا طبعاً أعتقد أن الغريزة الجنسية هي التي ضلت السبيل.
ولكن لديّ غير هذا من أسباب اعتقادي ذلك. فالغاية البيولوجية من الجنس هو الإنجاب، كما أن الغاية البيولوجية من الاغتذاء هي ترميم الجسم. فإذا أكلنا كلما شعرنا بميل إلى الأكل، وأكلنا بقدر ما نريد، فصحيح تماماً أن كثيرين منّا سيأكلون كثيراً، إنما ليس كثيراً على نحو هائل. إذ إن شخصاً واحداً قد يأكل حصة اثنين، إلا أنه لن يأكل حصة عشرة. فالشهوة تتخطى غايتها البيولوجية قليلاً، إنما ليس إلى حدّ مروع. ولكن إذا انغمس شاب قوي الصحة في إشباع شهوته الجنسية كلما عن له ذلك، وإذا أنتج كل فعل طفلاً، ففي غضون عشر سنين يمكن أن يُعمر قرية صغيرة بكل سهولة.
فهذه الشهوة ذات إسراف غريب ونادر من حيث وظيفتها.
أو للنظر إلى الأمر من زاوية أخرى. يمكنك أن تحشد جمهوراً لا بأس به لمشاهدة عرض تعرِّ، أي لمشاهدة شابة تتعرى تدريجياً على المسرح. فافترض الآن أنك ذهبت إلى بلد يمكنك فيه أن تملأ كراسي مسرح بمجرد عرض طبق مغطى على المسرح، ومن ثم برفع الغطاء على مهل بحيث يرى الجميع، قُبيل إطفاء الأضواء تماماً، أن فيه قطعة من لح الغنم أو شريحة من لحم البقر، أفلا تعتقد عندئذ أن خللاً قد طرا على شهوة الأكل؟ أوَلا يظن أي شخص نشأ في عالم آخر آن أمراً غريباً على نحو مماثل طرأ على حالة الغريزة الجنسية بيننا؟
قال أحد النقاد إنه لو وجد بلداً تشيع به أفعال تعر من هذا النوع بالنسبة إلى الطعام، لاستنتج أن أهل ذلك البلد يتضورون جوعاً. وقد عنى بالطبع التلميح إلى أن أموراً مثل عروض التعري لا تنتج من الفساد الجنسي، بل من الحرمان الجنسي. فأنا أوافقه أنه لو وجدنا في بلد غريب أن أفعالاً مماثلة بشرائح اللحم شائعة، فأحد التفسيرات التي تتبادر إلى ذهني سيكون وجود مجاعة. ولكن الخطوة التالية تقضي بأن أختبر فرضيتي بالتحقق من مقدار الطعام المُستهلك في البلد فعلاً: أكثير هو أم قليل؟ فإذا بين التحقق أن مقداراً لا بأس به يُستهلك، فعلينا عندئذ بالطبع أ، نتخلى عن فرضية المجاعة ونحاول التفكير في سواها.
على المنوال نفسه، قبل أن نقبل الحرمان الجنسي سبباً للتعري ينبغي لنا أن نبحث عن بينة على وجود تقشف جنسي في عصرنا يفوق في الواقع ذاك الذي كان شائعاً يومن لم يكن التعري معروفاً. ولكن مثل هذه البينة غير موجودة بكل يقين. فموانع الحمل جعلت الإشباع الجنسي داخل نطاق الزواج أقل كلفة بكثير، وخارج نطاقه أكثر أماناً بكثير، مما كانت عليه الحال في أي وقت مضى؛ وبات الرأي العام في الغرب أقل عداءً للعلاقات غير الشرعية، بل للشذوذ أيضاً، مما كان عليه كل حين منذ الأزمنة الوثنية.
ثم أن فرضية الجوع أو الحرمان ليست الوحيدة التي يمكننا أن نتصورها. فكل إنسان يعرف أن الشهوة الجنسية، شأنها شأن شهواتنا الأخرى، تنمو بالإشباع. ذلك أن الجياع يفكرون كثيراً بالأكل، ولكن النهمين يفعلون ذلك أيضاً؛ والمُتخمون كما المحرومون يهوَون الدغدغة.
إليك نقطة ثالثة. لن تجد إلاّ عددا قليلاً من الناس ممن يرغبون في أكل أشياء ليس طعاماً بالحقيقة، أو في استعمال الطعام لأشياء أخرى غير الأكل. بعبارة أخرى، إن ضروب الشذوذ في شهوة الطعام نادرة. ولكن ضروب الشذوذ في الشهوة الجنسية عديدة، وصعبة الشفاء، ومروّعة. آسف لأن أضطر إلى الدخول في هذه التفاصيل كلها، لكن لا بد لي من ذلك. أما سبب اضطراري إلى ذلك، فهو أننا، أنا وأنتم، ما برحنا على مدى السنين العشرين الماضية نُلَّقن طوال اليوم أكاذيب غبية عن الجنس.
فكم يسمع الواحد منا، حتى يكاد يمرض، أن الرغبة الجنسية هي في حالة سائر الرغبات عيناها، وأننا لو أقلعنا فقط عن فكرة كبتها التقليدية، لكان كل ما في “الجنة” مُبهجاً. غير أن هذا ليس بصحيح. فحالما تنظر إلى الحقائق، بعيداً عن الدعايات، ترى أنه باطل.
يقولون لك أن الجنس صار مشكلة لأنه تعرض للكبت. ولكن على مدى العشرين سنة الماضية، لم يكن مكبوتاً. فلطالما تجري الثرثرة عنه طوال اليوم ومع ذلك ما زال في ورطة وحالة من التشويش. فلو كان الكبت قد سبب المشكلة، لكان التفريخ قليلاً عنه أصلح حاله، غير أنه لم يصلحها. فأعتقد أن العكس هو الصحيح. إذ أعتقد أن الجنس البشري كبت الجنس لأنه كان قد صار مشكلة كبيرة. أما معاصرونا فيقولون دائماً: “ليس ما يدعو إلى الخجل في حقيقة كون الجنس البشري يتكاثر بطريقة معينة، ولا في كونه يؤتي لذّة” وإذا كان هذا ما يعنونه، فهم على حقّ.
فالمسيحية تقول بمثل هذا: أن المشكلة ليست في الأمر نفسه، ولا في اللذة. وقد قال المعلمون المسيحيون القدامى إنه لو أن الإنسان لم يسقط قط، لكانت اللذة الجنسية أقوى بكثير فعلاً. بدلاً من كونها أقل مما هي عليه الآن. في علمي أن المسيحيين المشوشي الذهن قد تكلموا كما لو أن المسيحية تعتبر الجنس أو الجسد أو اللذة سيئة في ذاتها. غير أنهم كانوا على خطأ. فالمسيحية تكاد أن تكون من بين الديانات الكبرى الوحيدة التي تمدح الجسم البشري.
والتي ترى أن المادة خيرة، وتؤكد أن الله نفسه اتخذ جسداً إنسانياً ذات مرة، وإن جسماً من نوع ما سيُعطى لنا في السماء وسيكون عنصراً جوهرياً في سعادتنا وبهائنا وطاقتنا. وقد مجدت المسيحية الزواج أكثر من أية ديانة أخرى، حتى ليكاد أرقى شعر عُذري ان يكن من نتاج شعراء مسحيين. فإذا قال امرؤٌ إن الجنس، بحد ذاته سيء، فإن المسيحية تناقضه حالاً. ولكن طبعاً حين يقول الناس: “ليس الجنس أمراً مخجلاً” فقد يَعنون أن “الحالة التي باتت عليها الغريزة الجنسية الآن ليست أمرً يدعو إلى الخجل”.
فإذا كان هذا ما يعنونه، يكونون مخطئين، حسبما أعتقد. فأنا أرى أن الوضع مدعاة لكل خجل. لا داعي للخجل في الاستمتاع بطعامك؛ ولكن سيكون كل ما يدعو للخجل إذا جعل نصف العالم الطعام هم حياتهم الأول وقضوا وقتهم يتأملون صور الطعام ويتلمظون ويُسيلون لعابهم. لست أقصد أننا، أنا وأنتم، مسؤولون فردياً عن الوضع الحالي.
فآباؤنا الأقدمون سلمونا كياناً عضوياً فاسداً من هذه الناحية، ثم ننشأ حيث تُحيط بنا الدعاية المحبذة لعدم العفاف. وثمة ناس يريدون إبقاء غريزتنا الجنسية ملتهبة كي يكسبوا منا مالاً. ذلك لأن رجلاً يستبدّ به هاجس هو بالطبع قليل المقاومة للمبيعات. إنما الله عليم بوضعنا، وهو لن يديننا كما لو لم تكن لدينا عقبات نتغلب عليها. فما يهم هو إخلاصنا وثبات إرادتنا على التغلب على العقبات.
وقبل أن يتأتى لنا الشفاء، علينا أن نريد الشفاء. فالراغبون حقاً في المعونة سيحصلون عليها؛ ولكن بالنسبة إلى كثيرين من أهل عصرنا، حتى الرغبة صعبة. ويسهل أن نحسب أننا نريد شيئاً ما ونحن لا نريده حقاً. وقد أخبرنا مسيحيّ شهير عاش في القديم بأنه لما كان شاباً صلى باستمرار طلباً للعفة، ولكنه بعد سنين مضت أدرك أنه بينما كان شفتاها تقولان: “يا رب، اجعلني عفيفاً!” كان قلبه يُضيف سراً: “وكن رجاء لا تفعل ذلك الآن”. وقد يحصل مثل هذا في الصلاة لأجل فضائل أخرى أيضاً. إنما هنالك ثلاثة أسباب من أجلها يصعب علينا الآن خصوصاً أن نرغب في العفة التامة، ناهيك بإحرازها.
ففي المقام الأول، تتحد طبيعتنا الفاسدة والشياطين التي تجربنا وكل الدعاية المعاصرة المثيرة للشهوة لإقناعنا بأن الرغبات التي نقاومها هي “طبيعية” جداً، و”سليمة صحياً” للغاية، وهي معقولة ومقبولة، يحث تكاد مقاومتنا لها أن تكون شذوذاً وانحرافاً. فربّ مُلصق بعد ملصق، وفلم بعد فلم، ورواية بعد رواية، تربط فكرة الانغماس او الإشباع الجنسي بفكر الصحة والسوية والشباب والصراحة والمرح.
غير أن هذا الربط أكذوبة. وشأن كل كذبة قوية، هذا الربط مؤسس على حقيقة، ألا وهي الحقيقة المعترف بها آنفاً من أن الجنس في ذاته (بمعزل عن الإفراط على أنوعه وعن الهواجس التي نشأت حوله) هو “طبيعي” و”سليم صحياً” وما إلى ذلك، إنما ينبغي أن تكون هذه الكذبة تافهة ومنفصلة كلياً عن المسيحية، على أساس أية نظرة معقولة. فمن الواضح أن استسلامنا لجميع رغباتنا يُفضي إلى العجز والمرض والمحاسدات والأكاذيب والتستر وكل ما هو نقيض الصحة والمرح والصراحة.
إذ في سبيل أية سعادة، ولو في هذا العالم، تدعو الضرورة إلى مقدار كبير من الضبط. وهكذا، فادعاء كون كل رغبة، إذا كانت قوية، سليمة صحياً ومقبولة منطقياً هو ادعاء باطل. فكل إنسان عاقل ومهذب يجب أن يحوز مجموعة ما من القيم التي بموجبها يختار أن يرفض بعضاً من رغباته ويقبل غيرها. ومن الناس مَن يفعل ذلك على أساس مبادئ مسيحية، ومَن يفعله على أساس مبادئ صحية، ومَن يفعله على أساس مبادئ اجتماعية. فالتضارب الحقيقي ليس بين المسيحية و”الطبيعة”، بل بين المبادئ المسيحية والمبادئ الأخرى في السيطرة على “الطبيعة”.
إذ لا بد من السيطرة على “الطبيعة” (أعني الرغبة الطبيعة) على كي حال، إلا إذا شئت تدمير حياتك كلها. وليس مَن ينكر أن المبادئ المسيحية أشد صرامة من سواها. غير أننا نعتقد أنك ستحصل على معونة لإطاعتها لن تحصل عليها لإطاعة غيرها من المبادئ.
وفي المقام الثاني، يُعاق كثيرون عن محاولة التزام العفاف المسيحي بجدية لأنهم يتصورون (قبل أن يحاولوا) أن ذلك مستحيل. ولكن عندما ينبغي السعي إلى شيء ما، يجب ألا يُفكر المرء أبداً في الإمكانية أو الاستحالة. فإذا واجه الطالب سؤال اختباري في ورقة امتحان، ينظر في قدرته على الإجابة عنه. أما إذا واجهه سؤال إلزامي، فعليه أن يبذل أقصى جهده.
ثم إنك تنال علامة ما لقاء إجابة ناقصة بعض الشيء. إنما من المؤكد أنك لن تحصل على أية علامة إذا لم تُجب عن السؤال. وليس في الامتحانات فقط، بل أيضاً في الحرب، أو في تسلق الجبال، او تعلم التزلج أو السباحة أو ركوب الدراجة، بل أيضاً في تزور قبة بأصابع باردة في صقيع الشتاء، غالباً ما يقوم الناس بما كان يبدو مستحيلاً قبل قيامهم به. فما أروع ما تقدر أن تفعله حين يكون عليك فعله!
وفي وسعنا بالحقيقة أن نتيقن بأن العفاف التام، شأنه شأن الإحسان التام، لن يُحرز بأي جهود بشرية مجرّدة. فلا بدّ أن تطلب معونة الله لأجله. حتى إنه بعدما تكون قد فعلت ذلك، قد يبدو لك وقتاً طويلاً أنك لم تتلق أية معونة، أو تلقيت أقل مما تحتاج إليه. فلا تبتئس! بل بعد كل فشل، اطلب الغفران، ثم قم وحاول من جديد. فما يعيننا الله على بلوغه أولاً أغلب الأحيان لا يكون هو الفضيلة ذاتها، بل القدرة على المحاولة دائماً من جديد. فمهما كانت أهمية العفاف (أو الشجاعة أو الصدق أو غيرهما من الفضائل)، تدربنا هذه العملية على عادات النفس، وتلك أكثر أهمية بعد.
إنها تشفينا من توهماتنا عن أنفسنا، وتعلمنا الاتكال على الله. فمن الناحية الأولى، نتعلم أنه لا يمكننا أن نثق بنفوسنا حتى في أحسن أحوالنا؛ ومن الناحية الأخرى أنه لا داعي لأن نيأس حتى في أسوئها لأن سقطاتنا مغفورة لنا. أما الأمر الوحيد الفتاك، فهو أن نقعد قانعين بأي شيء أقل من الكمال.
وفي المقام الثالث، غالباً ما يُسئ الناس فهم ما يُعلمه علم النفس عن “حالات الكبت”. فهو يعلمنا أن الجنس “المكبوت” خطر. ولكن كلمة “المكبوت” هنا لفظة تقنية. فهي لا تعني “مكبوتاً” بمعنى “مرفوضاً” أو “مُقاوَماً”. إذ أن الفكرة أو الرغبة المكبوتة هي فكرة أو رغبة دُفعت إلى ما دون الوعي (عادة في سن مبكرة جداً) وبات الآن ممكناً أن تخطر في البال فقط في شكل مُقنع وغير مميز. فالشهوة الجنسية المكبوتة لا تظهر للمريض بأنها جنسية أبداً. وعندما ينهمك مُراهق أو راشد في مقاومة رغبة يعيها، لا يكون متعاملاً مع كبت، ولا يكون متعرضاً على الإطلاق لإحداث كبت.
بل على العكس، فإن أولئك الذين يسعون إلى العفاف باجتهاد يكونون أكثر وعياً، وسرعان ما يعرفون مقداراً وافراً عن حال جنسياتهم أكبر مما يعرفه أي شخص سواهم. وإذا بهم باتوا يعرفون رغباتهم كما عرف ولنغتون نابليون، أو شرلوك هولمز موريارتي؛ وكما يعرف صائد الفئرانِ الفئرانَ، أو السمكري أحوال المواسير الراشحة. فالفضيلة، الفضيلة المنشودة، تؤتي النور؛ أما الانغماس فيؤتي التشوش والارتباك والغموض.
وفي الختام، رغم اضطراري إلى التوسع قليلاً في حديثي عن الجنس، اود أن أُوضح بقدر إمكاني أن لب الأخلاقيات المسيحية ليس ههنا. فإذا حسب أحد أن المسيحيين يعتبرون عدم العفة أسوأ رزيلة، فهو مخطئ. إن خطايا الجسد سيئة، ولكنها الأقل سوءاً بين الخطايا. فجميع اللذات الأسوأ روحية محض: لذة تخطئة الآخرين أو تسفيههم، لذة التسلط والتفضل وسماع المديح، لذة الاغتياب أو الذم، مباهج السلطة، متعة الحقد أو الكراهية. ذلك أن في داخلي عنصرين يُصارعان النفس الإنسانية التي يجب أن أسعى كي أحققها، وهما النفس الحيوانية والنفس الشيطانية؛ وهذه الأخيرة أسوأ الاثنتين.
ولذلك ربما المرأة المتزمتة المباهية ببرها الذاتي أقرب إلى جهنم من الفاجرة المقرة بإثهما. ولكن الأفضل طبعاً أن تكون المرأة لا هذه ولا تلك!



