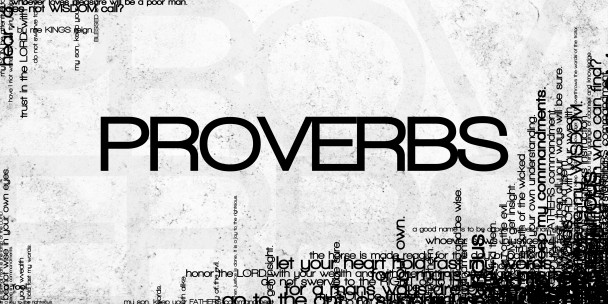التائب المثالي – سي إس لويس

التائب المثالي – سي إس لويس
هكذا نجد أمامنا هذا الخيار المروّع: إن هذا الرجل الذي نتحدث عنه إما كان وسيبقى ما قاله إنه هو تماماً، وإما مخبول، أو أي شيء آخر أسوأ. والآن يبدو لي واضحاً أنه لم يكن مخبولاً ولا خبيثاً. وتالياً، فمهما بدا الأمر غريباً أو مروعاً أو غير محتمل، ينبغي لي أن أقبل الرأي القائل بأنه كان وسيبقى هو الله. لقد هبط الله إلى هذا العالم الذي يحتله العدو، في صورة إنسان.
والآن، ماذا كان القصد من الأمر كلّه؟ ماذا جاء ليفعل؟ طبعاً كي يُعلم. ولكن ما إن تنظر في كتاب العهد الجديد أو أي مؤلف مسيحي صحيح آخر، حتى تجد هناك حديثاً ثابتاً عن أمر مختلف: عن موته وقيامته حياً من جديد! وبديهي أن المسيحيين يعتقدون أن النقطة الجوهرية في القضية تكمن ها هنا. فهم يرون أن الغرض الأساسي الذي جاء إلى الأرض كي يفعله إنما كان أن يتألم ويُقتل.
إنما قبل أن صرت مسيحياً حقيقياً كان يسيطر عليّ الانطباع بأن أول أمر ينبغي للمسيحيين أن يؤمنوا به هو نظرية بعينها بشأن الغرض من موته. فحسب تلك النظرية أن الله أراد أن يعاقب الإنسان على التحول عنه والانضمام إلى العاصي الطاغي المهلك، ولكن المسيح تطوع لتحمل القصاص عنا، فأطلق الله سراحنا. والآن أعترف بأن هذه النظرية لا تبدو لي بالغة اللاأخلاقية والسخف كما كانت حالها عندي فيما مضى. ولكن ليست هذه هي النقطة التي أود توضيحها والتأكيد عليها. فالذي تبين لي حقاً فيما بعد هو أنه لا هذه النظرية ولا سواها هي المسيحية.
فالعقيدة المسيحية المركزية هي أن موت المسيح أصلح حالنا أمام الله ومعه ويسّر لنا بداءة جديدة، بطريقة من الطرق. أما النظريات التي تعلل كيف تم ذلك فمسألة أخرى. ولطالما اعتقد الناس مقدارً لا بأس به من النظريات المختلفة في كيفية حصول الأمر. أما ما يتفق عليه جميع المسيحيين فهو أنه حصل فعلاً ويؤدي غرضه حقاً. وها أنا أقول لكم ما أعتقده بشأن ذلك. إن جميع الناس العاقلين يعرفون أنه إن كنت تعباً وجائعاً فإن وجبة طعام تنفعك. غير أن نظرية التغذية الحديثة (كل ما يعلق بالفيتامينات والبروتينات) هي أمر مختلف.
ولطالما تناول الناس الطعام وشعروا بحُسن الحال قبل زمان طويل من سماع أحد بنظرية الفيتامينات فعلاً. وإذا تم التخلي يوماً عن نظرية الفيتامينات: فإنهم سيظلون يأكلون طعامهم على المنوال عينه تماماً. فالنظريات المتعلقة بموت المسيح ليست هي المسيحية، بل مجرد تفسيرات لكيفية وفاء ذلك الموت بغرضه. ولن يتفق المسيحيون كلهم على مدى أهمية تلك النظريات. والكنيسة التي إليها أنتمي (كنيسة إنكلترا) لا تٌقر أية واحدة منهن على أنها النظرية الصحيحة. أما بعض الكنائس الأخرى فتُجاوز هذا الحد قليلاً. ولكني أعتقد أن الكنائس كلها تتفق على أن الحدث نفسه أهم بما لا يُقدر من أي تعليلات طلع بها اللاهوتيون.
وأعتقد أن الجميع يُحتمل أن يعترفوا بأن أي تعليل لن يُحيط بالحقيقة كلها أبداً. ولكن كما قلت في تمهيد هذا الكتاب، ما أنا إلا مؤمن من العامة، وعند هذا الحد نخوض مياهاً غامرة. إنما يمكنني أن أطلعك على كيفية رؤيتي إلى الأمر شخصياً، نظراً لكونها رؤية ذات قيمة، كما أحسب.
في رأيي أن النظريات ليست في ذاتها ما هو مطلوب منكم قبوله. ولربما قرأ بعضكم مؤلفات العالمين جيمس جينز وآرثر أدينغتنون فما يفعله هذان عندما يريدان تفسير الذرّة، أو أي شيء من هذا القبيل، هو أن يقدما لك وصفاً يمكنك على أساسه أن تُنشئ صورة ذهنية. إلا أنهم لا يلبثان أن يُنبهاك إلى أن تلك الصورة ليست هي ما يعتقده العلماء فعلاً. فما يعتقده العلماء إنما هو صيغة رياضية أو حسابية. وليست الصور إلا لمساعدتك على فهم الصيغة. وليست الصور في الواقع صحيحة على غرار صحة الصيغة، إذ لا تزودك بالمادة الحقيقية بل بمجرد شيء يشابهها على وجه التقريب.
فالمقصود من وراء الصور أن تكون مساعدة، وإذا لم تكن كذلك يمكنك نبذها. أما الشيء نفسه فلا يمكن تصويره، بل يمكن فقط التعبير عنه رياضياً. وكلنا هنا في الصف نفسه. فنحن نؤمن بأن المسيح في سياق التاريخ هو تمامً تلك النقطة التي فيها ظهر في عالمنا هذا أمرٌ فائقٌ للتصور كلياً مصدره خارج هذا العالم. وإذا كنا نعجز حتى عن تصور الذرات التي منها يتكون عالمنا بالذات، فمن غير ريب أننا لن نتمكن من تصور هذا الأمر الفائق.
وبالحقيقة أنه لو تبين لنا أننا قادرون على فهم الأمر تماماً، فإن هذا الواقع عينه يُبين أنه ليس ذلك الأمر الذي يزعم أنه هو، أي الحق غير القابل للتصور والأزلي والآتي مما وراء الطبيعة مخترقاً الطبيعة كالبرق. وربما تسأل: أي نفع لنا فيه ما دمنا لا نفهمه؟ غير أن الجواب عن هذا سهل. ففي وسع المرء أن يتناول غداءه بغير أن يفهم تماماً كيف يُغذيّه الطعام. وفي وسعه أيضاً أن يقبل ما عمله المسيح بغير أن يفهم كيف يؤدي غرضه. وبالحقيقة أنه لن يعرف يقيناً كيف يفعل فعله إلا متى قبله.
يُقال لنا أن المسيح مات لأجلنا، وأن موته غسلنا من خطايانا، وإنه بموته أبطل فاعلية الموت بعينه. تلك هي الصيغة. تلك هي المسيحية. ذلك هو ما ينبغي ان نؤمن به. أما النظريات التي ننشئها بشأن كيفية إتمام موت المسيح لكامل أبعاده، فهي في رأيي أمر ثانوي تماماً، إذ هي مجرد ترسيمات أو تصاميم ينبغي نبذها إن كانت لا تساعدنا، وإذا ساعدتنا فعلاً فينبغي عدم الخلط بينها وبين الأمر الحقيقي بعينه. ومع ذلك، فإن بعض هذه النظريات تستحق أن نُلقي نظرة عليها.
إن النظرية التي سمع بها معظم الناس هي تلك التي ذكرتها سابقاً والقائلة بأنه قد أطلق سراحنا لأن المسيح تطوع أن يتحمل القصاص عوضاً عنا. فالآن، تبدو هذه النظرية في ظاهرها سخيفة جداً، إذا كان الله على استعداد للعفو عنا، فماذا لم يفعل ذلك ما تُرى؟ وأي داع معقول لمعاقبة شخص بريء بدلاً منا؟ ليس ثمة داعٍ معقول يمكنني أن أراه حقاً إن كنتَ تُفكر في العقاب بلغة محكمة الجُنح. أما إذا فكرت في دَينٍ ما، فثمة معنى وافٍ في أن يدفع شخص ميسور ديناً بالنيابة عن شخص معسور.
أو إذا نظرت إلى “تأدية العقوبة” لا بمعنى تحمّل القصاص، بل بالمعنى الأعم الذي يخص “تحمل النفقات” أو “دفع الفاتورة” (أي تسوية الحساب)، فعندئذ بالطبع يُبين لنا الاختبار العام أنه حين يتورط إنسان في مأزق ما، فإن عناء إخراجه منه يقع عادة على عاتق صديق مُحب.
والآن، ما نوع “المأزق” الذي تردّى الإنسان فيه؟ لقد أراد أن يستقل بنفسه، متصرفاً كأنه يخص نفسه. بكلمة أخرى: ليس الإنسان الساقط مجرد مخلوق ناقص يحتاج إلى تحسين، بل هو عاص متمرد يجب أن يُلقي سلاحه. فإلقاؤك سلاحك، واستسلامك، وتعبيرك عن ندامتك وأسفك، وإدراكك أنك سالك سبيل الضلال، واستعدادك لبدء الحياة مجدداً من نقطة الصفر…. تلك هي الطريقة الوحيدة للخروج من مأزقنا. وعملية الخضوع هذه، التي تشبه حركة دوران سريعة إلى الوراء، هي ما يسميه المسيحيون “التوبة”. وليست التوبة أمراً ممتعاً أبداً.
فهي شيءٌ أصعب بكثير من مجرد تناول وجبة وضيعة. إنها تعني إطراح كل ما دربنا أنفسنا على حيازته طوال آلاف السنين من عُجب وافتخار كاذب وعناد. إنها تعني قتل جزئ من ذاتك أو معاناة نوع من الموت. وبالواقع أن التوبة تستلزم إنساناً صالحاً. وها هنا الورطة المربكة: فالإنسان الطالح وحده ينبغي أن يتوب، إنما الإنسان الصالح وحده يقدر أن يتوب توبة كاملة. وكلما ازددت فساداً تضاعف احتياجك إلى التوبة، وقَلّت قدرتك على القيام بها. فالشخص الوحيد القادر على أن يتوب توبة كاملة ينبغي أن يكون شخصاً كاملاً، وهذا لا يكون محتاجاً إلى التوبة.
إنما تذكر أن هذه التوبة، أي هذا الخضوع الطوعي للخزي ولما يُشبه الموت، ليست أمراً يطلبه منك الله قبل أن يقبلك من جديد، ويمكن أن يُعفيك منه إذا شاء، بل إنها بصريح العبارة وصف لما يُمثله الرجوع إليه. فإن طلبت إلى الله أن يقبلك من جديد يغير توبة، تكون بالحقيقة طالباً إليه أن يسمع لك بالرجوع إليه بغير أن ترجع. وهذا أم يستحيل حدوثه. حسن جداً إذاً، علينا أن نُنجزها! غير أن الفساد الذي يجعلنا بحاجة إليها هو نفسه يجعلنا عاجزين عن القيام بها. فهل نقدر أن نقوم بها إذا ساعدنا الله؟ نعم، ولكن ماذا نعني بذكرنا مساعدة الله لنا؟ نعني وضع الله فينا جزءاً من ذاته، إذا جاز التعبير.
إنه يمنحنا شيئاً من قدراته التفكيرية، وبهذه الكيفية نُفكر؛ ويبث فينا قليلاً من محببته، وبهذه الكيفية نحب بعضنا بعضاً. وعندما تُعلّم ولداً الكتابة، تمسك بيده وهو يرسم الأحرف. ذلك أنه يُصور الأحرف لأنك أنت تُصورها. فنحن نُحب ونفكر لأن الله يحب ويفكر ويمسك بأيدينا فيما نفعل ذلك. ولو لم نسقط، لكان ذلك كله سَفَراً سعيداً. ولكننا الآن، للأسف! نحتاج إلى مساعدة الله كي نفعل شيئاً لا يفعله الله أبداً في ذات طبيعته: كي نستسلم ونتألم، ونخضع، ونموت.
فلا شيء في طبيعة الله يتوافق مع هذه العملية إطلاقاً. عليه، فإن الدرب الوحيد الذي فيه نحتاج الآن إلى هداية الله أكثر الكل هو درب لم يسلكه الله قط، في ذات طبيعته. وفي مقدور الله أن يمدنا بما لدينا. إنما هذا الأمر بعينه ليس لديه في ذات طبيعته.
ولكن هب الله صار إنساناً، هب طبيعتنا البشرية التي يمكن أن تتألم وتموت اندمجت بطبيعة الله في شخص واحد، فعندئذ يكون في مقدور ذلك الشخص أن يساعدنا. وفي وسعه إذ ذاك أن يُخضع إرادته ويتألم ويموت، لأنه إنسان؛ كما أن في وسعه أن يفعل ذلك على نحو كامل تماماً؛ لأنه الله. ولا يمكننا، أنا وأنت، أن نجتاز هذه العملية إلا إذا عملها الله فينا. ولكن الله لا يمكن أن يعملها إلا إذا صار إنساناً.
ولن تنجح محاولاتنا في إطار عملية الموت هذه إلا إذا شاركنا نحن البشر في اختبار الله الموت، تماماً كما أن تفكيرنا لا يمكن أن ينجح إلا لكونه نقطة من بحر تفكيره وعقله. إنما لا يمكننا أن نُشارك في اختبار الله للموت ما لم يمت الله فعلاً، ولا يمكن أن يموت تعالى بغير أن يكون إنساناً. بهذا المعنى يفي الله دَيننا ويُعاني عوضاً عنا ما لا يحتاج هو نفسه لأن يُعانيه أبداً.
وقد سمعت بعضاً يتشكون قائلين: “إن كان المسيح هو الله كما هو إنسان أيضاً، فعندئذ تفقد آلامه وموته كل قيمة في نظرنا، لأنه لابد أن ذلك كان سهلاً جداً عليه.” إلا أن آخرين قد يشجبون (على نحو صحيح جداً) ما ينطوي عليه هذا الاعتراض من نكران جميل وفظاظة. ولكن ما يذهلني أنا هو ما ينم عنه هذا الموقف الثاني من سوء فهم. فبمعنى ما طبعاً، مُقدمو هذا الاعتراض على حق. بل إنهم قصّروا في دعم قضيتهم الخاصة. فالخضوع الكامل، ومعاناة الآلام الكاملة، والموت الكامل، لم تكُن فقط أسهل على المسيح لأنه هو الله، بل إنها كانت ممكنة فقط لأنه هو الله.
ولكن أليس هذا سبباً غريباً جداً لعدم قبولها؟ إن المعلم قادر على رسم الحروف للولد لأن المعلم راشد ويعرف كيفية الكتابة. ولا ريب في أن كونه راشداً يجعل الأمر أسهل على المعلم؛ وفقط لأنه أسهل عليه فإنه يستطيع أن يساعد الولد. فإذا رفض الولد المعلم، لأن الكتابة “سهلة على الراشدين”، وانتظر أن يتعلم الكتابة من ولد آخر لا يقدر هو نفسه أن يكتب (وتالياً لا تكون له أفضلية “مجحفة”)، فإنه لن يتقدم في تعلماه بسرعة زائدة.
وإذا كنتُ أغرق في نهر جارف، فقد يُناولني رجل ما زالت إحدى رجليه على الضفة يداً تُنقذ حياتي. أفينبغي لي أرد صارخاً (بين لهاثي): “لا، هذا مُجحف! أنت صاحب أفضلية! إنك تُبقي إحدى قدميك على الضفة!”؟ أنما تلك الأفضلية (سـمّها إجحافاً إذا شئت) هي السـبب الوحيد لقدرة الرجل على إسداء أي خير إليّ. فإلى أي مصـدر تتطلع طلبـاً للعـون إن كنت لا تتطلع إلى ذاك الذي هو أقوى منك؟
هذه هي طريقتي في النظر إلى ما يدعوه المسيحيون “الكفارة”. إنما تذكر أن ما أوردته هو صورة أخرى ليس غير. فلا تغلط بحسبانها الشيء الحقيقي بذاته. إن لم تجد فيها أي عون لك، فاتركها ضارباً عنها صفحاً!