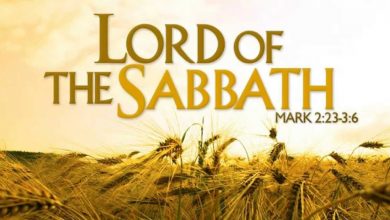الكتاب المقدس ونظرة إلى النقد الكتابي العلمي المعاصر
الكتاب المقدس ونظرة إلى النقد الكتابي العلمي المعاصر
الكتاب المقدس ونظرة إلى النقد الكتابي العلمي المعاصر

العلاقة الصميمية مع الكلمة الالهية هي بداية إيمان. ولا يمكن للمرء أن ينمو في الرب إذا عزل نفسه عن كلمة الحياة، وتغرّب عنها. لا يغتني المرء، ولا يكتنز في أعماقه كنوز الدهر الآتي والمثول في حضرة المسيح، إلا إذا تشبّعت نفسه من كلام الحياة.
والمرء لا يمتلئ من هذه كلها لمجرد الانتماء إلى الطائفة، ولا لمجرد أنه محسوب عضواً في عائلة مسيحية، أو مواطناً في دولة تقوم في أرض مهد الأديان.
المؤمن لا يتقدم في إيمانه، ولا يتجذّر رؤيته إلى العالم إذا انعزل عن الكتاب المقدس. فالعلاقة مع كتاب الحياة هي التي ترسّخ خطانا، وتثبت أقدامنا في درب الله.
وهذا ليس بالأمر الغريب، طالما أن الكلمة الالهية هي نبع ماء حي يغذي الكيان ويروي الظمأ على نحو ما قاله الرب: «… الماء الذي أعطيه أنا، يصير نبع ماء يتفجّر حياة أبدية» (يوحنا 4: 14). وهكذا أيضاً يؤكد لنا الالهي بطرس مكانه كلمة الحياة فيقول: «إلى أين نذهب يارب، وكلام الحياة الأبدية عندك؟» (يوحنا 6: 68).
في الواقع تبدو هذه الكلمات بديهية، ولا اختلاف على معناها ومضمونها.
إلا أن الحياة اليومية تكشف لنا إنصراف الناس، عموماً، عن مطالعة الكتاب المقدس. لا بل ان قسماً لا يستهان به من الذين يُحسبون على المسيح ويسمّون به، لا يتصلون بالكتاب المقدس، ولأسباب كثيرة. فأنت تراهم في حالة من اللامبالاة تجاه كلمة الحياة، الأمر الذي أراه علامة مرض روحي كبير في هذا الشرق خاصة، وفي العالم عامة.
بيد أننا نتعلّم، من سفر أعمال الرسل، أن مطالعة الكلمة الالهيّة، لابد أن تقترن بفهم الكلمة في سياقها الضيق والعام، وان هذا الفهم يستدعي مرشداً: «فقال الروح القدس لفيلبس تقدّم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي أشعياء، فقال له: ألعلّك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف لي ذلك إن لم يرشدني أحد…؟» (اعمال 8: 29—31). من هذا نتبيّن ان فهم الكلمة، من اجل العيش بموجبها، يقترن بمن يفسرّها ويشرحها. وهكذا كان التفسير حاجة وضرورة من أجل مقاربة الإنجيل كلام الحياة، بعمق وشمول.
ومع بروز علم النقد الكتابي في مطلع القرن التاسع عشر، طرح سؤال كان ويبقى ملحّاً، وعلى غاية كبيرة من الأهمية. انه سؤال حرّك الجهود وشحذ الهمم، عمّق السعي ووسّع الرؤى، وشق الآفاق، ليميط اللثام عن عدد من مكنونات الكتاب المقدس، فعاد الجهد على الكثيرين بالخير والنفع والفائدة. ما هذا السؤال؟
من البديهي القول ان التفسير ضرورة، والشرح حاجة ولكن كيف السبيل الى الشرح والتفسير؟ كيف نفسّر، كيف يسلم الفهم والقراءة والتفسير معاً؟ ولكي يأتي السؤال أعمق وأشمل وأكثر وضوحاً، ينبغي أن نصوغه على النحو التالي:
كيف نطالع كافة الوثائق التاريخية والدينية والحضارية التي وصلتنا من الماضي البعيد، من المدنيات البائدة؟ أليست هذه الوثائق المختلفة الأنواع والمشارب محصّلة جهود السلف وخلاصة خبرتهم ومعاناتهم وحياتهم؟ ما المعيار الذي به تسلم مطالعتنا لها؟ هل تكفي المطالعة البحتة لمجرد أننا نمتلك عدداً من الابجديات القديمة والعريقة؟ هل تكفي القراءة الفردية السريعة؟ أليس هناك خطر في أن نأتي عبر المطالعات الفردية، إلى نتائج لم تكن لتخطر على بال واضعي هذه الوثائق؟ ما الذي سيوحّد قراءتنا في حال برز خلاف أو نزاع؟
في الواقع ينسحب السؤال هذا على الوثائق العامة على اختلافها، بما فيها المخطوطات الدينية، لا سيما تلك التي تتصل بالكتاب المقدّس. أهل الشأن يدركون ان المعرفة الكتابية مطلب في كل زمان وحاجة، لا سيما في زماننا الحاضر الذي يعج بالتساؤلات والهموم، والمشبع بالبدع والهرطقات التي لا بد من التصدّي لها على غير صعيد.
فإذا كانت المعرفة السطحية كافية، فما الذي يضمنها ويعصم أصحابها من الخطأ والزلل والانحراف؟ ما الذي يضمن فهم العهد القديم، بعقلية زماننا، بدون أخطاء؟ أليس من ضرورة لقاسم مشترك تسلم به القراءة ويستقيم به الفهم (common denominator)؟ أليس من ضرورة لمقياس نعتمده في مسعانا لتسلم كل مقاربة وإتصال بالكتاب المقدس؟
وفي غمرة التساؤلات الكثيرة، والمهمة، بات من المؤكد، ان وجود المرشد او الدليل إلى المطالعة السليمة لكل وثيقة قديمة، مدنية كانت أم دينية، هو حاجة ماسة، وضرورة ملحّة.
لقد رام العلماء الكبار الغوص في أعماق الماضي لسبر أغواره، وفض أسراره، وحل الغازه ومكنوناته، من أجل الوقوف على فكر القدماء لمعرفة الخواص التي اتسمت بها حياتهم. يحدوهم إلى الهدف المنشود، رغبة في معرفة المزيد عن العالم القديم من أجل معرفة حركة الحياة الإنسانية وطبيعة ارتقائها.
في الواقع ان تساؤلات عديدة جالت في عقل العلماء سعياً الى هذا الهدف المشوق اليه. ومن شأن جهودهم هذه، ان تغني حاضرنا، وتنير درب مسيرتنا في معارج النهوض والارتقاء.
إلا ان قراءة علمية للمخطوطات القديمة والوثائق العريقة، بغية اكتناه لبّها، وفض أسرارها، لابد ان تستتبع نهجاً، وتستدعي طريقة أو نمطاً، وتشترط خطاً واضحا وجلياً يتّسم بعدد من عناصر لازمة وضرورية. ما هي هذه العناصر العلمية التي لا غنى عنها في الجهد العلمي من أجل مقاربة كنوز العالم القديم المنصرم؟
الموضوعية والدقّة والشمول، والحياد الأقصى، مع ما يتصل بهذه من علوم عامة ومعرفة باللغات القديمة، هي أمور واجبة كي تسلم القراءة وتستوفي شروط الفهم لهذه المخطوطات. لقد تنبّه العلماء الى دور المقارنة في كشف الحقيقة فقاموا الى الوثائق ليقابلوا بين هذه وتلك حسب معرفتهم بأزمنة التدوين.
لكن ما معنى الكلام عن كل هذه التفاصيل والتشعبات العلمية والتساؤلات المعقدة والمتداخلة، والتي من شأنها، إذا اعتمدت، ان تحيل موضوعاً صغيراً، إلى أمر يفوق حجمه الأصلي مرات عدّة؟ لماذا كل هذا التعقيد؟
في الواقع، ليس النهج العلمي سوى وسيلة غايتها الفهم الأفضل، والأكمل لكل وثيقة قديمة، سواء كانت دينية أم مدنية. ودراسة الوثيقة القديمة درسا وافياً وشافياً، تستدعي من أهل الشأن، أموراً عدّة، كالوقوف عند العبارات والاصطلاحات وحروف الجر – لا سيما إذا كان الكلام عن اللغة اليونانية، لغة النص السبعيني – (septuagint) حيث هناك للنصب معنى، وللاضافة معنى[1]…
وكان لابد قبل الشروع في قراءة الوثائق وتفسيرها، من أخذ الأمور في جزئياتها، والوقوف على سياقها الضيق والعام، وذلك للخلوص في نهاية المطاف الى اكتشاف سياق واحد يسلط الضوء على قراءة صحيحة من أجل فهم صحيح، للنص الذي بين أيدينا.
ويعيننا في مسعانا هذا ان كنا نروم الدقة والموضوعية، ونشد الغاية المرتجاة، جملة من أسئلة وتساؤلات كانت وستبقى واجبة في مسيرة كل جهد أو عمل علمي: من هو الذي يدور حوله النص؟ ما هي الفكرة الأساسية التي يعالجها النص؟ من هو الكاتب؟ ما هي مقوّمات ثقافته وأدبه؟ ما هي المدارس الأدبية التي تأثر بها فانعكست في أدبه؟ أين عاش؟ متى عاش؟ لماذا كتب؟ ماذا يريد أن يقول؟ هذه وغيرها من الأسئلة، واجبة لنا ان كنا نتطّلع إلى قراءة رصينة وفهم سليم للوثائق المختلفة.
وفي الحقيقة، لقد اتسعت رقعة علم التفسير الكتابي لتشمل نطاقات كانت حتى الأمس القريب تبدو وكأنها عديمة الصلة بموضوع علمي، أو عنوان دراسة. الجغرافيا صارت ركناً مركزياً وباباً مهماً يعوّل على معطياته. التاريخ بكل أبعاده ومتفرعاته أصبح ذا شأن لا سيما وان الزمان والمكان هما إطاران يحيطان بحياة الانسان في كل آنٍ ومكان.
وكل ذلك لأن للجغرافيا وللتاريخ دوراً هاماً ومميزاً كونهما يصوغان ذهنية الانسان ويتحكمان بمعالمها وتعبيرها. الجغرافيا والتاريخ يسهمان في كشف خواص الشعوب والمجتمعات والأمم في كل مكان من العالم[2]
ثم ان باباً آخر، لا بل علماً آخر، زيد على كافة الابواب الأخرى، لما صار له في هذا العصر من أهمية. ما هو؟ انه علم الآثار الذي يربطنا بالحضارات القديمة، وقد أتاح لنا فرصة التعرف على عدد من مرافق الحياة عند الأقدمين، وقدم لنا منجزاتهم على مائدة علمية مزدانة بالخلاصات البديعة والرائعة، فأسهم بذلك في جمع حلقات الزمن البائد، بزماننا هذا. ويمكننا أن نسأل: لماذا علم الآثار؟ ما أهميته على صعيد علم النقد الكتابي (biblical criticism)، أو على صعيد علوم التفسير الكتابي؟ (exegesis, hermeneutics) أيعقل أن نأتي إلى المسيح، من المنظور الإيراني، عبر آثار وأطلال؟ أيعقل أن تقود الحجارة خطانا إلى معرفة المسيح؟ ألا يبدو غريبا أن نتكلّم عن الكتاب المقدس من خلال الآثار؟
قد يبدو للوهلة الأولى أن يكون مجيئاً إلى المسيح عبر عالم الآثار والحضارات المكتشفة والمعروفة بآن معاً أمراً غريباً. يبدو غريباً حقا أن تكون مقاربتنا للمسيح عبر حجارة وألواح ومسلات (obelisks) وفخار ووريقات حفظتها لنا طبقات الأرض وكهوفها، وجرار القدماء الهشة. إلا أن علم الآثار قادر أن يمدنا، بما يقوم فيه، بالمعطيات اللازمة للوصول إلى الخلفية الأولى التي عليها وفيها تمّت ولادة النصوص والوثائق التي وصلت إلينا.
فأنت إذ تطالع – على سبيل المثال لا الحصر – ما أنجبته حضارة أوغاريت وماري ورأس شمرا والاهرامات ومدافن العراق وما بين النهرين مهد الحضارات الكبيرة من سومرية وبابلية وأشورية وأكادية وغيرها، فإنّك، تجعل حتماً، كل ثمار التنقيب العلمي (Excavations) على مائدة شهية مزدانة بأشهى المآكل وأطيبها. ولكن ما هي أهمية هذا التنقيب الاركيولوچي الشامل؟ ما جدواها في علاقتنا مع الكتاب المقدّس؟
أهمية علوم الآثار تأتي من كونها تجعلك قادراً أن ترقب حركات الشعوب وحضاراتها، وأن تتأمل في الخط البياني الحضاري العريق، وذلك بقصد الوقوف على طبيعة التفاعل الذي كان بين الشعوب والحضارات التي بادت. وكل ذلك، لأنك من خلال مشهد بانورامي واحد، بُذل الكثير من أجله، تستطيع أن ترقب حياة شعب أو أمة صارت في أحشاء التاريخ الغابر، وذلك كي ترى كيف كانت الحياة وأساليبها وأفكار أبنائها وبيئتهم. من خلال هذا، يمكنك أن تستلهم وتقارب العناصر التي إمتاز بها كاتب الوثيقة التي بين يديك.
في الحقيقة، لقد بذل الكثير من أجل إعداد هذه المائدة الغنية بالمآكل الحضارية الطيبة المذاق. قرون عديدة تعاقبت، ونفوس كثيرة بذلت وجاهدت، وأتعاب خفية سكبت، من أجل إعداد مائدة الحضارات المختلفة.
بعد هذا الاقتضاب، نأتي إلى السؤال: وكيف أفهم؟ وان شرعت أفهم، هل أستطيع القول انني أفهم كما يجب؟ هل قراءتي صحيحة، وفهمي سليم؟ وهل ما توصلت إليه بالدرس والتحليل والمقارنة، هو نفسه ما كان يجول في فكر الكاتب عندما كتب؟ بإختصار، هل الخلاصات التي بين يدي، كانت في نية الكاتب عند التدوين. وان زعمت ان فهمي سليم وصحيح، فما هي المعايير التي اعتمدتها للوصول الى هذا الهدف؟
من الأكيد ان القارئ لا يستطيع الكلام عن أمر لم يكن في ذهن الكاتب. وهذا الأمر يقودنا إلى ما هو مهم حقاً لاستكمال عملية القراءة، أعني ما يتّصل بمسألة وحدة الفكر بين الكاتب والقارئ، من جهة، وبين الكاتب والمفسر، من جهة ثانية.
ولا معنى في الأساس لكل ما تتوصّل إليه من قراءتك، ان كانت ثمار جهودك لا تجعلك إلى مائدة الكاتب تقاربه وتجالسه وتحاكيه لتدرك مبتغاه. لابد من اتصالك بالكاتب، كي يسلم فهمك لرسالته. والأمر نفسه يجب أن يحصل في خبرة المفسّر أيضاً.
إن إغفال مثل هذه المسلّمات، من شأنه أن يشوش رسالة الكاتب من خلال الحيلولة دون وصولها إليك، عبر مثولك في حضرته كي تفهم مبتغاه. وقد نأتي، ان نحن أغفلنا عناصر الفهم الصحيح، إلى خلاصات وقراءات لم تكن في الأساس في ذهن الكاتب. وشئ من هذا إذا حصل، سيفقد الوثيقة التي بين يديك قيمتها، ان كانت ذات قيمة. كما ومن شأنه أن يلغي كل قيمة أو فائدة ترتجي من القراءة والكتابة بآن معاً.
وهكذا، فإن بروز علم النقد الكتابي، على أيدي أناس عمالقة في العلم دأبهم البحث وطلب الحقيقة، يقابله دخول العالم المسيحي على خط الدراسات الكتابية وتقنيات النقد ومناهج التفسير المختلفة، جعلنا نلحظ — بادئ ذي بدء — الأولوية المعطاة للقراءة السليمة والرصينة، والأهمية الكبيرة التي حظى بها الكتاب المقدس عند العلماء، وقد شرعنا منذ بضعة عقود ننعم بالثمار العلمية الكثيرة.
بيد أن فئة من المسيحيين التقويين (pietists)، وهؤلاء يؤلفون شريحة مجتمعية لا يستهان بعددها، لا يكترثون لعلوم التفسير الكتابي، لا بل يزدادون تحفظاً أمام الجهود العلمية وثمار العلماء. ويفعلون ذلك، تأكيداً منهم على الغيرة والإيمان والتقوى، فهم يقشعرّون عندما يتخيلون نصوص الكتاب المقدس تحت مباضع العلماء وفرضياتهم، وذلك لأنهم يرون في التشريح النصّي (textual autopsy) دعوة مبطّنة إلى تمزيق الكتاب والهتْك بوحدته. وما تمزيق الكتاب في نظرهم، إلا خطوة تدعو إلى إلغاء قدسية الكتاب وتدنيس كرامته والنيل من حرمته (sacrilege).
والحقيقة ان المجهودات العلمية، لا يمكنها في أي من الأحوال، ان تنال من قدسية الكتاب المقدس بتشريحه وتفكيك أوصاله. ليس هذا شأن الجهود العلمية أصلا. من شأن الجهود العلمية ان تكون عامل بناء لا عامل هدم. كذلك فإنها تسهم في توسيع آفاق قراءتنا وفهمنا للكتاب المقدس.
من شأن علوم النقد الكتابي أن تقرّبنا من الكتاب إلى درجة مصادقته ومحبته. وكل ذلك لأن الكتاب المقدّس كتاب حياة، ومقاربة الحياة من شأنها أن تحيي طاقاتنا وتفجّر إنسانيتنا للبلوغ إلى ملء قامة المسيح.
وما الدخول في ميادين علوم النقد الكتابي إلا خدمة يسديها العلماء والمفسّرون لكل مؤمن ينشغل قلبه بكلام الحياة. ليس عمل العلماء أو تعب العلماء ضرباً من الإنحراف، ولا هو خروج على القاعدة أو إنتهاك للمحرمات، أو استخفاف بالكتاب.
لقد رأي البعض، في مقولة لترتليان، حجة يدحضون بها الدراسات الكتابية: «ان دم الشهداء هو الحبة التي منها تخرج الكنيسة وتنمو. أما عرق الشرّاح والمفسرين، فما هو إلا تلك الحبة الصغيرة التي تخرج منها البدع والهرطقات».
لقد رأي ترتليان في موت الشهيد خدمة بها تنمو الكنيسة، لكن جهود الكثيرين من المنظّرين كانت بالنسبة إليه فرصة ومجال تدعو إلى ظهور البدع والهرطقات.
ولكن أيعقل أن يكون كل شرح وتفسير خدمة للهرطقات، جهداً لا يصب إلا في الانحرافات والبدع؟ ألا نتعلّم من موقف يسوع، ووقوفه في الهيكل، وشرحه لمقطع من أشعيا (لوقا 4: 19—21)، (أشعيا 61: 1—2)، وجوب التفسير لإماطة اللثام عن غوامض بعض العبارات والفقرات والنصوص الكتابية؟
وعليه، فإن الداعين إلى الاحجام عن الجهود العلمية البيلية، إنما يرتكزون في موقفهم هذا، على علم ناقص، ورؤيا ناقصة ومبتورة، وسوء فهم واضح للجهد العلمي العام بكل مقاصده وأبعاده. ترى لماذا كانت العلوم الكتابية؟ ما الذي يدعونا إلى الاقبال عليها، والاحتكام إليها، والأخذ من ثمارها وخلاصاتها؟ وهل ثمة مخاطر تنتج عنها؟
قلنا أن تاريخاً طويلا يفصل بين الاطار الذي رعى ولادة النص الأول[3] (prototype)، — أعني زمن الكتابة — ، والإطار الآخر الذي فيه يُقرأ هذا النص ويفسرّ. البون القائم بين زمان الكتابة من جهة، وزمان القراءة والتفسير، من جهة ثانية، واسع جداً، الأمر الذي يدفعنا إلى الاقرار بالجهل بين حين وآخر، فيحفزنا ذلك على الإسترشاد بالعلماء لتقليص البون من أجل فهم النص وتمثّله. وكل ذلك لأن قوالب الفكر البشري تتغيّر وتتبدّل على مرّ الأيام، ومع تغيرّ الحضارات.
فكم من عبارات كانت بليغة في زمانها، وألفاظ كانت رائجة في عصرها، انقرضت وبادت على مرّ الأيام، وما عاد الاتصال بها أو مطالعتها ممكنة بدون معجم؟ كم من مفهوم تبدّل ليصبح كالمومياء في المتاحف! من هنا ينبغي العمل على رأب الصدع وتقليص البون كي تستقيم القراءة ويسلم الفهم والتفسير.
والآن، ما هو جوهر العلوم النقدية المعاصرة؟ ما هي توجّهاتها؟ وإلى أين مآلها؟
العلوم النقدية (critical sciences) هي أدوات حيادية (netural instruments) فعّالة جدا في زماننا، ولابد من اعتمادها والاحتكام إلى ثمارها. لكن من الأكيد أن ليس كل العلماء من رحيل القديسين اصفياء الله. ليسوا جميعهم دعاة تقوى ورجال إيمان خالص. وفي هذا سرّ كبير، وذلك لأن ما يحفز البعض على الفضول العلمي هو حبّ الحقيقة، أو الفضول الإنساني العام. ومما لاشك فيه أن فئة لا يستهان بها من العلماء، يحفزها إلى العلم، الشهادة العميقة للإيمان بالله، ويحدوها الى عملها الخلاق، حبّ الرب، وخدمة مجد يسوع المسيح.
لقد أسميتُ العلوم الكتابية، أدوات حيادية، لأنها في الحقيقة هكذا. فهي تحتكم الرصانة والمنهجية والموضوعية مع ما يتصل بكل هذه من درس وتحليل ومقارنة. وكل من العلماء يدأب في ميدانه ضمن خط ومنهجية ومقاييس. وعلى قدر الدقة والموضوعية في العلم، تأتي الثمار فتكون يانعة أو فجّة.
ولا ننكر، أن العلماء على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم، يسهمون في إنماء العلاقات الاكليزيولوچية ومواصلة الحوار وتعميقه بين الأخوة في الدين الواحد. ان هكذا صورة عن العلماء، تعني، انهم في العمق شريحة من الناس ليست محسوبة على أحد. والعلماء الحقيقيون أفق وعلامة رؤية. العالم الحقيقي لا يستلزم أحد، ولا يجير ثمار جهوده لفئة دون الأخرى. انه نور لمن رام النور والاستنارة بآن معاً.
وفي عصرنا الحاضر بتنا نعيش — أكثر من أي وقت مضى — في حالة غموض وضبابية. إنسان اليوم ينزع إلى هروبية غرائزية. إنه يتحاشى الحقيقة لأنها متطلبة وضاغطة. من هنا فإن الحاجة ماسة إلى من يقودنا إلى الحقيقة هذه، ويبرز معالمها وقيمتها وجدواها في ححياتنا نحن الى مزيد من التشرذم والتفكك.
من هنا حاجتنا الى ما يرأب الصدع ويلملم الشمل ويعيد الوحدة الى كياننا الضائع والضعيف والممزق بفعل خطايانا. حاجتنا ال العلماء ماسة، وذلك خدمة لمجد يسوع المسيح، من جهة، وخلاص النفس، من جهة ثانية.
وعليه، فالدراسات الكتابية تدفع الى التلاقي وتحض على جمع الشمل نتيجة للتنافر القائم بين الأفراد والشعوب. لكن إذا كانت قيمة العلماء بهذا القدر من الأهمية والمكانة، ألا يعني رأينا فيهم، وتأييدنا لخطاهم ومساعيهم، ان الفهم الصحيح للكتاب المقدس، هو، في التحليل الأخير، حكر على العلماء، ويقتصر في النهاية على أهل الاختصاص الخبويين (elite)؟
وإذا كان السؤال صحيحاً، عندها من البديهي القول ان الكتاب المقدس ليس لكل الناس، وان قراءة العامة له، محفوفة بالخطر كل حين؟ ألا يجعلنا استنتاج كهذا نأتي الى القول أن الكتاب المقدس رفيق الصفوة فقط؟
الكنيسة بقديسيها ولاهوتيها، والمتعبدين للرب فيها، والمصلين بالروح والحق من أبنائها، هي وحدها دون سواها، صاحبة الحق في ان تنتقي من باقة الثمار العلمية ما تراه منسجماً مع إيمانها وحياتها وخبرتها في الروح القدس. الكنيسة ليست ملزمة بكل محصل العلماء وثمارهم. تقنياتهم ملك لهم، أما الاختيار فهو للكنيسة.
الكنيسة تؤمن أن العلماء قادرون على تقديم مفاتيح التفسير النّصّي (textual clues). هذا الكلام بداهة، ولا خلاف حوله.
والدليل عليه، دخول الكنيسة في كل مكان، على خط العلماء، وقبولها للعديد من ثمارهم. لكن، هل تقدم العلوم الكتابية مفاتيح التفسير وحسب، أم أنها تدّعي احتكار التفسير أيضا؟ ألا يجوز القول أن من يمتلك مفاتيح التفسير، يستطيع أن يمتلك القدرة على التفسير ايضاً؟
في الحقيقة هذا سؤال كبير، والرد عليه يستدعي معرفة ماهية علوم التفسير من جهة، وماهية الكنيسة، من جهة أخرى.
قد يكون بين العلماء أناس كبار بالإيمان والروح، عندئذ يمكننا القول أن لمثل هؤلاء الحق في التفسير. أما إذا كان هناك أناس يحفزهم إلى العمل والمعرفة حب المعرفة، وحسب، عندها لا يكون التفسير ملكاً لهم. ولكن ما معنى القول أن العلوم الكتابية (biblical sciences) تقدم المفاتيح، بينما الكنيسة تمسك بالتفسير أو تحتكره؟ كيف نفهم الفصل بين العلماء والكنيسة في هذا المضمار؟ ألا يستطيع من يمتلك المفاتيح، أن يفتح بها الأبواب، فيدخل إلى رحاب الحقيقة والتفسير؟
لماذا يحتجب المعنى على من بيده مفاتيح التفسير، بينما يكون التفسير من حقّ الكنيسة التي لا تمتلك مفاتيح التفسير وتقنيات البحث والمقارنة؟ أيعقل أن واحداً يمتلك المفاتيح بينما آخر يفتح ويدخل الى اللباب والعمق؟ واذا كان التفسير حكراً على الكنيسة، عندها سنقع في مأزق كبير: أين تبقى قيمة العلماء ومكانتهم؟
الكنيسة حاضنة الكتاب، لأنها عروس المسيح المجيدة التي لا غضن فيها ولا وسخ (blemish). الكنيسة هي التي تقيس الكتاب على حياتها وخبرتها في الروح القدس. هي التي تحكم في أصالته على أنوار الروح القدس. ولكن ألا ترتعد فرائص البعض عندما يسمعون ان الكنيسة هي التي تحكم على الكتاب؟ ألا يرون في النظرة شيئاً من كفر وهرطقة؟
الأمر بداهة للمؤمن، لأن الكتاب هو سفر الكنيسة، ولأن الكنيسة هي التي حزمت أمرها وأعلنت موقفها من مسألة الأسفار غير القانونية. الكنيسة هي التي قالت: هذا غث وهذا ثمين، وذلك على نور الروح الذي تختبر في أعماقها وحياتها.
لكن لا يجوز أن ننسى أن الكنيسة التي فعلا هذا، هي بدورها تحتكم الى الكتاب فتقيس به حياتها. الكتاب المقدس هو معيار مناقبية الكنيسة (ethics) وحياتها وسلوكها وتعليمها في كل زمان. الكنيسة لا تقدّم شيئاً لا ينسجم مع فحوى الكاتب.
الكتاب المقدّس هو ركيزة الكنيسة في التصدّي لمشكلات زمانها. لهذا السبب، نرى المؤمنين يطوفون بالكتاب، ويقبّلونه ويتبركون به ويسمعونه ويتعظون بالروح الذي نفخ فيه والهم الذين كتبوه. إذاً ثمة حقيقتان لا تصارع بينهما، ولا مفر منهما:
(1) الكنيسة تقيس الكتاب على أنوار خبرتها في الروح.
(2) الكنيسة تقيس نفسها بالكتاب لتنمو به ومن خلاله الى ملء قامة المسيح.
في الواقع، ليس من السهل الفصل بين الكنيسة والكتاب.فهو يجسّد حياتها، وهي، على نور أصالة حياتها، تحكم فيه، لأنه قد خرج منها، ولأنها بدورها خرجت من جنب السيد. من هنا تأتي إلى أمر بسيط مفاده ان العلماء يتعاملون مع الكتاب كموضوع بحث ودراسة، بينما الكنيسة تتعامل معه كنبع حياة. وفي هذا كل الفرق. وهنا نأتي الى منعطف آخر: يستحيل، في التحليل الأخير أن تنمو العلوم النقدية الكتابية (biblical critical sciences) بمعزل عن الكنيسة.
فالنقد العلمي للكتاب ليس في النهاية جهداً هوائياً (in vaccuo)، رغم الاحترام الكامل لكل العلماء ولكل أتعابهم. العلم الحقيقي طاقة خير. إلا انه قفزة حيادية. العلم الكتابي هو خطة عمل، أو قل برنامج بلا حدود وآفاق. إطاره الكلمة، والكلمة الالهية لا تُحد ولا تُستنفد بدون الكنيسة، لا معنى للتفسير ولا جدوى منه.
وعلم التفسير من شأنه أن يميط اللثام عن غوامض الكتاب المقدس التي أوجدها البون القائم بين الازمان والحضارات. لذا فنحن نعتمد ثمار العلماء التي تنسجم مع إيماننا وحياتنا وذلك كي ينكشف المعنى فنأتي الى قراءة سوية وفهم صحيح. ان عرق العلماء هو إسهام منهم، — رغم تعدّد الدوافع والغايات عند العلماء، — في بلورة القراءة السليمة. إلا أن تمثل الثمار العلمية هو رهن باللاهوتيين والقديسين. الكنيسة، في التحليل الأخير، هي التي تحكم على جهود العلماء وتنتقي منها. بدون الكنيسة لا معنى لجهود العلماء.
وطوّر العلماء مناهجهم، وكان لابد أن يماشي التطور دقة الموضوع وأهميته. بعض العلماء أدركوا مكانة الكنيسة الأولى، وتيقنوا أنها لعبت دوراً مميزاً في حفظ ونقل الشهادات التي تسلمتها[4] ودار في أوساط العلماء جدال طويل، دام عقودا وسنين، حول أصل وولادة التقاليد أو المدارس التي أخذ بها التي دوّنوا الأسفار الالهية الملهمة والموحاة. وهذا من شأنه، إذا أخذ في الحسبان، أن يعيننا على معرفة كيفية التدوين، وبالتالي، على فهم البيئة التي رعت ولادة النص.
وفهم الكتاب المقدس على مبدأ: «الكتاب فقط»[5] هو موقف علمي بكل تأكيد، لكنه لا يكفي، لأن التفسير المسيحي ليس موقفاً معزولا (self-contained) بل يحتاج الى ما هو أبعد من النص الكتابي البحت، وذلك لأن التعاطي مع الكتاب ليس — من المنظور المسيحي — مرهوناً بالكتاب فقط، وهذا من مستلزمات التفسير. كيف؟
الليتورجيا الكنسية، هي شكل من أشكال التفسير أيضاً. لا بل أن من أعمق غايات الليتورجيا أن تقدّم للمؤمنين مادة الكتاب بأسلوب ممسرح. والأمر نفسه تضطلع به الأيقونة، وإلا عُدّت خارج الكنيسة وباتت فناً بحتاً، وهذا مرفوض. فنحن ليس عندنا فن من أجل الفن، أو ليتورجيا ممسرحة من أجل ذاتها.
في الليتورجيا ثمة أنوار مقدّسة، مسلّطة على العيد والمناسبة التي يكون المؤمن بصددها. وفي الليتورجيا المسيحية الارثوذكسية ثمة نصوص كتابية خصصت لكل عيد. وفي هذا يتجلّى فهم الكنيسة للكتاب وللحدث المعيّد له بآن معاً.
لكن ثمة مشكلة تطرح حول تفسير الكتاب. لا تفسير حقيقي للكتاب بدون رابط (connector) وهذا الرابط وجوده ضروري لجمع الكاتب والقارئ إلى مائدة واحدة. ترى ما هي صفات هذا الرابط، وأين نتعرف عليه؟
الرابط هذا هو جسر يصل بين الكاتب والقارئ، من جهة، وبين الكاتب والمفسر، من جهة ثانية. ولابد من مسلّمة مفادها أن الرابط في التفسير (exegetical connector) هو جسر بين الشهادة الرسولية التي احتضنت التدوين، وبين الحياة الحاضرة. في هذا الرابط تكمن الضمانة الواجبة لكل قراءة وتفسير. الرابط التفسيري هذا، هو الضامن أن ما دوّنه الكاتب، هو نفسه ما سوف يدركه القارئ والمفسر بآن معاً، وإلا فمن يضمن وصول الرسالة إلى غايتها؟
ما من شكّ ان علم التفسير يسهم إلى حد بعيد في تقليص البون بين زمان الكتابة وزمان القراءة. لكن مهما كانت خدمته جليلة، فهو سيبقى عاجزاً، كعلم، عن رأب الصدع والغاء البون القائم. ان عملية الربط بين الكاتب والقارئ، هي مضمار لا شأن للعلم به، وذلك لأن الرابط أو الجامع يتجاوز حدود العلم مهما اتسعت. لماذا؟ لأن الرابط هذا ليس موضوعاً علمياً، وهو نفسه مصدر التدوين والفهم والتفسير. من أوحى للكاتب كي يكتب، هو نفسه سيلهم من يقرأ ومن يفهم ومن يفسر بآن معاً.
الرابط التفسيري هذا هو الروح القدس الذي نطق بالأنبياء على ما نقول في دستور إيماننا. الروح القدس هو الجسر الحقيقي بين الكاتب والقارئ، لأنه الرب المحيّي المنبثق من الآب. وهو نفسه سوف يأخذ مما للمسيح ويعطينا حسب قول الرب (يوحنا 16: 14).
لقد أدرك اللاهوتيين الكاثوليك المعروفون بطول الباع في ميادين العلوم الكتابية، ان الروح القدس هو الرابط التفسيري[6]، حتى ان العالم الكبير الآب هنري كازيل شرع يتخطى صحبة من الوجوديين، ليشير إلى فهم الكلمة عبر الاتصال بالروح القدس. وهنا يبرز سؤال: وكيف يعمل الروح القدس كرابط تفسيري exegetical connector ، فيحقق الماضي الرسولي في حاضرنا هذا؟ هل ثمة دعوة مبطّنة الى مأزق تفسيري؟ ألا يعني هذا ان ثمة معنى مزدوجاً للنص الكتابي: واحد يقوم في النص الحرفي، وآخر في المعنى الروحي؟ أيعقل أن يكون المعنى الحرفي مبايناً للمعنى الروحي؟
لقد وجد الرمزيون (allegorists) في رسائل بولس الرسول ما يدعم نزعتهم التأويلية في التفسير، وذلك باقتباس القول التالي للرسول: «… وختان القلب بالروح القدس لا بالكتاب هو الختان» (رومية 2: 29). وأيضاً: «… ظاهرين انكم رسالة المسيح مخدومة منّا مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي» (2 كور 3: 3).
في الواقع لا يقول الرسول بما يدعو إليه الرمزيون واعوانهم، وهذا ما نستدلّ عليه في قوله: «قولوا لي انتم الذين تريدون ان تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب انه كان لإبراهيم ابنان واحد من الجارية والآخر من الحرة. لكن الذي من الجارية كان حسب الجسد، واما الذي من الحرة، فبالموعد. وكل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان: أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية والذي هو هاجر. لأن هاجر جبل سيناء في العربية. ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها.
وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعاً، فهي حرة. لأنه مكتوب افرحي ايتها العاقر التي لم تلد. اهتفي واصرخي ايتها التي لم تتمخض فإن اولاد الموحشة اكثر من التي لها زوج. وأما نحن ايها الأخوة فنظير اسحاق اولاد الموعد. ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضاً. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذاً لسنا ايها الأخوة اولاد الجارية، بل اولاد الحرة» (غلا 4: 21—31). هاجر وسارة يفسران رمزياً على انهما اسرائيل والكنيسة.
وعمد بعض المفسرين، — تحت تأثير الهلّينستي —، إلى تفسير هذه الثنائية البوليسية (الحرف والروح)، فقالوا، بمعنيين: واحد روحي، وآخر تاريخي، وذلك باقتباسات من رسائل بولس نفسها: (راجع رومية الإصحاح الخامس) وأيضاً: (1 كور إصحاح 15). وايضاً: (1 كور 10)، وذلك لأن بولس الرسول يعتبر خبرة إسرائيل في البرية كنموذج نبوي يعلن ما سيأتي في الزمن الاسكاتولوچي[7].
في الواقع، لقد أسهم العلامة اوريجانوس — من خلال نظريته في التفسير وعلى اساس الثالوث الإنساني (الجسد، النفس، والروح)، — رفع الحيف عن عدد كبير من المقاطع الكتابية الغامضة. وقد دعم نظريته في التفسير يما ورد في سفر الأمثال: «ألم اكتب إليكم بطرق ثلاثة؟» (امثال 22: 20). كذلك فقد رأى في صورة فلك نوح ضالته المنشودة فقد كان الفلك مؤلفاً من ثلاث طبقات… لقد رأى اوريجانوس أن الكتاب المقدس ملئ بالمعاني الروحية لذلك لم يستطع — كما يقول — ان يتوقف عند المعنى الحرفي ويكتفي به[8].
إلا أن التوغل في تفسير حرفي، وفي آخر روحي، من شأنه أن يلغي مكانة الروح القدس ودوره كجسر بين الكاتب والقارئ، من جهة، وبين الكاتب والمفسرين من جهة ثانية. ومن شأن ذلك أيضاً أن يرمي بنا إلى تمزيق الكتاب المقدس من خلال أبرز المخاطر التي تحلّ بنا بسبب من هذا التقسيم المزعوم.
وعمل الروح القدس لا ينحصر في حدود الوحي الكتابي كما ولا ينحصر في أنه آلهم الذين دوّنوا وكتبوا. ان نطاق الروح لا يحد «فالروح يهب حيث يشاء…». الروح القدس لا يرتهن بالإرادة البشرية. وهو يدخل تاريخنا دون أن نتمكن من قراءة اعماله بمقاييس التاريخ، لأن أعمال الروح لا يدركها إلا القلب النقي المتعطش لوصايا المسيح.
ان علم التفسير في ميدان واسع ومتشعب. ونحن لا نخشاه ولا نخاف على الكتاب المقدس منه. الله هو الذي يصوغ خلاصنا بالكلمة عبر صور وأحداث وأشخاص تترامى هنا وثمة في العهدين القديم والجديد. الله قادر بالكلمة، من جهة، مقرونة بطاعة الإنسان لله، من جهة ثانية، أن يقينا الانزلاق والزلل. والكتاب المقدس يُعدّنا ويقود خطانا في معارج العتق والحرية من خلال العهدين معاً وذلك لأن يسوع قال: «موسى والأنبياء عني تكلموا» (لوقا 24: 27).
«موسى والأنبياء عني تكلموا» (لوقا 24: 27)
يسوع له المجد، يؤكد في الاقتباس المذكور (لوقا 24: 27)، ان الأنبياء سبق أن تكلموا عنه قبل تجسده. ما معنى هذا؟
انه يعني ان نشاط الأنبياء، أو بكلام آخر الإتجاهية النبوية (prophetic directionality) كانت في حركة إلى الأمام، إلى الآتي، إلى يسوع المسيح. الأنبياء كانوا يضطلعون بمهمة قيادة الناس نحو يسوع مسّيّا المنتظر. لنسمع ما يقوله الكتاب المقدس بهذا الصدد: «فيلبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء…» (يوحنا 1: 45). وأيضاً: «ابوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي، فرأى وفرح» (يوحنا 8: 56).
وأيضاً: «بولس عبد ليسوع المسيح، المدعو رسولا، المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة» (رومية 1: 1) وأيضاً: «كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوساً للرب… وهذا كان بارا ً تقياً ينتظر تعزية إسرائيل… وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في اورشليم…» (لوقا 2: 23—39). وأيضاً: «… لان جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا» (متّى 11: 12—15). وأيضاً: «… خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني… اما هذا كله فقد كان لكي تكّمل كتب الأنبياء» (متّى 26: 56).
[1] لقد استعمل القديس باسيليوس الكبير حروف الجر كثيراً في دفاعه عن ألوهية الروح القدس وذلك باعتماده للشواهد من الكتاب المقدس: (في الروح القدس).
[2] نحن في بلادنا تربينا وما نزال على إحتقار الجغرافيا والتاريخ وذلك لأن أهلنا ظنوا أن الرياضيات والعلوم هي وحدها تكفي لحياتنا وثقافتنا. وفي هذا جهل كبير وتجزئه للحياة العلمية والثقافية بآن معاً.
[3] هذه الملاحظة تنطبق على العهدين: القديم والجديد.
[4] See «The first day of the new creation», V. Kesich, S. V. S. Press, p: 17.
[5] Sola scriptura.
[6] La nouvelle herméneutique biblique, Bruxelle, 1969, p: 10.
[7] A. Robert and A. feuillet, Introduction à la Bible, Tournai (Bleg), 1959, p: 181.
[8] في المبادئ 4: 3-5.