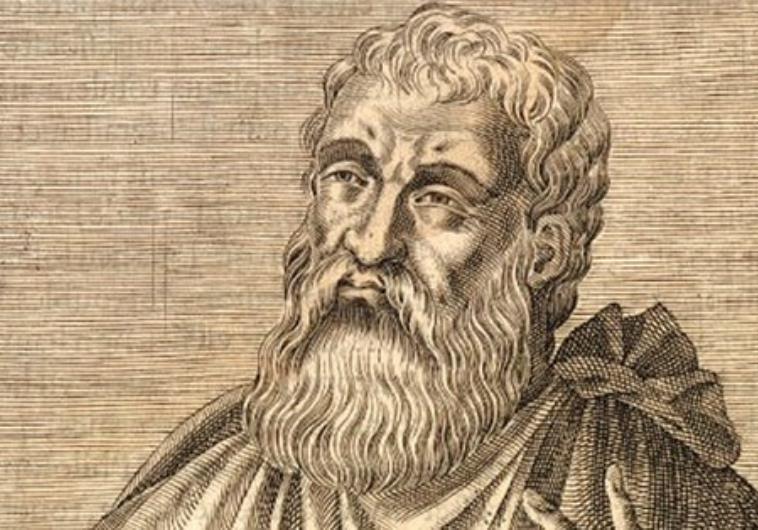أساليب النقد النصي – استرداد صياغة النص الأصلي للعهد الجديد
أساليب النقد النصي - استرداد صياغة النص الأصلي للعهد الجديد
أساليب النقد النصي – استرداد صياغة النص الأصلي للعهد الجديد

أساليب النقد النصي – استرداد صياغة النص الأصلي للعهد الجديد
كيف يمكن لنقّاد النصوص أن يحددوا الصياغة الأصلية للعهد الجديد، بوجود هذا الكم الهائل من المواد تحت تصرفهم، فإن المخطوطات تختلف مع بعضها البعض بصورة كبيرة، مما يعني أنه يجب استخدام بعض الوسائل للفصل فيها. باختصار، كيف يمكن للعلماء أن يعرفوا أياً من النصوص المختلفة هو النص الأصلي.
بالنسبة للغالبية العظمى من الاختلافات النصية، لا توجد ببساطة أية مشكلة في تحديد الصياغة الأصلية، ولكن فيما يختص بنسبة ضئيلة من الاختلافات لا بد من وجود مجموعة من الوسائل مجتمعة لتكون هي المفتاح في تحديد الصياغة الأصلية.
أولاً، يقوم العلماء بفحص البرهان الخارجي -المخطوطات، والترجمات، والاقتباسات الكتابية التي استخدمها آباء الكنيسة. وهناك طرق يمكننا بها أن نعرف من البيانات الخارجية مدى قدم نص معين.
ثانياً، يقوم العلماء بفحص البرهان الداخلي -أي العادات وأساليب كتابة المؤلفين، وأيضاً عادات وحتى أخطاء الكتّاب.
وهاتان الوسيلتان يتم التعامل مع كل منهما بصورة مستقلة عن الأخرى، ثم تتم مقارنة النتائج. لكن العامل الفصل في كل هذا المجهود المضني هو هذا: النص الذي ينشأ عنه نصوص أخرى يكون في الأرجح هو النص الأصلي. وعندما يشير البرهان الخارجي والداخلي إلى نفس الاتجاه، يكون لدى نقاد النص ثقة كبيرة في أن لديهم الصياغة الأصلية. وسوف نشرح باختصار هذه العملية ثم نختم بمثال أو اثنين لكي نوضح بصوة عملية كيف تتم هذه العملية.
البرهان الخارجي
توجد ثلاثة معاير خارجية تستخدم للحكم على الاختلافات وإظهار أي منها هو الأرجح أن يكون الصياغة الأصلية: تاريخ المخطوطة وسماتها؛ واتصال النسب؛ والتوزيع الجغرافي.
تاريخ المخطوطة وسماتها
عادة ما يكون الاختلاف أو النص المفضّل هو ذلك الموجود في أقدم المخطوطات. فقصر الوقت الذي يمر بين تلك المخطوطات وبين الأصل، والعدد الأقل من النسخ الداخلة بينهما يقلل من الأخطاء. وكلما كان الخط الواصل بين المخطوطة والأصل مباشراً كلما كانت فرصتها أفضل في أن تكون لها الصياغة الصحيحة.
كما أن المخطوطات التي تثبت أنها أكثر مصداقية في موضع آخر، يكون لها الأفضلية. وهكذا فإن الكاتب المدقق الذي يعمل على كتابة مخطوطة في القرن الخامس قد ينتج نصاً أكثر مصداقية من كاتب من القرن الثالث يكون اهتمامه الأكثر هو إنهاء مهمته وعمله بسرعة.
أما بالنسبة للسمات، فعادة ما يعتبر الأكثر أهمية هو أن نرى ما إذا كان المخطوطة التي لدينا شاهدة جيدة لصياغة نصها أكثر منها للنص الأصلي، وهذا لأن الطريق لصياغة النص الأصلي يمر عبر أساليب مختلفة للنص. يعتبر هذا تمييزاً مهماً، ولكن لابد من الوصول إليه في عملية النقد النصي.
وهكذا فإن تاريخ المخطوطات هو عامل مهم في تحديد قيمة نص معين، كما أن السمات العامة لإحدى المخطوطات، على الأقل في علاقتها بصياغة نصها، هي أيضاً عامل مهم.
اتصال النسب
تمت كتابة معظم المخطوطات في أماكن كان يتم فيها نسخ بعض الاختلافات التعليمية بصورة متكررة. هذا معناه أن معظم المخطوطات تجد أصولها في سلف محلي (أو ما يمكننا أن نطلق عليه أصل إقليمي) له تأثيره على ما تلاه في تلك المنطقة. وهكذا تظهر الأنماط الجغرافية للنصوص، معطية كل منطقة أسلوباً مميزاً للنص. وعندما تتفق جميع أو معظم المخطوطات المعروفة بانتمائها لأسلوب نص معين على قراءة نص ما، يمكن للمرء أن يستنتج أن السلف المحلي لأسلوب النص هذا ربما كان يحوي تلك القراءة النصية.
لكن ما هو بالضبط أسلوب النص؟ تقدم الثقافة المسيحية الإنجليزية قياساً حديثاً. فكثيراً، عندما يسمع الناس في الكنيسة واعظاً يقرأ من الكتاب المقدس، يمكنهم أن يميزوا أي من التراجم المتعدد بالإنجليزية يستخدمها -حتى عندما تكون هذه الترجمة غير موجودة أمامهم. وهذا لأن كل ترجمة تأخذ نمطاً ذا أسلوب معين في استخدام اللغة. ولذلك فإن ترجمة “كينج جيمس” تبدو للسامع قديمة ولكنها أنيقة؛ أما “النسخة الدولية الجديدة NIV” فتبدو أكثر كأسلوب محادثة؛ بينما تبدو ترجمة “الرسالة Message” مفعمة بالحياة.
والآن، لنفترض أن آلة الطباعة لم تخترع، وأن كل قسيس كان عليه أن يقضي العام الأول من خدمته في التدرب على كتابة نسخته الخاصة من الكتاب المقدس. وقتها يوجد في كل كلية لاهوت نسخة مختلفة من الكتاب المقدس تستخدم فيها، ويكون من المتوقع أن يعرف الطلاب هذه النسخة جيداً.
عندها يمكن للطلاب في مكان ما أن يكتبوا نسخة من الترجمة المتاحة؛ والطلاب في مكان آخر يكتبون نسختهم من ترجمة أخرى، وهكذا. ستكون النتيجة أنه لن تكون هناك نسخة واحدة مكتوبة بخط اليد من الترجمات المختلفة تماثل تماماً “الأصل المتاح”، ولكنها ستكون قريبة منه، ومقارنة بعضها بالبعض الآخر ستساعد الشخص على أن يرى ماذا كان شكل الأصل المتاح في المكان أو الإقليم.
ثم لنفترض الآن أن مئات السنين قد مرت وأن كل ما تبقى من نسخ بعض الترجمات، هو عبارة عن دستة من النسخ أو ما نحو ذلك من كل “أسلوب نصي”. ولكن واحدة من نسخ إحدى الترجمات تم العثور عليها في مكان ما، وكان بها العديد من النصوص المشابهة لنسخة ترجمة أخرى. في تلك الحالة سيقول المرء إن تلك المخطوطة بها خلط، وحتى لو كانت قديمة، فإن الخلط سيجعلها أقل أهمية من نسخة الترجمة الأخرى الأصلية أو المطابقة للأصل تماماً التي جاءت بعدها.
وسوف تكون أقل أهمية لأنها لن تكون شاهدة ذات مصداقية لأسلوب نصها. هذه هي الطريقة التي يتم بها تقييم “سمات” المخطوطة: هل هي قريبة من صياغة أصلها المحلي، أم أن بها مزيج من أكثر من أسلوب نصي آخر؟ الاختيار الأول أفضل من الثاني لأنه يساعد في محاولة العودة إلى صياغة الأصل المحلي.
يشبه نص العهد الجديد هذا الأمر، فهناك ثلاثة أساليب نصية رئيسية، وهي، الإسكندري، والغربي، والبيزنطي. فالأسلوب الإسكندري تم إنتاجه بوجه خاص في مصر، والغربي تم إنتاجه في روما وفي الغرب (رغم أنه أنتج في أماكن أخرى كذلك)، والبيزنطي أنتج معظمه في الشرق. ويتفق معظم العلماء على أن أسلوب النص الإسكندري بدأ في القرن الثاني، مثل الأسلوب الغربي، بينما النص البيزنطي في تطور لاحق، مبني بصورة كبيرة على المخطوطات الغربية والإسكندرية.
1 على أن أفضل المخطوطات الإسكندرية هي تلك التي ليس بها خليط من القراءات النصية الغربية أو البيزنطية. وعندما ينظر المرء إلى جميع المخطوطات الإسكندرية، فإنه يرى نمطاً ما من القراءة النصية. وعندما يكون للمخطوطات الإسكندرية الأفضل نفس القراءة النصية، يستطيع عندها العلماء أن يتأكدوا نسبياً من أن الأصل المحلي الإسكندري كانت له تلك القراءة النصية. وهذا الأمر صحيح حتى لو لم يعد ذلك الأصل المحلي موجوداً. هذا استنتاج بسيط من البراهين المتوفرة.
وهكذا فإننا بواسطة اتصال النسب، يمكننا أن نرجع بتاريخ القراءة النصية داخل إطار أسلوب النص إلى أصلها المحلي. يشبه هذا الأمر الاستنتاج الذي يمكن أن يتوصل إليه المرء إذا استطاع أن يلتقي مع عائلة ممتدة مكونة من خمسين من السويديين ذوي العيون الزرقاء، إذ كان لأجدادهم في الأغلب عيون زرقاء أيضاً.
وحيث أن النصوص الإسكندرية والغربية لها جذور يرجع تاريخها إلى القرن الثاني (الأمر الذي يمكن تأكيده بواسطة اقتباسات آباء الكنيسة من مناطق معينة في القرن الثاني)، فإنه عندما يكون لكل من هذه الأساليب النصية اتصال نسبي، فقد يقال إن قراءاتهم النصية يرجع تاريخها إلى القرن الثاني.
فكّر مثلاً في عائلتين هاجر أجدادهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بدايات القرن التاسع عشر. بالنسبة لعائلة “دود” هناك اتفاق تاريخي على المكان الذي جاءوا منه. والعام الذين وصلوا فيه، والمكان الذي استقروا فيه، أي أنهم جاءوا من ويلز، عام 1833، واستقروا في نيويورك. وتتفق في ذلك جميع المصادر تقريباً سواء كانت مصادر حية أو عبارة عن مذكرات ورسائل من الأجيال السابقة. مع العلم بأن بعض المصادر اللاحقة لديها معلومات مختلفة، ولكن هناك اختلاف بسيط للغاية فيها.
ففي إحدى الرسائل التي كتبتها طفلة في الثانية عشرة من العمر، تقولت إن اجدادها وصلوا عام 1883، بينما في مذكرات أحد الأشخاص الذين تزوجوا داخل هذه العائلة مذكور أنهم جاءوا من إنجلترا. وهكذا فبالرغم من أنه ليست جميع السجلات تتفق معاً بالكامل، إلا أن أفضل الشهادات تتفق، والشهادات المنحرفة عن ذلك لا تبتعد كثيراً.
وأكثر من ذلك، يمكن تفسير الانحرافات. ففي إحدى الحالات، يرجع الاختلاف إلى المصادفة أو الزلل (1883 مقابل 1833)، بينما في حالة أخرى قد يرجع الاختلاف إلى الاتجاه باستبدال ما هو غير مألوف بما هو مألوف ومعروف.
أما عائلة “والاس” فتاريخها أقل دقة. فيقول البعض أن الأجداد قد جاءوا إلى الولايات المتحدة عام 1819، بينما يقول آخرون أنهم جاءوا عام 1847. ويقول البعض أن الأجداد قد أتوا من اسكتلندا، بينما يقول آخرون أنهم جاءوا من ألمانيا؛ 2كما يقول البعض أن الأجداد قد استقروا في بوسطن، ولكن هناك آخرون يقولون إنهم استقروا في رود أيلاند. فعندما تكون هناك تناقضات من هذا النوع، لا يكون هناك اتصال نسبي، وتحتاج الحقيقة أن تتحدد بواسطة وسائل أخرى.
لكن بالنسبة لعائلة “دود” فإن لديها تاريخ ثابت ومتسق، والاتصال النسبي يفترض أن هذا التاريخ يرجع إلى عام 1833. ومع ذلك فإن الاتصال النسبي في حد ذاته لا يعتبر كافياً لإثبات أن قراءة نصية معينة هو القراءة الأصلية، ولكنه يظهر بالفعل أنها أقدم من أي من المخطوطات الأخرى الباقية من نفس هذا الأسلوب.
وحتى عندما تكون مخطوطات أسلوب النص الإسكندري ليست قوية تماماً، يمكن للمرء في أغلب الأحيان أن يفترض تاريخاً لتيارين من التعليم الذين سبقا تاريخ الشهادات الباقية. وهذا لأن النص الإسكندري كان له على الأرجح فرعان -الإسكندري الأولي، الإسكندري الثانوي. وكل من هذين الفرعين هو تيار قديم في النقل، ولكن التيار الإسكندري الأولي تم إنتاجه بعناية أكثر.
ولذلك فحتى لو كانت النسخ الأصلية لمختلف الأصول الاقليمية قد اختفت، فمن الممكن افتراض تاريخ لإحدى الاختلافات التي يسبق تاريخها أياً من المخطوطات التي وجد فيها هذا الاختلاف.
التوزيع الجغرافي
إن الاختلاف الذي يوجد في مناطق جغرافية منتشرة في القرون القليلة الأولى للحقبة المسيحية من الأرجح أن يكون اصلياً أكثر مما نكون الاختلاف الذي يوجد في منطقة واحدة فقط. فتواطؤ الشهود يقل احتماله بأكثر ما يمكن عندما يكون الشهود موزعين في روما والإسكندرية وقيصرية أكثر مما يقل عندما يكونون جميعهم في أورشليم أو أنطاكية.
ولذلك، إذا كانت هناك مخطوطة من القرن الثالث في مصر، وترجمة من القرن الثالث في روما، وأحد آباء الكنيسة من القرن الثالث في فرنسا، اتفقوا جميعاُ على صياغة مقطع ما، فإن الفرص المتاحة هي أن يكونوا جميعهم نسخاً من مصدر أقدم. فالانتشار الجغرافي للمصادر التي تتفق مع بعضها البعض هو عامل شديد الأهمية في تحديد صياغة النص الأصلي.
لكن هذا لا يوضح فقط أن قراءة معينة للنص لم يتم إنتاجها بواسطة نوع من التعاون، ولكنه يوضح أيضاً أن القراءة النصية هي أكثر قدماً من أي من المصادر الموجودة. بواسطة هذه الوسيلة، يمكن للعلماء شرعياً أن “يرجعوا” بتاريخ قراءة نصية إلى زمن يسبق تاريخ المصادر التي تشهد لها.
لنفكر ثانية في القياس الذي قمنا به في عائلتي “دود” و”والاس”. إذا أكدت عائلة أخرى، لا تمت بقرابة لأي من هاتين العائلتين، بعض المعلومات الموجودة في سجلات عائلة “دود” أو “والاس”، فسيكون هذا مشابهاً لتأثير التوزيع الجغرافي. فلا توجد علاقة بين هذه العائلة الأخرى وعائلة دود أو عائلة والاس، ومع ذلك، فإنها تقدم شهادة مستقلة تؤكد حقيقة الأحداث المدونة في سجلات عائلة دود أو عائلة والاس. وهذا النوع من “الشهادة المتعددة” يقوي احتمالية أن تكون تلك الأحداث قد وقعت بالفعل.
لكن هذا البرهان ليس دليلاً في حد ذاته، إذ أنه يمكن أن تكون هناك أسباب مستقلة لكل مجموعة من السجلات تجعلها تقول نفس الشيء، كما سنرى فيما بعد. لكن رغم أن التوزيع الجغرافي ليس معصوماً من الخطأ، إلا أنه عامل مهم في تحديد صياغة العهد الجديد الأصلية.
يجب الإشارة إلى أنه بعد الأربعة القرون الأولى، لم يعد التوزيع الجغرافي بنفس الفائدة تقريباً حيث أنه بحلول هذا الوقت كان هناك مزج على نطاق واسع بين المخطوطات، بسبب حرية تبادل المعلومات التي انتشرت بمجرد أن أصبحت المسيحية ديانة شرعية.
كما يمكن أن يتم تمثيل عامل التوزيع الجغرافي بصورة غير كاملة بالاختلافات التي تحدث في “لعبة الهاتف”. ففي هذه اللعبة يتم وقوف صف من الناس، ثم يقوم أول فرد فيهم بالهمس بكلام ما في أذن الشخص الذي يليه، وبتكرار الرسالة المنقولة من شخص إلى آخر عبر الصف فإنها تصل في النهاية مشوهة. الهدف من لعبة الهاتف هذه في الحقيقة هو أن نرى كيف يمكن أن تتشوه الرسالة الأصلية. فليس هناك دافع “للوصول بالرسالة صحيحة”.
ولكن لنفترض أنه بدلاً من استخدام صف واحد من الناس، فإننا سنستخدم ثلاثة صفوف، ولن يكون الشخص الأخير في الصف هو الشخص الوحيد الذي يقول ما الذي أصبحت عليه الرسالة، بل يكون في إمكاننا أن نعرف كيف تم فهم الرسالة في نقاط مختلفة عبر الطريق. عندها ربما يتمكن المرء جيداً من إعادة بناء الكثير مما نطق به في الأصل بمقارنة الصفوف الثلاثة والعثور على الأشياء المشتركة بينها. هذا هو تأثير التوزيع الجغرافي.
وبأخذ خطوة أبعد، لنفترض أنه تم تحديد أن واحداً من هذه الصفوف كان أكثر دقة من الصفين الآخرين في نقل القول الأصلي. ويمكن اختبار هذا الأمر بسماع ما يقوله شخص “في بداية الصف” بالمقارنة بما يقوله شخص آخر في نهايته، فإن كان هناك تغيير بسيط للغاية من هذا الشخص للآخر، فإن هذا الصف يعتبر متفوقاً على الصفين الآخرين. لكن لكي نحل هذا اللغز، يجب استحضار البرهان الداخلي.
فتاريخ وسمات المخطوطة، والاتصال النسبي فيها، والتوزيع الجغرافي لها، هم ثلاثة أدلة في المعلومات الخارجية التي تساعدنا على تحديد أية قراءة نصية هي الأقدم -وهي القراءة التي نشأت منها بقية القراءات. ولكن البرهان الخارجي ليس هو المنهاج الكامل. فمثلاً، في الأماكن التي تختلف فيها المخطوطات القديمة عن بعضها البعض، أو التي يكون فيها التوزيع الجغرافي ضئيلاً، أو التي تكون فيها القراءة النصية مجرد نوع الصياغة التي يحتمل أن يكون الكاتب قد ألفها، هنا، قد يكون البرهان الداخلي هو الأكثر أهمية.
البرهان الداخلي
البرهان الداخلي هو اختبار صياغة الاختلافات من أجل تحديد أية قراء نصية هي التي تسببت في نشأة قراءة ما أو قراءات أخرى، وربما تكون بالتالي هي الأصلي.
قواعد البراهين الداخلي
إن الدليل الإرشادي الأساسي في النقد الداخلي هو هذا: اختر القراءة النصية التي تشرح بأفضل صورة نشأة القراءة أو القراءات النصية الأخرى. وهذا هو نفس القانون الذي ينطبق على كل نقد نصي، سواء خارجي أو داخلي. فهو نفس المبدأ، رغم اختلاف الوسائل (التي تكون مكملة لبعضها البعض). إن الحكم في البرهان الداخلي هو أمر شديد الذاتية، ولكنه أحياناً يكون شديد الموضوعية. فكل شخص يمارس هذا النوع من النقد النصي كل يوم. يوضّح ديفيد باركر هذا الأمر بإبداع في كتابه، “النص الحي للأناجيل”، قائلاً:
إن كل شخص يقوم بقراءة الصحف اليومية هو خبير في النقد النصي، في تكيفه مع تلك الأخطاء الواضحة للحزف، واستبدال أسطر بأخرى، والخلط بين الحروف. هذه العملية المتطورة في إدراك الكلمات التي لا تحمل معنى والتعرف على المعنى المقصود هي عملية طبيعية للغاية بالنسبة لنا، نحن العلماء الكلاسيكيين للإسكندرية القديمة أو الرهبان البينيدكتيين، حتى إننا نقوم بها بدون تفكير، وبدون وعي بقرابتنا لسانت مور. فالنقد النصي ليس علماً غامضاً، ولكنه يخص جمع الصلات البشرية.3
بالرغم من أن بعض الأخطاء التي وردت في المقطع السابق قد تستغرق منا بعض الوقت لتمييزها، فإن لا بد وأن تكون قد تمكنت من اكتشافها تماماً. لذلك فأنت لا تحتاج إلى مخطوطة أخرى لكي تقارن بها ذلك المقطع؛ إذ أنك تستطيع أن تحدد ما قد المؤلف أن يقوله ببساطة بواسطة فحص الصياغة وإزالة الأخطاء المعروفة. هذا هو البرهان الداخلي.
وبالرغم من وجود إرشادات متعددة تحت المظلة الواسعة لاختيار القراءة النصية التي تشرح بأفضل ما يمكن نشأة قراءة ما أو قراءات نصية أخرى، فإن هناك اثنين من هذه الإرشادات بارزان بصورة خاصة، وهما: القراءة النصية الأصعب هي الأفضل، والقراءة النصية الأقصر هي الأفضل.4
القراءة الأصعب هي الأفضل
إن القراءة النصية الأصعب هي تلك الأكثر إرباكاً، والأكثر غموضاً، والأكثر إرهاقاً. كما أن القراءات الأصعب تستخدم أيضاً كلمات أكثر ندرة أو تتضمن صياغة يمكن فهمها على أنها متناقضة. هذه القاعدة مهمة لأن الكتّاب كانوا يميلون إلى تيسير الصعوبات الموجودة في النصوص، أكثر مما يميلون إلى خلق صعوبات.
في الفصل الرابع، أشرنا إلى أن مرقس وصف يسوع فقط باستخدام الضمائر عبر تسعة وثمانين آية متتالية. (وفي الحقيقة إن الضمائر نفسها كانت غائبة في كثير من الأحيان، حيث أن اللغة اليونانية تستخدم نهايات الأفعال للإشارة إلى الشخص وإلى العدد بالنسبة للفاعل) فكان الكتّاب بالطبيعة يريدون إضافة اسم يسوع لتوضيح الشخص الذي يتحدث عنه النص. في مثل هذه الحالات، تكون القراءة النصية الأصلية هي الأقصر والأصعب معاً.
أو لنفكر مثلاً في مشكلة نصية في إنجيل يوحنا 4. وهي تكمن في رواية لقاء يسوع مع المرأة السامرية عند البئر. فبعد حوار قصير، يأمر يسوع المرأة أن تذهب إلى بيتها وتستدعي زوجها، قائلاً: «اذْهَبِي وَادْعِي زَوْجَكِ وَتَعَالَيْ إِلَى ههُنَا» (ع16). فتجيب المرأة: «لَيْسَ لِي زَوْجٌ» (ع17). فيجيب يسوع على هذا الكلام بقوله: «حَسَنًا قُلْتِ: لَيْسَ لِي زَوْجٌ» (ع17). الآن عند هذه المرحلة كان لدى النساخ مشكلة. إذ أن يسوع قد اقتبس نفس كلمات المرأة لكنه عكس الترتيب (كما يظهر في الترجمة الإنجيلزية).
فبالنسبة لبعض هؤلاء الكتّاب يبدو وكأن يسوع قد أخطأ في اقتباس كلماتها، أو أنها هي قد قالتها بصورة خاطئة في المقام الأول. ولذلك فإنهم يقومون بتوفيق ترتيب كلماتها ليكون مثل ترتيب كلماته التي اقتبسها منها. هناك عدد قليل فقط (رغم أنه قديم) من المخطوطات هي التي تقوم بذلك، ولكنها من الواضح أنها تخلق قراءة نصية أسهل.
كثيراً ما تحدث مثل هذه الأمور في الأشياء المتشابهة في الأناجيل. فيتم تقديم قراءة أسهل لكي تتوافق صياغة إحدى الأناجيل مع إنجيل آخر. كما قام النساخ بتسهيل النحو والأسلوب بل وحتى الفكر اللاهوتي -نعم الفكر اللاهوتي. فعبر الزمن، كان الكتّاب يغيرون في صياغة النص لكي يجعلوه متسقاً بوضوح أكثر مع معتقداتهم اللاهوتية. لكن هذا لا يعني أن النص الأصلي لم يكن مستقيماً؛ ولكنه لم يكن دائماً بمثل الاستقامة الواضحة كما كان يرغب النساخ في ذلك، أو أن استقامته كانت مختلفة قليلاً عما كان يعتقده الكتّاب.
ربما وجب إيجاد تشبيه نفهم به طبيعة النص الأصلي. فبالنسبة لأولئك الذين يعرفون جيداً رواية جي آر تولكين “ملك الخواتم”، يكون لهذا المعيار معنى جيداً. فعندما تلتقي الأقزام المحاصرة بالغريب الأسود، سترايدر، عند فندق المهر الراقص، فإنها تستريح عندما تعلم أنه في جانبها. فيعلن أنه آراجورن، وأنه لو كان عدوهم لكان في إمكانه أن يقتلهم بسهولة.
وساد صمت طويل، وفي النهاية تحدث فرودو بتردد قائلاً: “كنت أعتقد أنك صديق قبل أن تأتي الرسالة، أو على الأقل كنت أتمنى ذلك. لقد أخفتني عدة مرات هذه الليلة، ولكن ليس بالطريقة التي يمكن أن يخيف بها خدام الأعداء، أو هكذا أتخيل. أعتقد أن واحداً من جواسيسه تراه يبدو جميلاً ولكنك تشعر أنه أكثر قذارة.”5
وبالمثل، فإن النص الأصلي أسلوبه صعب ويضايق المسيحيين، ولكنه في النهاية نص يمكننا أن نميزه ونثق فيه.
ولتوضيح عملية تحويل النص لكي يتوافق مع المعتقد التقليدي القويم، نجد هذا الأمر في (1تيموثاوس 3: 16)، وهي آية قد ناقشناها في الفصل السادس (أنظر ملحوظة 9). فإن صياغة “الله ظهر في الجسد” هي تأكيد واضح لألوهية المسيح، بينما صياغة “الذي ظهر في الجسد” فيها معنى ضمني لذلك فقط.6 وبالرغم من وجود كم كبير من النصوص التي تؤكد ألوهية المسيح، فإن الكتّاب التقليديين قاموا من حين إلى آخر بتغيير نصوص أخرى لكي يجعلوها تقول هذا الأمر أيضاً. وهكذا فإن القراءة الأصعب في هذه الحالة هي “الذي”.
القراءة النصية الأقصر هي الأفضل
كان لدى الكتّاب اتجاه قوي لإضافة كلمات أو جمل أكثر من أن يحذفوا. وهكذا كان النص يميل إلى الطول مع مرور الوقت، بدلاً من أن يتقلص أو يقصر -رغم أنه قد زاد بنسبة 2 في المائة فقط عبر ألف وأربعمائة عام. لم يكن الكتّاب في الأغلب يحذفون أي شيء عن عمد.7 وهكذا، وحيث أن الحذف غير المتعمد بعيد الاحتمال، تكون القراءة النصية الأقصر عادة هي الأفضل. لقد ناقشنا بالفعل من قبل إضافة اسم يسوع في العديد من الأماكن في الأناجيل حيث لم يكن مستخدماً في الأصل.
كما أنه في نهاية كل سفر من أسفار العهد الجديد، تظهر كلمة آمين، على الأقل في بعض المخطوطات. لكن مثل هذه النهاية كانت تضاف بواسطة الكتّاب بصورة روتينية إلى أسفار العهد الجديد لأن عدداً قليلاً من هذه الأسفار كان بها مثل هذه النهاية في الأصل (رو 16: 27؛ غلا 6: 18؛ يهو 25).
فمعظم الشهادات اليونانية تنهي كل سفر من أسفار العهد الجديد بكلمة آمين. فيما عدا أسفار أعمال الرسل ورسالة يعقوب ورسالة يوحنا الثالثة (وحتى في هذه الأسفار، نجد كلمة آمين موجودة في بعض المخطوطات). وهكذا فإنه اختلاف متوقع وقراءة نصية أطول.
على أن الكتّاب قاموا أيضاً بمزيد من الإضافات الأساسية. فمثلاً، في (رومية 8: 1)، يشير البرهان الخارجي بالكامل إلى صياغة، “ِإِذًا لاَ شَيْءَ مِنَ الدَّيْنُونَةِ الآنَ عَلَى الَّذِينَ هُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ”. لكن هناك اختلافان يتنافسان مع تلك الصياغة، فبعض المخطوطات تضيف “السَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الْجَسَدِ”، وأيضاً مخطوطات لاحقة تضيف “بَلْ حَسَبَ الرُّوحِ”.
وهكذا قد كان لدى الكتّاب الاتجاه بأن يضيفوا إلى النعمة، لكي يعدّلوا أو يقيّدوا العبارات المطلقة. في هذه الحالة يكون من الواضح أن القراءة الثالثة قد نشأت من الثانية، لأنها إن كان قد نشأت بدون القراءة الثانية لكانت الآية بلا معنى على الإطلاق، إذ تكون: “ِإذًا لاَ شَيْءَ مِنَ الدَّيْنُونَةِ الآنَ عَلَى الَّذِينَ هُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ َبلْ حَسَبَ الرُّوحِ”. وفي هذه الحالة تكون أقصر قراءة هي التي تسببت في نشأة القراءتين الأخريين، وهكذا نشأت القراءة الأطول.
هاتان القاعدتان شديدتا الأهمية والنفع في تحديد صياغة النص الأصلي. وفي نفس الوقت، يجب ألا يتم تطبيقهما بمعزل عن الاعتبارات الأخرى. فبعض المخطوطات، خاصة في النص الغربي، كانت معرضة لأن تحذف آيات بأكملها. وعلى الرغم من أن النص الغربي كان قديماً، إلا أنه في نفس الوقت غير متقن إلى حد ما. هنا تكمن أهمية البرهان الخارجي، إذ إنه يمارس نوعاً من الرقابة على جودة البرهان الداخلي.
أقسام البرهان الداخلي
احتمالات النسخ
إن احتماليات النسخ لها علاقة بما يحتمل أن يقوم به الكاتب (الناسخ). وهناك نوعان من التغييرات التي حدثت وقام بها الكتّاب، هما التغييرات المتعمّدة وتلك غير المتعمّدة.
في كثير من الأحيان قام الكتّاب عن عمد بتغيير النص لأسباب نحوية ولاهوتية وتفسيرية، كما أوضحنا من قبل. وهنا على وجه الخصوص نجد قاعدتي القراءة الأقصر والقراءة الأصعب مفيدتان للغاية. (انظر المناقشة التي قمنا بها من قبل للتوضيح).
على أن الكثير من التغيرات النسخية لم تكن متعمدة، فبسبب مشاكل ضعف البصر والسمع والإجهاد أو سوء الحكم، كان الكتّاب كثيراً ما يقومون بتغيير النص عن غير عمد. وقد تمت مناقشة بعض هذه الحالات في فصل سابق. لكن يمكننا هنا أن نضيف أنه كان هناك خطأ شائع لدى الكتّاب هو أنهم كانوا يكتبون مرة واحدة ما كان يجب عليهم أن يكتبوه مرتين.
ويطلق على هذا الأمر الكتابة المفردة، كان هذا يحدث خاصة عندما كانت عين الكاتب تتخطى الكلمة الثانية التي تنتهي بنفس طريقة كتابة الكلمة التي قبلها. ولكنها كانت تحدث أيضاً عندما كان سطران ينتهيان بنفس الكلمات.
فمثلاً في (1يو 2: 23)، نقرأ “كُلُّ مَنْ يُنْكِرُ الابْنَ لَيْسَ لَهُ الآبُ أَيْضًا، وَمَنْ يَعْتَرِفُ بِالابْنِ فَلَهُ الآبُ أَيْضًا.”، ففي اليونانية تنتهي كل من الجملتين “لَهُ الآبُ أَيْضًا”. فإذا تم الاختلاط بين السطرين سنحصل على قراءة مروّعة: “كل من ينكر الابن له الآب أيضاً ومن يعترف بالابن ليس له الآب أيضاً”.
إن أسلوب النص البيزنطي ليس به هذا الجزء الثاني من العدد. لكن على الرغم من أن القراءة الأقصر هي المفضّلة عادة، فإن هذا القانون لا يطبق إذا كان من المحتمل حدوث خطأ غير مقصود. وهذا مثل تقليدي للحذف غير المتعمد: فتعبير “له الآب أيضاً” في الجملة السابقة حدث به كتابة مفردة.
احتمالات الأصالة
وهذا يختبر ما كان يحتمل أن يكون كاتب السفر الأصلي قد كتبه. على الرغم من وجود أشياء أخرى، إلا أن هناك أمران أساسيان يتضمنها هذا الاحتمال، وهما -السياق أي اختلاف يلائم السياق أفضل من الآخر؟ فمثلاً، في (يوحنا 14)، يتحدث يسوع لتلاميذه في الليلة التي سبقت صلبه، وفي عدد 17 يخبرهم عن الروح القدس، فيقول: “وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهُ لأَنَّهُ مَاكِثٌ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ.” يوجد اختلاف نصي هنا: فبدلاً من “ويكون فيكم” تقول بعض المخطوطات القديمة والموثوق فيها بصورة كبيرة “وهو فيكم”.
فالفارق هنا هو بين زمن المستقبل وبين المضارع. لكن عندما يفكر المرء فيما كان المؤلف قد كتبه، يكون زمن المستقبل هو الأرجح أكثر في الاستخدام. فالسياق المباشر في (يو 14: 16) وفي الأصحاح ككل يشير إلى زمن المستقبل، وإنجيل يوحنا عامة ينظر إلى حلول الروح القدس على أنه بالتأكيد حدث مستقبلي. وهكذا يكون للزمن المستقبل مصداقية أفضل فيما يختص بسياق النص.8
أي اختلاف يلائم أسلوب المؤلف أكثر من الآخر؟ هنا يعني السؤال بما يفعله المؤلف عادة، وكيف يعبّر عن نفسه، وما هي دافعه واللغة التي يستخدمها عادة. فمثلاً، واحد من الأسباب التي لأجلها لا يعتبر معظم العلماء أن (مرقس 16: 9-20) جزء أصيل هو أن المفردات والنحو في هذه الآيات لا تشبه على الإطلاق ما يوجد في بقية إنجيل مرقس.
وعندما يضاف إلى هذه الملحوظة الاحتمال القوي بأن الكتّاب كانوا يرغبون في إنهاء إنجيل مرقس بأكثر من القول بأنهن “كن خائفات”، وبالإضافة إلى حقيقة أن أقدم وأفضل المخطوطات لا توجد بها تلك الآيات الاثنا عشر، يكون البرهان المربك هو أن (مرقس 16: 9-20) تمت إضافته فيما بعد.
بل أن الاعتبارات النصية يكون لها أهميتها حتى عندما يتضمن الاختلاف كلمة واحدة فقط. وهكذا، ففي (يوحنا 4: 1)، تختلف المخطوطات بين القراءة “1فَلَمَّا عَلِمَ يَسُوعَ أَنَّ الْفَرِّيسِيِّينَ سَمِعُوا أَنَّه يُصَيِّرُ وَيُعَمِّدُ تَلاَمِيذَ أَكْثَرَ مِنْ يُوحَنَّا”، وبين “فَلَمَّا عَلِمَ الرَّبُّ أَنَّ الْفَرِّيسِيِّينَ سَمِعُوا أَنَّ يَسُوعَ يُصَيِّرُ وَيُعَمِّدُ تَلاَمِيذَ أَكْثَرَ مِنْ يُوحَنَّا”….
ففي الحقيقة إن الكثير من المخطوطات الأقدم والأفضل كانت تقول “الرب” هنا بدلاً من “يسوع”. ومع ذلك، فإن رواية يوحنا تدعو يسوع “رباً” مرتين على الأقل قبل القيامة (6: 23؛ 11: 2). ومن ناحية أخرى، تستخدم كلمة “يسوع” عشرات المرات. وهكذا فإن الاعتبار النصي هنا هو في جانب كلمة “يسوع” بدلاً من “الرب”.
الملخص
عندما تتم مقارنة البرهان الخارجي بالبرهان الداخلي، يتوصل العلماء إلى نتيجة بشان أية قراءة نصية هي الأصلية, فيكون الاختلاف النصي الذي يقترب أكثر من الأصالة هو الذي يوجد في أقدم وأفضل وأكثر الشهادات المنتشرة جغرافياً. كما أنه يكون متفقاً مع السياق وأسلوب المؤلف، ويكون هو المنشئ الواضح للقراءات المنافسة له على المستوى الأدبي.
إن تسعة وتسعون بالمائة من كل المشاكل النصية يتم حلها بسهولة عن طريق مقارنة البراهين الخارجية والداخلية. بل إن حتى نسبة جيدة من الواحد في المائة المتبقية التي يكون لها معنى وتكون قابلة للتطبيق، يمكن حلها بقدر كبير من الثقة عن طريق المقارنة بعناية بين البراهين الخارجية والداخلية.
لكن هناك العديد من المناسبات التي يبدو فيها أن البرهان الخارجي يشير إلى طريق ما، بينما يشير البرهان الداخلي إلى طريق آخر. فكيف يمكن للعلماء أن يقرروا في مثل هذه الحالات؟ هذا هو نوع من الألغاز الذي يملأ المجلات اللاهوتية! في الفصل التالي سوف نصارع على وجه التحديد مع الأمور موضع الخطر في مثل هذه المواقف.
ولكننا هنا نحتاج أن نشدد على أمر واحد مهم: أنه إذا وجد اختلاف معين في المخطوطات غير اليونانية فقط، أو إذا وجد فقط في بعض المخطوطات القليلة الحديثة، حتى لو كانت مصداقيتها الداخلية ممتازة، فلابد من رفضه.
فإننا عندما نتعامل مع عدد من المخطوطات يصل إلى الآلاف، فإن الحوادث غير المتوقعة والدوافع غير المعروفة قد تكون هي الأسباب وراء قراءة نصية شاردة هنا أو هناك والتي يكون لها داخلياً مصداقية قوية. ومن ناحية أخرى، في أحيان نادرة يكون البرهان الخارجي إلى جانب إحدى القراءة بصورة شديدة القوة، ولكن يكون هناك عدد كبير بما يكفي من المخطوطات المهمة بجانب قراءة مختلفة، ويكون البرهان الداخلي إلى جانب القراءة الثانية بالكامل. في مثل هذه الحالات، تكون القراءة الثانية في الأغلب هي الأصلية.
ففي (فيلبي 1: 14)، تقول ترجمة فان دايك: “وَأَكْثَرُ الإِخْوَةِ، وَهُمْ وَاثِقُونَ فِي الرَّبِّ بِوُثُقِي، يَجْتَرِئُونَ أَكْثَرَ عَلَى التَّكَلُّمِ بِالْكَلِمَةِ بِلاَ خَوْفٍ”. لكن، ماهي تلك “الكلمة” التي يتكلمون بها بلا خوف؟ هذا النوع من الغموض ترك الكتّاب في مأزق، إذ يحتاج الأمر إلى نوع من التوضيح. وهنا نشأ اختلاف متوقع وهو إضافة كلمة “الله” أي “كلمة الله”.
كما جاءت في ترجمة الحياة. هذا الاختلاف المحدد موجود في بعض من أفضل وأقدم المخطوطات، وخاصة في المخطوطات من أسلوب النص الإسكندري. بعض مخطوطات النص الغربي تضيف “الرب”.
ليس من السهل أن نعرف لماذا سقطت كلمة “الله” أو “الرب” من النص. فلا يمكن تمييز سبب متعمد أو غير متعمد لذلك من جانب الكتّاب. هذا بالإضافة إلى حقيقة أن بولس كثيراً ما كان عنده بعض الغموض، يعني أن البرهان الداخلي -أي كل من احتمالات النسخ واحتمالات الأصالة -هما إلى جانب القراءة الأقصر والأصعب. داخلياً، يبدو من الواضح أن بولس كتب “التكلم بالكلمة بلا خوف”. وأن الكتّاب أضافوا كلمة تفسيرية لكي يجعلوا المعنى أكثر وضوحاً.
وبالاتجاه إلى البرهان الخارجي، فإن القراءة الأقصر تؤيدها معظم المخطوطات اللاحقة (تلك التي تنتمي إلى أسلوب النص البيزنطي). ولكنها مؤيدة أيضاً بأقدم شهادة للفيلبيين، 46 P (التي يرجع تاريخها إلى حوالي عام 200). بالإضافة لذلك، فإن هناك مخطوطات أخرى غير بيزنطية لها القراءة الأقصر (وأبرزها مخطوطات 1729، التي ناقشناها في الفصل السادس).
فبالرغم من أن البرهان الخارجي غير ملزم بالقراءة الأقصر، يمكن للمرء بسهولة أن يرى كيف أن القراءة الأصلية يمكن أن توجد في هذه المخطوطات بدون تأييد بقية الشهادات القديمة.
في هذه الحالة قامت معظم المخطوطات الجيدة بإضافة اختلاف متوقع، وهو اختلاف كان يمكن أن ينشأ في أماكن متعددة بصورة مستقلة عن المخطوطات الأخرى. على أن الأمر الجوهري الذي نحتاج أن نفهمه هو أنه إذا كان أحد العلماء يعتقد أن القراءة الأصلية موجودة في مخطوطات أدنى، فإنه يجب أن يكون لديه تفسير معقول لكيفية الانتهاء إلى أن هذه المخطوطات لها القراءة السليمة بينما لا تكون تلك القراءة السليمة لدى مخطوطات أخرى جيدة، فيكون عليه أن يفسر تاريخها.
وفي هذه الحالة، تكون حقيقة أن صياغة بولس مبهمة في كثير من الأحيان، وحقيقة إن كلاً من كلمتي “الله” و”الرب” هما اختلافان أضافتهما بعض المخطوطات، وحقيقة أن القراءة الأقصر لها على الأقل بعض التميز، وأن المخطوطات القديمة في جانبه، تكون أسساً كافية لرؤية نص “التكلم بالكلمة بلا خوف” على أنه هو القراءة الأصلية. إن البرهان الخارجي على القراءة الأقصر ليس قوياً، ولكنه مناسب، والبرهان الداخلي في صالحها كثير ووفير. وعندما يدمج هذان معاً فإنهما يشيران إلى أن “التكلم بالكلمة بلا خوف” هو بالفعل النص الذي كتبه بولس.
والآن لنفكر في مشكلة نصية أخرى، وهي التي بدأنا بها هذا الفصل، المشكلة النصية الموجودة في (لوقا 1: 34). ولنستمع مرة أخرى إلى ما كتبه روبرت برايس عن هذه الآية: توجد مخطوطة شاردة (مخطوطة لاتينية قيمة b) تحذف سؤال مريم في (لوقا 1: 34)، “كَيْفَ يَكُونُ هذَا وَأَنَا لَسْتُ أَعْرِفُ رَجُلاً؟”
لاحظ أنه بدون هذه الآية لا يوجد في إنجيل لوقا ما يوحي بوجود حبل أو ميلاد فوق طبيعي. إن له معنى كبيراً (أن نرى هذه الآية على أنه تم إضافتها بواسطة كتّاب لاحقين)، ولكن البرهان شديد الضعف بالنسبة لنا لكي نتمكن من إدراج هذا السؤال. 9
كان روبرت برايس أحد أعضاء جماعة “مدرسة يسوع”، وهو عالم في العهد الجديد. ولكن، هل يتعامل مع الدلائل والبراهين بعدل؟ دعونا نختبر برهانه في ضوء المبادئ القياسية للنقد النصي.
سوف نتعامل مع البرهان الداخلي أولاً. يحاول برايس أن يبرهن على قضيته أكثر عن طريق البرهان الداخلي: “فالآية 34 تجعل مريم تواجه الملاك باعتراض متشكك يماثل تماماً اعتراض زكريا (1: 18): «كَيْفَ أَعْلَمُ هذَا، لأَنِّي أَنَا شَيْخٌ وَامْرَأَتِي مُتَقَدِّمَةٌ فِي أَيَّامِهَا؟»، وعندها ضرب الملاك جبرائيل زكريا بالخرس حتى يوم ولادة الطفل يوحنا، كعقاب له لاجترائه على الشك في كلامه. فهل سهل على لوقا أن ينسب نفس التشكك إلى مريم. وإن كان كذلك، فهل كان سيتركها بدون عقاب من الملاك؟”10
يفترض برايس أن البرهان الداخلي هو كله في جانب حذف هذه الآية، وهذا على الأكثر لأن التشابه بين استجابتي مريم وزكريا للملاك أن كلاً منهما أدت إلى استجابة مختلفة من الملاك جبرائيل. لكن، هل كانت استجابتي زكريا ومريم “متماثلتين تماماً” كما يزعم برايس؟ إن زكريا يسأل: “كيف أعلم هذا؟” فهو بذلك يسأل عن علامة على أن الملاك يخبره بالحقيقة.
ولكن استجابة مريم هي: “كيف يكون هذا؟” وكما يعلّق داريل بوك: إنها لم تشك في الإعلان، لأنها لم تطلب علامة كما فعل زكريا. ولكنها كانت متحيرة بشأن كيفية حدوث هذا الميلاد، وهو سؤال جعل الملاك يوضّح لها الأمر (1: 35)”11. هكذا يكون البرهان الداخلي إلى جانب إدراج هذه الآية بقوة.
وليس ذلك فقط، ولكن السمة المميزة للوقا هي أنه يستخدم أمرين متماثلين لتطوير حجته. وفي هذه الحالة، فإنه يظهر باستجابة مريم المختلفة أنها أكثر براً من زكريا. كما أنه يظهر أيضاً بواسطة الروايتين المتماثلتين أن ميلاد يسوع هو أكثر معجزية من ميلاد يوحنا المعمدان.
بل وأكثر من ذلك، أنه لو كان حبلها قد تم بوسيلة طبيعية، فلماذا يقول لها الملاك: “اَلرُّوحُ الْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقُوَّةُ الْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ، فَلِذلِكَ أَيْضًا الْقُدُّوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ اللهِ.” (ع35)؟ كانت هذه هي استجابة الملاك لتساؤل مريم؛ ويكون من الغريب للغاية أن يجيب الملاك على سؤال لم يطرح. وهكذا فإن برهان الأصالة (أسلوب لوقا وأيضاً سياق النص) هو بالكامل إلى جانب إدراج الآية 34.
ربما يكون البرهان الخارجي أكثر قوة إلى جانب الحذف، وإن كان كذلك، فإنه لابد وأن يكون مجمعاً عليه تقريباً لكي يتغلب على مثل هذا الاعتراض القوي من جانب البرهان الداخلي. ولكن برايس يعترف بأن البرهان الخارجي ضعيف للغاية -وهو عبارة عن مخطوطة لاتينية واحدة! فأساساً لا يوجد برهان خارجي يؤيد زعمه.
فمخطوطة واحدة لاتينية من القرن الخامس لا يدخل فيها عامل التوزيع الجغرافي، ولا عامل اتصال النسب، بل فقط الحد الأدنى من مصداقية التاريخ والسمات. فبقية المخطوطات اللاتينية بها هذه الآية، كما توجد أيضاً بجميع المخطوطات اليونانية. بل إن آباء الكنيسة أيضاً قد علقوا على هذه الآية منذ الأزمنة القديمة.
إن برايس شديد السخاء في تقييمه للحذف عندما يعطيه مرتبة مساوية مع الإدراج. ولذلك فإن استنتاجه بأن: “البرهان أضعف مما يسمح لنا بإدراج هذا السؤال.”12 يبدو وكأننا نحتاج لأن نعلّق الحكم لأن البراهين شديدة التوازن والتعادل، رغم أن برهان الحذف شديد الضعف ولا يجعلنا نأخذ افتراض برايس على محمل الجد.
إن ما يلفت النظر هو أنه في موضع سابق في كتابه يقوم بالاستشهاد باسم إف سي بور على أنه نموذج للعالم الجيد في علوم الكتاب المقدس: لابد أن نضع في الاعتبار دائماً القول المأثور لفرديناند كريستيان بور، إن أي شيء ممكن، ولكننا يجب أن نسأل ما هو المحتمل. وهذا أمر مهم لأنه اتجاه شديد الانتشار بين دارسي الكتاب المقدس التقليديين، بل وحتى العلماء المتطورين، أن يقوموا بترجيح براهين للمواقف الحرجة، ثم يقوموا بعد ذلك بطرحها جانباً على أنها “غير مثبتة”.
ولكن الأحكام العلمية لا يمكن أن تكون مجرد مسألة “الرغبة في الإيمان”، بل إن مبدأ المؤرخ لا بد دائماً أن يكون هو الحكمة القائلة: “لتكن لديك الجرأة لأن تعرف.” 13
لكن يبدو أن برايس لم يتبع النصيحة التي قدمها هو نفسه في اتباع حكمة بور (الذي هو أيضاً لم يكن دائماً يتبع نصيحته هو الشخصية!)، وأكثر من ذلك، يمكننا أيضاً أن نعكس هذا قائلين: إن الأحكام العلمية لا يمكن أن تكون مجرد مسألة “الرغبة في عدم الإيمان”. فالدليل على عدم وجود (لوقا 1: 34) لهو من الضعف الشديد بحيث أنه لم يقبله أي عالم جاد من علماء العهد الجديد.
فكيف يمكن لمخطوطة وحيدة باللاتينية أن يكون لها الصياغة الصحيحة بينما الآلاف الأخرى من المخطوطات -التي الكثير منها أقدم بصورة ملحوظة ولديها مصداقية أكثر من تلك المخطوطة الواحدة – قد جعلتها تنزلق من شباكها؟ كما لم يقدم برايس أية وسيلة معقولة كان يمكن بها أن يحدث نقل للنص بحيث أن النص الصحيح قد فقد بصورة ما عبر أكثر من أربعمائة عام من النسخ، ولكن تم ضبطه بواسطة تلك المخطوطة الوحيدة.
فالمؤرخ الجيد يجب على الأقل أن يقدم تفسيراً معقولاً لمثل هذا الشذوذ المتفرد. كما يجب عليه أيضاً أن يقدم الدليل على أنه، في مكان آخر في النص، يمكن أن تحوي مخطوطة منسوخة -أو حتى مجموعة من المخطوطات المنسوخة – الصياغة الأصلية، حيث أنتجت جميع المخطوطات الأخرى هذا الخطأ.
إنه لجديد بالذكر أن “برايس” قد أدرج “بور” و”إيمانويل كانت” للدفاع عن نظرته المدمرة للنص. فقط طبّق بور وسيلة تعلمها من الفلسفة (الجدلية الهيجلية) على العهد الجديد. ورغم أن آراءه كانت كلها ثائرة في منتصف القرن التاسع عشر، فإنه قد ثبت بطلانها منذ ذلك الوقت بواسطة البرهان التاريخي. لقد كان “كانت” بالطبع فيلسوفاً، ولكن أن يضع برايس مصطلح “مؤرخ” مع “كانت” في نفس العبارة، فإن هذا يعطي انطباعاً بأن “كانت” كان مؤرخاً في الأساس.
ولكن الافتراضات الفلسفية والبراهين التاريخية لا تكون دائماً على وفاق، فقد كان يقال كثيراً، بخصوص الأفكار الجديدة في علوم الكتاب المقدس، إن “الألمان هو الذين ابتكروها، والإنجليز أصلحوها، والأمريكان أفسدوها”. وهكذا فقد سعى “برايس” لكي يجد أية فضلات من الأدلة لكي تؤيده. وهذه هي الوسيلة التي تسوقها النتائح التي يرغب المرء في العثور عليها.
ومع ذلك، إذا كان ممكناً على الإطلاق، فسيكون من المفيد ان نفسّر كيف أن تلك المخطوطة اللاتينية الوحيدة -المخطوطة اللاتينية القديمة b- أسقطت استجابة مريم في (لوقا 1: 34). إن أقرب تفسير هو أن الكاتب قد قام بخطأ يعرف باسم الكتابة المفردة -وهي كتابة مرة واحدة ما كان يجب أن يكتب مرتين. فكل من الآيتين في ع 34و38 يبدأ تماماً بنفس الطريقة: “فقالت مريم”. ففي اللاتينية، تكتب هذه الجملة: dixit auteu Maria وهكذا فإن عين الكاتب تخطت هذا العدد وكتب العدد 38 الذي يبدأ بنفس الكلمات: dixit auteu Maria.
وبعد أن كتب الرد من عدد 38، عادت عينه مرة أخرى إلى العدد 35. (إن أي إنسان قام بنسخ نصوص من قبل يعرف كم من السهل أن يحدث مثل هذا الخطأ). ثم عندما وصل إلى العدد 38، أدرك أنه قد كتب هذا النص بالفعل، ولذلك قام بحذف الإجابة بأكملها في هذا المكان فقراءة نص المخطوطة اللاتينية القديمة b في عدد 38 هي ببساطة: “فمضى من عندها الملاك.” هكذا تم حذف إجابة مريم في عدد 38 ووضعها في عدد 34.
لكن لو كان برايس على حق، لما كان المخطوطة اللاتينية الوحيدة قد تضمنت الصياغة الصحيحة في عدد 34 فقط، ولكنها كانت ستتضمن الصياغة الصحيحة في عدد 38، ولكانت جميع الشهادات الأخرى -اليونانية واللاتينية والقبطية والسريانية، وغيرها -قد تضمنت الصياغة الخاطئة في كلا الموضعين. إن احتمال أن يكون تقييم برايس للبيانات صحيحاً هو احتمال متناهي الصغر إلى أبعد الحدود.14
بمعنى آخر، إن الشهادات غير اليونانية تعتبر ثانوية في الأهمية، وحتى النسخ الكاملة (وليس مجرد مخطوطات منفصلة داخل النسخة) في حد ذاتها، لا تستطيع أن تشير إلى صياغة نص أصلي.
لذلك فإن أساس برايس شديد الهشاشة، ويبدو أن افتراضاته الفلسفية هي التي تسوق قراراته. فكيف يمكنه إذاً أن يقول: “البرهان أضعف مما يجعلنا نتمكن من إدراج هذا السؤال؟” فالبرهان، على العكس، قوي تماماً على أن إنجيل لوقا لم يحذف أبداً العدد 34. وكما يعشق ويليام لين القول: “إن أوقية من البراهين لأفضل من رطل من الافتراضات”.
لكننا، في هذه الحالة، لدينا رطلاً من البراهين مقابل أوقية من الافتراضات. فحتى العلماء الذين ينكرون الميلاد العذراوي، يعرفون أن النصوص التي تتحدث عنه ليست موضع شك. إنه مجرد قبض الريح أن يتبنى المرء بجدية إمكانية غير ذلك، كما أنه يكشف عن قناع المخطط الكامل لتدمي الإيمان المسيحي بواسطة التلاعب والتحايل على البيانات التاريخية.