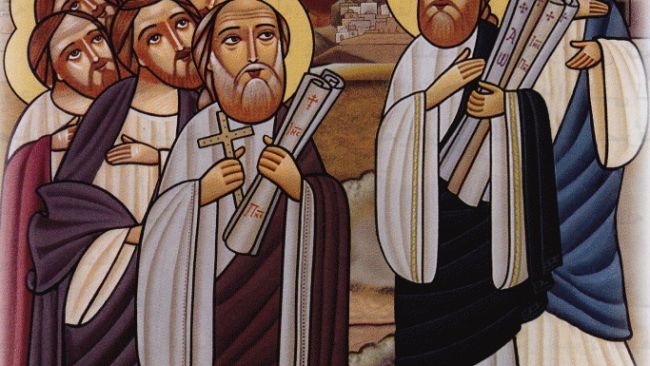معنى الألم – تأمل على خطى أيوب 2 – الأب نادر ميشيل
معنى الألم - تأمل على خطى أيوب 2 - الأب نادر ميشيل
معنى الألم – تأمل على خطى أيوب 2 – الأب نادر ميشيل

معنى الألم – تأمل على خطى أيوب 2 – الأب نادر ميشيل
إقرأ أيضاً:
-
معنى الألم – تأمل على خطى المزامير 1 – الأب نادر ميشيل
-
معنى الألم – تأمل على خطى يسوع 3 – الأب نادر ميشيل
2- سفر أيوب: لماذا الألم؟
بعد أن تناولنا ماهيّة الألم وآثاره في الإنسان والسؤال الذي يثيره حول معنى الحياة، يظلّ السؤال الذي يتردد دائماً: «لماذا الألم؟ وما السبب؟ ومَن المسئول؟».
بادئ ذي بدء، نقول إن هذه الأسئلة صحيحة لأنها تدلّ على أن السائل يعي أن الألم شر لابد من تجنّبه، وإذا وقع فلابد من اقتلاعه. لم نجد في قرائتنا السابقة للمزامير ولن نجد في الكتاب المقدس كله دفاعاً عن الألم ولا طلباً للألم ولا استمتاعاً بالألم.
لكن كيف يرد الكتاب المقدس على هذا السؤال: «لماذا الألم؟».
لن نجد إجابة واضحة، نهائية وشافية على هذا السؤال، ولكنّنا سنحاول تلمّس طريقنا في الإجابة عليه من خلال قراءة لاهوتيّة لسفر أيوب، وعند اللزوم سنتطرّق إلى أسفار أخرى من الكتاب المقدس أو نعرض بعض التفسيرات الفلسفية واللاهوتيّة الشائعة.
-
ما هو سفر أيوب؟
يصنَّف سفر أيوب في باب الكتب الحكميّة التي تعرض سرّ الإنسان والحياة والموت، وتخاطب الإنسان أياً كان، ناقلة من حكمة البشر ما يساعد كل مؤمن على فهم سر الحياة والحب والعمل والخلق والخلود. وأيوب هو أحد الحكماء الذي واجه مثل باقي البشر السؤال الذي يطرحه الألم والمرض والموت. ونحن لا نعرف لأيوب وطناً أو زمناً أو ديانة، غير أنه رجل مؤمن بالله. ويعود زمن كتابة السفر غالباً إلى ما بعد سبي الشعب العبراني إلى بابل(587-534 ق.م).
-
مَن هو أيوب؟
أيوب هو رجل صالح بمدحه الله: «إنه رجل كامل مستقيم يتقي الله ويجانب الشر، وإلى الآن متمسّك بكماله» (2/3). ويأتيه الشر من مصدر غريب عن الله وعن الإنسان. فنسمع الشيطان يشكّك في صدق إيمان أيوب ويشكوه لله. يبحث سفر أيوب أولاً وأخيراً في أساس العلاقة بين الله والإنسان، والسؤال هو التالي: هل يطيع الإنسان الله بسبب الخيرات التي ينعم بها؟ وبالنسبة إلى الشيطان، إذا نُزعت هذه الخيرات، ارتدّ الإنسان عن الله وأبطل علاقته به.
- مصائب أيوب:
بفقد أيوب صحته وبنيه وممتلكاته كلها، فيبقى مؤمناً بالله ولم يجدف أبداً عليه: «وقال: عرياناً خرجت من بطن أمي وعرياناً أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ، تبارك اسم الرب. في هذا كله لم يخطأ أيوب، ولا عتب على الله». (1/21-22). يؤمن أيوب بالله ويعترف بقدرة الله على كل شيء. ولكن هذا الاعتراف الإيمانيّ المبدئيّ لا يجاوب على التساؤلات التي يطرحها الألم: لماذا؟ لماذا؟ من أين يأتي؟ ومَن السبب؟. بل أكثر من ذلك، إنه لا يعيد السلام والنور إلى علاقة أيوب بالله، تلك التي اهتزّت تحت وطأة الألم، وجعلت أيوب يتساءل مَن هو الله الذي يرى الشقاء الذي حلّ به واحد تلو الآخر من دون أن يرحمه، وهل هو الله الذي أرسله ولماذا، وما موقف الله من الإنسان المتألم. ولذا ظلّ أيوب يعبّر بكل صدق وإصرار عن ألمه وعن صراعه لفهم معنى ما حدث له.
ويأتي أصدقاء أيوب لتبرير ما يحدث له: إذا فقدت خيراتك فلابد أنك خاطئ، لأن الله يكافئ الصالحين ويعاقب الأشرار. يدخل موقف أصدقاء أيوب في إطار نظرية لاهوتيّة شائعة في أذهاننا حول المجازاة الزمنيّة، فالأشرار يعاقبون والصالحون يكافأون. لنسمعهم يقولون لأيوب: «أذكر هل هلك أحدْ وهو بريء وأين دمرّ أهل الاستقامة؟ بل هل رأيت أن الذين يحرثون الإثم ويزرعون المشقة هم يحصدونها… أيكون الإنسان باراً أمام الله أم الرجل طاهراً أمام صانعه؟» (4/7-8، 17).
وفي نظر أصدقاء أيوب، وعلى رأسهم أليفاز، لا يمكن إنكار هذه النظرية، وعلى أيوب أن يتوب: «وأنت إن بكّرت إلى الله وطلبت رحمة القدير وكنت نقياً ومستقيماً، ففي الحال يغار عليك ويلبّي صدق نواياك» (5/8). وبكل ثقة يدعون أيوب إلى الاعتراف بفهمهم للحقيقة: «هذا ما فحصناه وهو الحق فاسمعه وانتفع به» (5/27). وحتى النهاية سيظل أصدقاء أيوب مصمّمين على رأيهم، يردّدونه بلا هوادة ويدافعون عنه. وليس موقف أصدقاء أيوب غريباً عنّا، فنحن نطرحه على أنفسنا عندما نتعرّض لمكروه: يا ترى ماذا فعلت لأستحقّ هذا؟ ما خطأي كي أتألم كما أتألم الآن؟
-
تبريرات الألم؟
ونسمع تبريرات كثيرة للمصائب والآلام. ولكن كلّما كانت نهائية وواثقة من نفسها، فهي في أغلب الأوقات خاطئة، وفي كل الأحوال لا تساعد المتألم على اكتشاف معنى لحياته بالرغم من الألم. وقبل أن ندخل مع أيوب في طريقه نحو الله من خلال الألم الذي حطّ به، نعرض سريعاً بعض التبريرات التي كثيراً ما نسمعها، وللأسف كثيراً ما نردّدها على مسامع من يتألمون.
بعض اللاهوتيين والفلاسفة يقولون إن الشر هو ظل الخير، ويفقد طبيعته كَشرّ إذا وُضع في الإطار العام للتطوّر. فالألم هو أزمة نمو، والحروب هي ولادة للتاريخ. ولكن هذا التبرير الغريب يزيد المتألم ألماً ويولّد في قلبه الغضب والثورة على كل شيء، على الناس وعلى الله. فيقول المتألم: «لماذا أتحمّل أنا ثمن هذا التطور؟ لماذا هكذا أتألم؟ أيّ نمو وأيّ حياة أجني من آلامي المدمرة؟». وكما سنرى مع أيوب، فالله لا يريد الشر ولا الألم، فالله لا يحطّم ولا يدمر ولا يتواطأ مع أيّ قوة تنال من الإنسان، من حياته وسعادته.
يقول بعضهم إن الألم عقاب عن شر اقترفه الإنسان، فماذا نقول عن آلام الأبرياء: أيوب، يوسف، يسوع، الأطفال المرضى، المسجونون بسبب آرائهم. أيّ شر فعل هؤلاء؟ وأيّ خطأ اقترفوه؟ وفي رأي بعضهم الآخر، ينتج الألم والشر من الاستعمال السيّئ لحرية الإنسان، ولكن ماذا نقول عن التفجيرات البركانية والأعاصير المدمرّة والأمراض الوراثية. ويقول بعضهم الآخر إن الأمراض والشيخوخة والكوارث الطبيعية ما هي إلا نواقص في الطبيعة وتعبير عن قدر محتّم، ولكن معرفة السبب وشرحها لا يلغي ثقل الألم وتأثيره في الإنسان.
ويحاول بعضهم التخفيف عن ألم الناس، فيقولون في أحاديثهم الروحيّة للمتألم: «إن كنت تتألم فذلك علامة عن حب الله أنه يجرّب مَن يحبّ». «يا ليته يحبّني حبّاً أقلّ قليلاً، فالألم يعصرني عصراً»، يجاوبهم الإنسان المتألم. ويزيد بعضهم فيقول للمتألم: «افرح لأن آلامك تخلّص العالم». والسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: كيف يتحول ألم بلا معنى إلى قوة خصبة للحياة؟ كيف يتحول مصدر اليأس في حياة إنسان إلى رجاء للآخرين؟ كيف يصير ما هو غير آدمي في حياة شخص إلى قوة تحرير للآخرين؟ كيف يقبل الله تقدمة ما يشوّه الإنسان ويحوّله إلى دودة حقيرة؟ كيف يفرح حين ينظر إلى الإنسان في هذه الحال؟
يبقى كل شرح لأسباب الألم ناقصاً وغير صحيح، قد يقول شيئاً نافعاً لكنه يهدم على الجانب الآخر أشياء كثيرة. يحاول الإجابة عن سؤال ويطرح عدّة أسئلة أخرى أخطر: مَن هو الله، وما هي إرادته على الإنسان، أيّ صورة عن الله نقدّم للناس، وماذا نقول للإنسان المتألم؟
مصير كل محاولة لشرح الأسباب بطريقة نهائية وشاملة هو الفشل. فهي تسعى إلى التبرير، ولكنها لا تساعد الإنسان المتألم على مواجهة ألمه وعلى توجيه حياته، بل تزيده ألماً على ألم.
وهذا ما حدث لأيوب عندما لم يدخل في نظرية أصدقائه، فطلب منهم الصمت رحمة له: «مَن لي بأن تسكتوا فيكون لكم في ذلك حكمة. اسمعوا حججي وأصغوا إلى دعاوى شفتَيَّ، ألإرضاء الله تتكلمون بالظلم أم لأجله تنطقون بالخداع؟» (13/5-7). وأكثر من ذلك، فالإنصات إلى المتألم يصبح بمثابة تعزية لهم: «اسمعوا قولي سماعاً ولتكن لي منكم هذه التعزية، اصبروا عليّ فأتكلم وبعد كلامي تسخرون» (21/3). وذلك يُفهمنا كم قد تكون أحاديثنا للأشخاص المتألمين كالسكاكين التي تغمد في جروحهم، وكم يصبح استماعنا إليهم تعزية لنا.
-
طريق أيوب نحو الله والآخرين عبر الآلام:
تكمن عظمة أيوب في دفاعه عن نفسه وفي بحثه الدؤوب عن تفسير لما يحدث له، وفي إلحاحه على الله كي يكلمه ويرشده. ويُظهر سفر أيوب مسيرة المعاناة والآلام التي مرّ بها أيوب، كما يبيّن لنا طريق الخلاص الذي اتّخذه كي يصل في النهاية إلى السلام والطمأنينة في معاينة الرب.
-
صرخة الحياة:
أول طريق الخلاص صرخة، وصرخة قوية مدوية، هي صرخة كل إنسان متألم: «بعد ذلك فتح أيوب فمه ولعن يومه وتكلم أيوب وقال: لا كان نهار وُلدت فيه ولا ليل قال: قد حُبل برجل» (3/3). أمام الآلام يصبح الكون والحياة بلا معنى، بل أكثر من ذلك، يفضي الألم بالإنسان إلى تفضيل الموت على الحياة لأنه قوة موت وتحطيم للإنسان. الآلام هي عبث ولا معنى. ليتني لم أولد، يعلن أيوب، ويقول: «فلا طمأنينة لي ولا قرار ولا راحة وقد داهمني الاضطراب» (3/26). وأمام الألم، ردّد إرميا أيضاً الكلمات نفسها: «ملعون اليوم الذي وُلدت فيه، اليوم الذي ولدتني فيه أمي لا يكون مباركاً» (إر 20/14).
أول طريق الخلاص هو صرخة الألم التي ترفض الألم وتدين التدمير والتحطيم اللذين يُدخلهما إلى الحياة. أول طريق الخلاص هو التعبير عن مدى التحطيم والتشويه اللذين يسبّبهما الألم في الإنسان. وهذه الصرخة موجّهة نحو الله كتساؤل حار، كحيرة مريرة، كاستفهام قوي ومُلحّ: لماذا؟ لماذا؟ فهي إذاً تحمل في طياتها، بالرغم من ثورتها وتمردها ورفضها، رجاءاً وطلباً للخلاص. هي صيحة رجاء، لأنها تعدّت صمت الموت الذي يحمله الألم، وهي طلب للخلاص لأنها تؤمن بالحياة بالرغم من الموت الذي يجلبه الألم.
-
لا استسلام للألم:
ثانياً، يرفض أيوب وجهة نظر أصحابه الذين يرون في شقائه عقاباً من الله ويستمرّ في رفض نظريتهم بكل قوة وحتى النهاية. ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني أن أيوب يرفض تبريراً لألمه لا يعيد إلى حياته التوازن المفقود، بل، وهذا هو الأهم، يرفض أيوب الاستسلام لتبرير للألم لا يعطي معنى لحياته، ولا يعطي نوراً لعلاقته بالله وبالآخرين. في نظر أيوب، لا تساعده تبريرات أصدقائه على القيام من سقطته، ولا على السير في طريق الحياة ولا على استعادة التوازن المفقود في علاقته بالله وبالآخرين. على العكس، هي تكرّس العبث واللا معنى اللذين نزلا به، وتزيده ألماً على ألم وحسرة فوق حسرة. تبريرات أصدقاء أيوب اللاهوتية هي عبارة عن لمات جوفاء.
ويرى أيوب في تبريرات أصدقائه محاولة منهم للتهرّب من الأسئلة الحقيقية التي يطرحها الألم على حياة الإنسان. هم يحاولون تبرير أوجاع أيوب ليسكنوا من خوفهم أمام الألم وتهديده المستتر لهم، لأنه في حال ظهور خطأ نظريتهم، يصبح الألم بلا مفهوم، كقوة غامضة قادرة على ضرب أيّ إنسان بلا تمييز وبلا سبب. وقد يكون هذا موقفنا أمام الألم والإنسان المتألم، نريد تبريراً سريعاً لما يحدث له، نريد أن نعطيه إجابة شافية، نريد أن لا نبقى بجانبه طويلاً، لأننا كلنا خائفون ومرعبون من شبح الألم. نريد كتم صرخة المتألم لأنه يُفزعنا، نريد إبعاد المتألم عن أعيننا لأنه يرعبنا. ألم نقرأ في الإنجيل (مر 10/46-52) كيف طلب الناس من أعمى أريحا، برطيماوس، الكفّ عن الصراخ «رحماك، يا ابن داود؟». فيسوع لا يخاف من مواجهة الإنسان المتألم ولكنه يحترم حرّيته وإرادته حتى يخلّصه من ألمه.
يعترف أيوب بأنه خاطئ ولكنه يسأل الله عن سبب عدم مغفرته له، ولما تتبعه خطيئته: «إذا خطئت فماذا فعلت لك يا رقيب البشر؟ ولِمَ جعلتني هدفاً لك حتى صرت عبئاً عليك؟ ولِمَ لا تتحمّل معصيتي ولا تنقل عنّي إثمي؟» (7/20-21أ). «فإنك تكتب عليّ أموراً مريرة وتُلحق بي آثام صباي» (13/26). أمام أصدقائه، يعترف أيوب بأنه إنسان خاطئ لكنه في الوقت نفسه لا يجد في حياته وتاريخه سبباً يستوجب هذه الآلام المريرة والمحطمة: «أروني الصواب فأسكت، فهمّوني في أيّ شيء ضللت. كلام الحق ما أحلى وقعه. أما لومكم لي فلا حق فيه.
أتحسبون كلامي يستحق اللوم، وهو كلام يائس يذهب في الريح؟ تلقون على اليتيم قرعة وتبيعون صديقكم بالرخص. فتطّفوا الآن والتفتوا إليّ، فإنّي بريء ثابت» (6/24-29). وأكثر من ذلك، يتفهم أيوب موقف أصدقائه، ويقول إنه بوسعه لو كان مكانهم أن يردّد الأقوال نفسها: «يا ما سمعت مثل هذا الكلام، وكم تتعبني تعزيتكم. أما للكلام الفارغ نهاية؟ وماذا يحرّضني حتى أجاوب؟ لو كنتم مكاني لتكلمت كلامكم ونمقته وهززت عليكم رأسي، أو لشجعتكم بكلمات فمي إلى أن تكلّ من الحراك شفتاي. والآن إذا تكلمت لا تزول كآبتي، أو تمنّعت فلا تذهب عنّي» (16/2-6).
وقد حسن كلام أيوب في عيني الرب، وعاتب الله أصدقاء أيوب عتاباً مريراً، رافضاً كلام أليفاز وزميليه الذين بنظريتهم اللاهوتية حول المجازاة الزمنية ظلموا في الوقت نفسه الله وعبده أيوب، وشوّهوا الله والإنسان: «إن غضبي قد اضطرم عليك وكلام صاحبَيك لأنكم لم تتكلموا عليّ بحسب الحق كعبدي أيوب. فخذوا الآن لكم سبعة ثيران وسبعة كباش واذهبوا إلى أيوب واصعدوا مُحرقة عنكم، وعبدي أيوب يصلي من أجلكم فإنّي أرفع وجهه ولا أعاملكم بحسب حماقتكم لأنكم لم تتكلموا عليّ بحسب الحق كعبدي أيوب» (42/7-8).
-
الانفتاح على آلام الآخرين:
ثالثاً، يحوّل أيوب شيئاً فشيئاً تساؤله عن ألمه الشخصي إلى تساؤل عن آلم الآخرين. يبدأ في الخروج من قوقعة آلامه عندما ينتبه إلى أحزان الآخرين. يتساءل عن معنى العدالة أمام مشهد الأشرار الذين يظلمون والأبرار الذين لا يجدون مكافأتهم، ويضيف كيف تتفق نظرية أصدقائه مع هذه الحقيقة المريرة. تحوّل رفض أيوب لألمه وللتبريرات الأشدّ إيلاماً إلى دفاع عن المظلومين وعن المتألّمين مثله. يطرح أيوب أسئلة خطيرة على نفسه وعلينا: «فإنّي كلما تذكرت ارتعت وأخذ جسمي الارتعاش. لماذا يحيا الأشرار ويشيخون ويعظم اقتدارهم؟ ذرّيّتهم قائمة أمامهم على أيامهم وخلفهم لدى أعينهم» (21/6-8).
«لماذا لا يدخر القدير أزمنة وعارفوه لا يشهدون أيامه؟، فإن من الناس مَن ينقلون الحدود ويسلبون القطعان ويرعونها. يسوقون حمار الأيتام ويرتهنون ثور الأرملة. يُبعدون المعوزين عن الطريق فيختبئ مساكين الأرض جميعاً» (24/1-4).
ومن أعماق تساؤلاته، يكتشف أيوب أن الله يقف إلى جانب الفقير والمسكين والمظلوم وأنه يهتم بهم، ويكتشف أنه بالتأكيد يهتم به هو أيضاً. ويمثل هذا التطور أو التحول الداخلي بداية النور الذي سيصل بأيوب إلى معاينة الله، عبر الألم والتجرّد والمعاناة.
يعلن أيوب إيمانه بحضور الله المحيي في حياته، رافضاً التواطؤ مع أيّ سوء، وشاكراً على نعمة الضمير المرتاح في الرب: «حيّ الله الذي يرفض حقّي والقدير الذي مرّر نفسي. ما دامت نفسي فيَّ وروح الله في أنفي لن تنطق بالسوء شفتاي ولا يتمتم لسني بالبهتان. حاشى لي أن أبرّركم. إلى أن تفيض روحي لا أقلع عن كمالي. تمسّكت ببرّي فلا أُرخيه لأن ضميري لا يخجل على يوم من أيامي» (27/2-6).
وبالرغم من الألم الذي يُغشّيه ويحوّل شكله إلى حيوان لا إنسان، يقاوم أيوب الانغلاق على الذات لينفتح على طلب العدالة للجميع انطلاقاً من أبوّة الله للكل: «إن كنت استهنت بحق عبدي أو أمّتي في دعواهما عليّ، فماذا أصنع حين يقوم الله وكيف أجيبه حين يحقّق؟ أوليس الذي صنعني في البطن هو صنعهما وواحد كوّننا في الرحم» (31/13-15). وتكتمل العدالة برفض عبوديّة المال: «هل جعلت في الذهب ثقتي….إنها جريمة ترفع إلى القضاء لأنّي أكون قد كفرت بالله العليّ» (31/24أ، 28).
ويظهر على طريق أيوب رجل حكيم، أليهو، ليعلن له أن الله يتكلم بطرق مختلفة لا نعلمها، وهو القادر على استعمال كل الوسائل، حتى الألم، كي يتعرّف الإنسان إليه وكي ينمو في طريق إنسانيّته: «فإن الله أبر من الإنسان. فما بالك تخاصمه؟ ألأنّه لا يجيب عن جميع أعماله؟ إن الله يتكلم بطريقة ثمّ بأخرى ولا نشعر بذلك… حينئذ يفتح آذان الناس ويختم على إنذارهم ليصرف الإنسان عن عمله ويمحو الكبرياء عن الرجل» (33/12ب-14، 16-17). ويواصل أليهو حديثه مؤكداً على أن الله يأخذ جانب المتألمين والمنسحقين، هو معهم، يسمع صراخهم ويستجيب لهم: «حتى رُفع إليه صراخ المساكين» (34/28).
-
طريق النور:
فَهِم أيوب أن مواجهة آلامه تمرّ بانفتاحه على آلام الآخرين وفي مساعدتهم من دون انتظار حلّ لمشاكله، سار طريق أيوب نحو الله عبر انتباهه الفعّال والجاد تجاه إخوته المتألمين وفي السعي الصادق لمعاونتهم. ومن هنا يظهر لنا سر رفض أيوب للتفسيرات السريعة للألم وللتبريرات المتعجّلة له، فقد كانت تعني له الاستسلام للشر والظلم، وهذا يخالف إيمانه بالله الذي يحرّر ويخلّص. ومن هنا أيضاً نفهم مسيرة أيوب نحو الله، فقد مرت بالحوار الغاضب وبالرجاء الواثق، ولكنها مشت بالتأكيد غي طريق رفع المعاناة عن المساكين ومقاومة الألم.
وفي مسيرته الروحية، تدرّج أيوب في مواجهته مع الله، فنسمعه أولاً يطلب حَكَماً بينهما: «لو كان بيننا حَكَم يجعل يده على كِلَينا، لرفع عنّي عصاه ولما روّعني رعبه» (9/33-34)، ثم يتبيّن أن الله يشهد له أمام أصدقائه: «لي منذ الآن شاهد في السماء ومحامٍ عنّي في الأعالي. إن الساخرين منّي هم أصدقائي، ولكن إلى الله تفيض عيناي» (16/19-20). وأخيراً يصل أيوب إلى الرجاء المطمئن في محرّر فادٍ: «أعرف أن شفيعي حيّ وسأقوم آجلاً من التراب فتلبس هذه الأعضاء جلدي وبجسدي أعاين الله» (19/25-26).
تجربة الموت التي مرّ بها أيوب أوصلته بعد طريق مرير إلى التعرّف إلى الله كمصدر للحياة، وإلى اكتشاف الله الذي ينقذه من الموت وينقذ العالم من الظلم. ويكتشف أيوب أن إرادة الله هي إرادة حياة تفوق كل قوى الموت. وهذه هي الكلمة الأخيرة والأكيدة عن حياة العالم وحياة أيوب: الله مع الإنسان في كل حال ليخلقه ويعطيه الحياة بالرغم من كل شيء، من وسط الألم ومن وسط الموت. الله أقوى من الألم، الله أكبر من الموت.
وأمام الله، ظلّ أيوب واثقاً بمحبة الله وبعدله وبرحمته، فلم يتوار ولم يبتعد، بل بقي أميناً في صلاته وتضرعاته إلى الرب: «وأعرض قضيّتي أمامه وأملأ فمي حججاً وأعرف كلمات إجابته وأتفهّم ما يقول لي؟ أبعظمة جبروته يحاكمني أم عليه أن يصغي إليّ؟ فيرى أنّي خصم مستقيم وأن دعواي هي الرابحة» (23/4-7).
وفي رد الله على أيوب (38-40)، نفهم أن نظ’رة الله إلى الإنسان تنبع من حب مجاني خلاّق، وهذا هو الأساس الذي يمكّن من التقاء الله بحرّية. لقاء الإنسان لله ولقاء الله للإنسان، هو لقاء بين حرّيتين، ومبدأه أن الله أحبّ أولاً حباً عظيماً مجانياً. تقف قدرة الله الفائقة عاجزة أمام حرية الإنسان وترفض الرضوخ المستسلم من جانب الإنسان والذي يُخفي وراءه التذمّر وعدم الرضا. يطلب الله من الإنسان أن يساهم معه في بناء عالم عادل انطلاقاً من الثقة والإيمان بأن قوى العبث هي تحت سيطرته: «أنظر إلى بهيموت الذي صنعته مثلك: إنه يأكل العشب قبل الثور» (40/15).
الألم الذي ينحر أيوب لن يقوده إلى الفناء، وهذا هو رجاؤه في وسط المحنة. يكتشف أيوب نفسه محمولاً ومأخوذاً داخل نظرة حب شاملة ومجانية. يكتشف أيوب محبة الله المجانية التي تضفي معنى على العدالة، فيدخل في فهم جديد لحياته ولمعناها ولحياة العالم من حوله. محبة الله المجانية له ولكل إنسان تدعوه للعمل من أجل العدالة في العالم ومن أجل تخفيف المعاناة عن كل المتألمين جسدياً ومعنوياً وروحياً. وهنا يجد أيوب السلام والنور لحياته: «كنت قد سمعتك سمع الأذن، أمّا الآن فعيني قد رأتك، فلذلك أرجع عن كلامي» (42/5-6أ).
محبة الله سر عميق وكبير لا تحوطه نظريات ولا تقيّده تفسيرات. وكل تبرير للألم بجرح حب الله للإنسان وينال من أبوّته الفيّاضة للبشر. محلة الله تدعو إلى الحرية والمجانية. هي نور يضيء الطريق الذي ينفتح أمام الإنسان المتألم ويدعوه إلى التقدم واثقاً في النصر على قوى الألم والظلم والقهر. محبة الله كبيرة، لا يحدّها فكر أو لاهوت، لأن المحبة تحب بدون سبب، وبدون استحقاق، وبلا حدود.
لقاء أيوب لله هو لقاء محلة حرّ ومجاني. كفى أيوب أن الله حاضر في حياته، يقف بجانبه في غضبه على الألم وفي رفضه للألم، وكفى أيوب أن الله معه، يدافع عنه أمام الظلم الذي وقع عليه وعلى الآخرين.
«لماذا الألم» لم يجاوب سفر أيوب، بل أكثر من ذلك رفض التفسيرات الزمنية الشائعة المبررة للألم. لكنه أظهر أن الحب المجاني هو أساس العلاقة بين الله والإنسان. الألم سر في حياة الإنسان والعالم، والسؤال «لماذا الألم» تلقائي وبديهي على لسان كل إنسان وخاصةً الإنسان المتألم. وهو سؤال سويّ وصحيح لأنه يعني أن الإنسان يفهم أن الألم شر لا معنى له، وأن الألم غريب على حياته ومشوّه لها، وأنه يجب والتخلّص منه. لكن الألم لن يقهر فقط بالإجابة على هذا السؤال، بل أساساً بمواجهته من طرفنا بكل الوسائل المتاحة، وبرفضنا لكل تبرير له، وبمساهمتنا في تحرير المتألمين والمظلومين. ونحن في ذلك كله واثقون بأن محبة الله أقوى من كل ألم وظلم وعنف، ومؤمنون بحضوره معنا، هو من يعطي الغلبة النهائية على كل قوى تدمير للإنسان وللعالم.
-
شفاء القلب:
تحوّل أيوب من معاتبة الله إلى تسبيح الله بعد طريق طويل من التعبير الصادق والمرير عن ألمه وعن عدم فهمه لما يحدث له. وشيئاً فشيئاً اكتشف أن الله يقف بجانب المتألمين والمظلومين، وأن أساس حياته هو محبة الله المجانية والمتجددة له. يصل أيوب إلى التسبيح والتمجيد قبل أن ترجع إليه صحته وأملاكه، لأنه اكتشف طريق الحياة في قلبه أمام الله. ليست الصحة والأملاك سبب فرحه وتمجيده لله، بل الثقة بأن الله يهب له الحياة ويمنحه الغلبة على الألم والظلم، ويدعوه إلى تحقيق العدل والكرامة لكل إنسان.
تحوّل أيوب عبر طريق الآلام إلى إنسان حر لأنه اكتشف قيمة حياته في محلة الله له، لا في المال ولا في الصحة ولا في القوة. كل ما سبق هو جميل ورائع وجدير البحث والدفاع عنه، ولكنه وُجد من أجل الإنسان ولم يُخلق الإنسان له. هي وسائل بين يدي الإنسان من أجل حياته وفرحه وهنائه، ولكنها ليست هدفاً في حدّ ذاتها. حياة الإنسان وفرحه وهناؤه هي في محبة الله له وفي تجاوبه مع هذه المحبة، وتظهر محبة الإنسان لله وتنمو وتتعمّق من خلال علاقة الإنسان بما يملك ويمتلك. وإذا أتى الألم على المال والصحة والقوة، قد يكتشف الإنسان عبر طريق الآلام أن محبة الله حاضرة في حياته، وتساعده على النهوض والقيام والتصدّي للظلم والألم على كافّة أشكاله وأنواعه. في محبة الله، يكتشف الإنسان قيمة حياته ومعناها، يجد القوة والرجاء لمقاومة الظلم والألم. في محبة الله، يصبح الإنسان حراً.
«طوبى للذين بك عزّتهم، ففي قلوبهم مَراقٍ إليك» (مز 83/6).
التحوّل الحقيقي هو تحوّل القلب الذي يرى ويفهم، والشفاء الحقيقي هو في القلب الذي يبرأ من تمردّه وعزلته ووحدته، ويصل إلى تجديد إيمانه بالله الخالق والمحب محبة مجانية فيّاضة. وعندئذ تتحوّل لعنة الألم إلى موقف واقعي، صادق وفعّال، ضد الألم في حياة الشخص نفسه وبالأخص في حياة الآخرين، لتخفيف الآلام ورفع المعاناة عن كل مظلوم ومسكين.
سفر أيوب هو نشيد يمجّد العلاقة بين الإنسان والله التي هي أساسها المحبة الحقيقية المجانية أكبر وأقوى من كل ألم وكل ظلم.