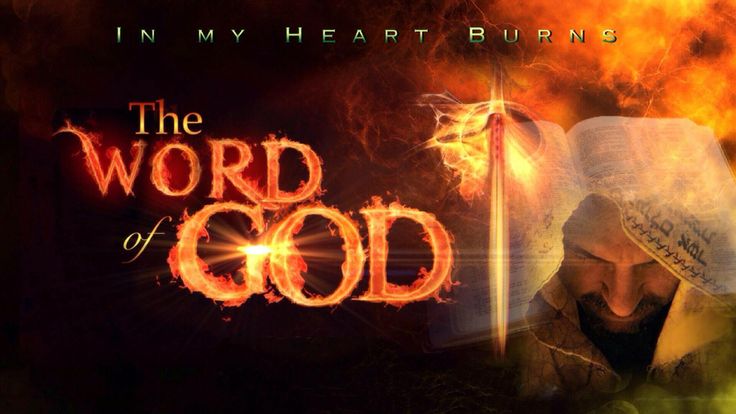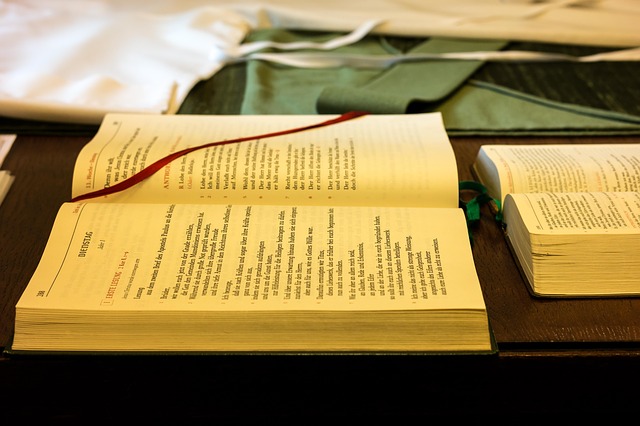العلم – رؤية لاهوتية وآبائية – دكتور جورج عوض
العلم – رؤية لاهوتية وآبائية – دكتور جورج عوض

العلم – رؤية لاهوتية وآبائية – دكتور جورج عوض
مقدمة
إن المتأمل لمسيرة العلم يجد أن النظريات العلمية تؤثر على رؤية البشر نحو الله والكون والإنسان، وبقدر ما يقترب الإنسان إلى الحقائق العلمية الأصيلة بقدر ما ينظر نظرة حقيقية نحو الله والكون والإنسان، هذه النظرة تتمشى مع التعاليم المسيحية والآبائية. لذا فإن مسيرة البحث العلمى هى في نفس الوقت مسيرة نضوج البشرية، وأن الاكتشافات العلمية هى بمثابة إعلان إلهى طبيعى يشهد للإله الخالق:
” لأن أموره غير المنظورة تُرى منذ خلق العالم مُدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته..” (رو18:1ـ20).
إن الخليقة تمثل بالحقيقة مرآة تعكس العظمة الإلهية، والتي تشهد لألوهية وأزلية الله، لذا عند القديس باسيليوس الكبير فالخليقة هى “معلم ومربى للمعرفة الإلهية”[1]. وهكذا وسم الله الخالق كل الخلائق بختم روحه، فكم هى عظيمة أعمالك يارب بحكمة صُنعت (أنظر مز24:103).
إذن البحث العلمى الأصيل يشهد على عظمة أعمال الله، ولا نجد ما يُسمى بالصراع بين العلم والإيمان. إن عالِم الفيزياء، مثلاً، الذي يراقب أو يكتشف بنية المادة والمعادلات التي لم تكن معروفة من قبل، وكذلك الفنى الذي يطبق هذه الاكتشافات لأهداف عملية تفيد البشرية، يعملان عملاً يعكس إمكانيات الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله.
إن العالم مخلوق بطريقة تجعله في حاجة إلى من يضفى معنى على المخلوقات، فالعالم من نفسه لا يستطيع أن يكون كاملاً ولكنه في حالة تجعله يحتاج للتكميل. لذلك فإن تشجيع البهيئات العلمية لتحقيق إنجازات علمية وتكنولوجية في كافة المجالات من استكشاف أسرار الكون إلى اختراق الأمراض المستعصية التي تُعجل بقتل الملايين، هو في الأساس تشجيع لأن يمارس الإنسان الإمكانيات والقدرات التي أودعها الله فيه منذ الخلق.
إن هذا البحث يستعرض مسيرة علم الفيزياء ـ في الغرب ـ منذ العصور الوسطى إلى اليوم وتأثير هذه المسيرة على التعاليم المسيحية في هذه الفترة. وكيف أن مفاهيم كثيرة أُعيد النظر إليها من خلال الرؤية الصحيحة للعلم والإيمان. وأيضًا سوف نرى حقيقة الصراع الذي حدث في العصور الوسطى بين الكنيسة والعلماء، كذلك سوف نرى كيف أن الفيزياء الحديثة باكتشافاتها قد صاغت رؤية ناضجة للبشرية تجاه الله والكون والإنسان، وهى ذات الرؤية التي تبناها ـ منذ البداية ـ اللاهوت الشرقى الآبائى في كنيستنا.
الفيزياء الكلاسيكية ولاهوت العصور الوسطي في الغرب
لقد نظرت الفيزياء الكلاسيكية إلى العالم نظرة نيوتينية ميكانيكية لها جذورها في فلسفة الذريين الإغريق[2] الذين قالوا أن المادة مصنوعة في أساسها من كتل بناء عديدة هي الذرات، تتصف بقدرة كامنة ساكنة في جوهرها أما حركتها فهي تقوم علي محرك خارجي ذو منشأ روحي يختلف اختلافًا أساسيًا عن المادة. ومن هنا نشأت الثنائية في التفكير الغربي، ثنائية الروح والمادة، العقل والجسد. وقد وجدت هذه الثنائية صيغتها الواضحة في فلسفة “ديكارت” والذي أسس نظريته علي التقسيم الجوهري للروح والمادة، للأنا والعالم .
اُعتبر العالم المادي مكون من كثرة أو تعدد من موضوعات مختلفة، وتجمعت في آلة ضخمه ولقد دعم ” نيوتن ” هذه النظرية الموجهة إلى العالم وأشاد بالنظرة الميكانيكية هذه وجعلها قاعدة تقوم عليها الفيزياء الكلاسيكية .
علي الجانب الأخر، كان اللاهوت الغربي في العصور الوسطي يتبني ثنائية: [الطبيعي و”فوق الطبيعي”] حيث كانت تسيطر هذه الثنائية آنذاك على الآراء اللاهوتية، فالعلم ينتمي إلى دائرة “الطبيعي” و”الأرضي” و”العالمي” و”الدنيوي”، أما الإيمان فينتمي إلى دائرة “فوق الطبيعي”، و”السماوي”، و”الكامل”، و”السامي”، وهكذا تولد صراع بين السماوي والأرضي نتيجة لهذه الثنائية الغربية (الطبيعي ـ فوق الطبيعي).
لقد أقامت هذه الثنائية العداوة بين ما هو “فوق” وبين ما هو “تحت”، ولذا انفصلت الحياة عن الإيمان، وانزلق الإنسان المسيحي الغربي إلى التشتت. ومن المعروف أن هذا الاعتقاد قد تبناه، من قبل، الاتجاه التصوفى القديم المعروف باسم “الغنوسية” إذ كانت ترى أن الله متعالٍ جدًا ولا يمكن أن يصنع شركة مع الكون ولا سيما المخلوقات المادية، وهكذا افترضت الغنوسية وجود “هوة” ساحقة لا يمكن عبورها بين الله والكون[3].
إن الصراع الذي حدث بين الإيمان والعلم في العصور الوسطي[4] في القرنين السابع عشر والتاسع عشر يبرهن ويؤكد علي خطورة الثنائية الغربية، لقد حدث تصادم في مجال علم الطبيعة في القرن السابع عشر وأيضا في مجال علم البيولوجي في القرن التاسع عشر. التصادم الأول تم بين الكنيسة الكاثوليكية والعالِم المعروف “جاليليو” (1564ـ1642م) في فرنسا، والثاني كان بين الكنيسة البروتستانتية والعالِم المشهور “داروين” (1809ـ1882م) في إنجلترا .
كانت نتيجة التصادم الأول إدانة “جاليليو” سنة 1633م لأنه نادي بأن الشمس هي مركز الكون. إذ كان هناك نظامين معروفين هما “مركزية الشمس” و”مركزية الأرض”. النظام الأول نادي بمركزية الشمس والأرض تتحرك حولها، فالأرض ما هى إلاّ جسم سماوي متحرك. أما النظام الثاني فكان يتبني “مركزية الأرض” أي أن الأرض هي مركز الكون والشمس هي التي تتحرك حولها .
كان من الشائع في الكنيسة الكاثوليكية قبل “جاليليو” الرأى القائل بـ “مركزية الأرض”، وكان هذا الرأى يستند إلى فلسفة أرسطو. بينما أكد “جاليليو” وبواسطة التليسكوب أن الأرض هي التي تتحرك والشمس هي مركز الكون. وقد أعتمد على النظرية الرياضية لـ”كوبرنيكوس” (1473م ـ1543م) وكتابه حول الأجرام السماوية (1543م) وأيضًا علي العالم “كيبلر” (1571م ـ1630م).
ومركزية الأرض، الرأى الذي تبنته الكنيسة الكاثوليكية، كان مجرد فرضية عند الأقدمين، وعلى الرغم من ذلك نجد أنها قد دافعت عنها بشدة، اذ ظنت أنها مديونة بالدفاع ليس فقط عن معتقداتها الدينية بل أيضًا عن كل مواقفها وآرائها، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى القهر والتهديد بالموت حرقًا.
وفي الحقيقة، كان الصراع بين الإيمان والعلم في الغرب الأوروبي ـ في القرن السابع عشر ـ هو صراع أيديولوجي وليس له علاقة بالإيمان، فالصراع كان بين السلطة الدينية (الفوقية) وبين السلطة المدنية (التحتية) أى بين ” السماوي” و” الأرضي ” .
أما التصادم الثاني كان مع “داروين” في القرن التاسع عشر في المجال البيولوجي، إذ كان صراعًا حول أصل الحياة: وبمعنى آخر هل الوجود هو خليقة الله أم نتيجة تطور طبيعي؟ ومرة أخري نجد أن الصراع يدور بين الله (الفوقاني) وعلم التطور (التحتاني) .
فوفق نظرية التطور لداروين، تكون الحياة قد مرت بمراحل تطور من البساطة إلى الأنواع المركبة، من الناقصة إلى الكاملة، من الأضعف إلى الأقوى وقد عبّر “داروين” عن نظريته هذه في كتابين: “أصل الأنواع” (1859م) و”أصل الإنسان” (1871م).
فالحياة عند “داروين” لا تتأثر بعنصر آخر خارجها، فهي تُنظم في غياب الله. إن الحياة نتاج الانتخاب الطبيعى بين الكائنات، أى بقدر تكيُّف كل كائن مع البيئة الطبيعية، وبقدر تكيُّفه هذا يبقى في الحياة ويتطور، ونتيجة لنظرية “داروين” هذه، فإن الحياة هى صراع للتعايش والبقاء فيها للأقوى. لهذا نجد أن النظرية الداروينية كانت تضاد نظرية الخلق من وجهة النظر اللاهوتية للعالم. كما ظهر أن التطور البيولوجي يضاد علم اللاهوت المسيحي .
لقد نُقل الشجار بين الإيمان والعلم من كيفية خلق العالم ” الكوزمولوجيا ” إلى شجار بين الإيمان والعلم عن أصل الحياة “البيولوجيا”. ومرة أخري نقول أن الصراع ليس حقيقيًا لأن الخلق من وجهة النظر اللاهوتية والتطور لا يلغى أحدهما الأخر بل يتكاملان، وهذا ما سوف تظهره الفيزياء الحديثة، إذ أن الخليقة تحتوي في ذاتها علي مفهوم التطور، وبالطبع فإن التطور يستلزم فرضية الخلق.
وأيضًا فوفق اللاهوت الكتابي فإن الخلق من العدم لا يلغى التطور، وهذا يمكن أن يُفهم من التعبير الكتابى ” حسن جدًا” كما جاء في سفر التكوين (تك1). لقد نشأ هذا الصراع في البيئة الغربية (من القرن17ـ إلى القرن 19) حيث انتشرت ثنائية “فوق الطبيعي” ـ “الطبيعي”، ونادت بالهوة بين الخالق “الفوقاني” والعالم “التحتاني”.
لقد نُظر إلى الكون نظرة نيوتينية، إذ كان الكون يُعتبر مكان مطلق، وعاء فارغ مستقل عن الظواهر الفيزيقية التي تقع ضمنه وأصبح الزمان مطلق، مستقل عن العالم المادي، ولا يحمل تاريخ يسري من الماضي إلى المستقبل .
ولقد استطاع نيوتن أن يصف حركة المادة بقوانين ثابتة غير قابلة للتغيير. فالطبيعة ـ بحسب رأيه ـ تخضع لحتمية صارمة، فالكون الذي هو آلة جبارة يخضع بكامله للسببية والحتمية، فكل شئ يحدث، يخضع لعلة أو سبب. وكان من نتيجة هذه النظرية بزوغ فكر فلسفى (ديكارت) يفصل حتميًا بين “الأنا” و”العالم”، فلقد نادى “ديكارت” بأنه يمكن وصف العالم علي نحو موضوعي، أي أنه لا يوجد تأثير ولا علاقة بين المراقب أو الملاحظ الإنساني(الذات)، و”الموضوع” الذي يصفه. وعليه فلابد للإنسان أن يكتشف فقط هذه القوانين الجامدة المحددة والأساسية للحركة ويسلم بها.
وهكذا، فالله، حسب النظرة النيوتينية، قد خلق ـ في البدء ـ الأجسام المادية والقوة المنظمة بينها، وأيضًا القوانين الأساسية للحركة. وبهذه الطريقة، أنطلق الكون كله في حركته منذ ذلك البدء، مثل آلة تتحكم بها القوانين الثابتة التي لا تقبل التبديل. وهكذا عُزل الإنسان عن الشيء الذي يلاحظه، وساد الوصف الموضوعي للطبيعة علي علم الفيزياء واُعتبر مثالاً يحتذي في كل فرع من فروع العلم. والواقع أن هذه النظرة النيوتينية لها صدى في الواقع اليومى للإنسان، فحالة الركود وعدم التغيير والاستسلام للواقع تستمد جذورها من هذه النظرة.
الفيزياء الحديثة واللاهوت الآبائى الأصيل
لقد تطور علم الفيزياء، في القرن العشرين، وأحدث ثورات في المفاهيم والتصورات أدت إلى كشف واضح لقصور وجهة النظر الميكانيكية، وأحلت محلها نظرة عضوية وإيكولوجية للعالم تتماثل تماثلاً كبيرًا مع تعاليم اللاهوت الكتابي عن الخلق في كنيستنا الشرقية. فقد تبني الشرق معادلة “غير المخلوق” ـ و”المخلوق” أي “الله” و”المخلوقات”، وأن هناك علاقة “اعتمادية” من جانب يعتمد فيها المخلوق علي الخالق ” كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان” (يو3:1)، والقديس كيرلس عمود الدين في شرحه لإنجيل يوحنا الإصحاح4:1، يوضح هذه العلاقة بين الخالق والمخلوق قائلاً:
[ أن تستنير شئ وأن تنير شئ آخر، فهو عطاء وأخذ، الابن ينير والخليقة تستنير، إذن فالابن والخليقة ليسا واحدًا، فالواحد يعطى والآخر يأخذ][5].
هذا وبالرغم من تشديد القديس كيرلس على التمييز بين الخالق والخليقة، إلاّ أنه يُقر بعلاقة (الأخذ ـ العطاء) فالخليقة تأخذ والخالق يعطى. وهكذا فبدون هذه العلاقة والشركة بين الله والمخلوق، لا تكون هناك حياة للمخلوق لأن مصدر حياته هو الخالق، لذلك يؤكد القديس كيرلس هذا الإيمان بقوله: [ لأن يد الله تمسك بكل شئ، بجميع المخلوقات في الخليقة كلها، وتعطى حياة لمن يحتاج إلى الحياة، وتزرع النور الروحى في الكائنات القادرة على أن تتقبل الفهم.
وهو ليس محصورًا في مكان ولا يتحرك من مكان إلى آخر، لأن الحركة من صفات الأجساد وإنما هو يملأ كل الأشياء ][6]. إن التعليم عن العلاقة بين الخالق والمخلوق قد اتضحت وتأكدت بالتجسد، لأن تجسد الله الكلمة قد قرّب تمامًا المسافة بين الخالق والمخلوق إلى مستوي الشركة والاتحاد، لذا لا يوجد ما يسمي بالصراع التصادمي أو المضطرد بين الخالق والمخلوق، وعندما يشرح القديس كيرلس كلمات المسيح ” جئت نورًا إلى العالم” (يو46:2)، وكلمات المرنم “ أرسل نورك وحقك “(مز3:43) ـ ردًا على الهراطقة الذين اعترضوا على هذه الآيات بقولهم: كيف يقول عن نفسه إنه سيأتى إلى العالم؟
هل معنى ذلك إنه لم يكن في العالم وأن المرنم أيضًا يترجى مجيء من هو ليس حاضرًا؟ـ يقول القديس كيرلس: [إن الإنجيلى الإلهى يصف الابن الوحيد بكل الصفات الخاصة بالله ولا سيما أنه حاضر بدون انقطاع في العالم لأنه بالطبيعة هو الحياة وهو نور بجوهره ويملأ الخليقة كإله غير محصور في مكان، ولا يُقاس بمقاييس ولا يُدرك بالكم ولا يحيط به شئ. ولا يتحرك من مكان إلى آخر، ولكنه يسكن في الكل ولا يفارق أحدًا، ومع كل هذا يُقال إنه أتى إلى العالم رغم حضوره الدائم فيه.
وهذا المجيء إلى العالم هو التجسد لأنه أعلن نفسه للذين على الأرض وتحدث مع البشر (باروخ37:3) عندما تجسد، وجعل حضوره في العالم ظاهرًا للكل. والذي كان في الماضى معروفًا لفكر الإنسان صار مرئيًا بعيون الجسد أيضًا ولا سيما عندما صار ظاهرًا بالعجائب والقوات ويترجى المرنم مجيء النور والحق لكى ينير الكلمة العالم عندما يأتى متجسدًا ][7].
علي الجانب الأخر، فإن الفيزياء الحديثة، لا ترى الكون كآلة تتألف من عدد وافر من الأشياء المنفصلة، بل إنه كُلٌ متجانس، متناغم، متصل غير منقسم، فالكون كله عبارة عن شبكة أو بنية من العلاقات الديناميكية. وهذا مايؤكده بولس الرسول في رسالته إلى كولوسي ” فإن فيه (في المسيح) خلق الكل مافي السموات وما علي الأرض مايري ومالايري سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين. الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل ” (كو1: 16ـ17).
ويعبر القديس كيرلس بوضوح كيف أن “الكلمة” هو الذي يعطى الاستنارة لكل المخلوقات، وكل المخلوقات تخلُّص بنوال ما ليس لها، ويعلل ذلك مشددًا على أن الابن الوحيد هو وحده النور الحقيقى والمخلوقات تحتاج إلى النور لأنها من طبيعة مختلفة عنه:
[… فالابن ينير الخليقة كخالق لأنه النور الحقيقى، وعندما تشترك الخليقة في نور الابن تشرق بنوره وتصبح في هذه الحالة نورًا، لأنها بتعطف الابن ترتفع إلى فوق، لأنه مَجّد الخليقة وكللها بأكاليل متنوعة من الكرامة، لكى يأتى إليه كل من نال كرامة ويرفع صلوات الشكر بصوت عالٍ: ” باركى يا نفسى الرب ولا تنسى كل حساناته، الذي يغفر جميع ذنوبك ويشفى كل أمراضك ويفتدى من الهلاك حياتك ويكللك بالمحبة المترفقة والرحمة الحانية ويملأ فمك بالخيرات” (مز2:103ـ5)][8].
أن سر تماسك كل شيء هو اللوغوس “الكلمة”، اذ فيه يقوم الكل، وهذا يعني أن كل شيء في الكون مرتبط ببعض وأن هناك علاقات متداخله بين الاشياء. وهذا ماكشفته النظرية الكوانتيه اذ نادت بأن “الاحتمال” هو السمة الأساسية للحقيقة الجوهرية، اذ يستحيل فهم الجزئيات إلاّ بعلاقتها المتداخله، فالجزئيات ليست ” أشياء” جامدة بل هي علاقات متداخلة بين الاشياء وليست هذة” الاشياء” الا علاقات متداخلة بين أشياء أخري وهلم جرا .
لذلك فإن النظرية الكوانتيه تنادي بوجود وحدة أساسية للكون، فكلما توغلنا إلى أعماق المادة، وجدنا أن الطبيعة لا تكشف لنا عن أنها كتل بناء أساسية معزولة، بل هي شبكة من العلاقات بين الأجزاء المتنوعة العديدة الكل فيها متحد .
إن الفيزياء الحديثة تعتقد اعتقادا راسخا في أن هذا النسيج الكوني من العلائق يشتمل علي الملاحظ البشري ووعيه بطريقة أساسية، ففي النظرية الكوانتية نستطيع فهم ” الموضوعات ـ الأشياء” ضمن حدود التفاعل المتداخل بين الملاحظ والشيء الموضوع تحت الملاحظة خلال عمليات متنوعة للملاحظة والقياس، وتقع نهاية هذه السلسلة من العمليات دائما في وعي الملاحظ البشري. فان قرار الإنسان الواعي لكيفية الملاحظة ـ لنقل ملاحظة إلكترون ـ يحدد خصائص الإلكترون إلى حد ما. فإن الإلكترون لا يتصف بخصائص موضوعية بمعزل عن عقل المراقب أو الملاحظ البشري[9].
وهكذا بَطُلَ الفصل الحاد في الفيزياء بين الأنا والعالم بحسب ديكارت، وأيضًا بين العقل والمادة. وأصبح لا يمكننا أن نتحدث عن الطبيعة دون التحدث في آن واحد عن أنفسنا.
أيضًا أحدثت النظرية النسبية لأينشتاين ثورة في تصورنا للزمان والمكان، لقد نفت هذه النظرية أن للمكان ثلاثة أبعاد، وأكدت علي أن الزمان ليس له وجودًا مستقلاً أو منفصلاً، فكلاهما أى الزمان والمكان مرتبطان برباط لا ينفصل. فـ [الفيزياء الحديثة، لم تعد الكتلة مرتبطة بجوهر مادي وبالتالي لا تشاهد الجزئيات وهي تحتوي ” قوامًا” أساسيًا، بل تشاهد بأنها حزم طاقة، فطبيعة الجزيئات ديناميكية في أساسها ولا يفهم هذا إلا في بنية يلتحم فيها الزمان والمكان في متصل رباعي البعد.
في هذه البنية، يبطل تصورنا للجزئيات بأنها أشياء سكونية ثلاثية البعد مثل كرات البلياردو بل هي ديناميكية لها كيان مكاني ” كتلة ” ولها بعد زماني في عمليات وظيفية تستغرق الطاقة المتكافئة. لذا لا يمكن أن نفصل كيان المادة عن فاعليتها. عندما تراقب الجزئيات لا نشاهدها علي أنها جوهر مادي بل أنماطًا ديناميكية تتبدل الواحدة منها علي نحو متواصل إلى الأخرى، إنها الطاقة][10]. وهكذا تنظر الفيزياء الحديثة إلى الطبيعة علي أنها تتكون من عناصر أساسية أو مكونات منسجمة مع بعض، في نسيج علاقات متداخلة[11] .
التأثيرات التي أحدثتها الفيزياء الحديثة والتي تتوافق مع اللاهوت الآبائى [12]
1 ـ تحولت النظرة إلى العالم من الميكانيكية إلى الأيكولوجية
بحسب الفيزياء الكلاسيكية، نُظر إلى العالم علي أنه آلة، والإنسان أصبح ماكينة، والله هو المهندس الأعظم الذي خلق العالم وتركه يسير وفق قوانين ونواميس الحركة. أما الفيزياء الحديثة فهي تنظر إلى العالم نظرة إيكولوجية فالعالم هو إيكوسOikos بيت للإنسان، والكون ليس ساكنًا، وجامدًا ذو طبيعة ميتة، بل منظومة عضوية حية تتطور وتؤثر وتتأثر.
لم يعد الله ـ في نظر الآباء ـ هو ساعاتي العالم، أي صنع العالم مثل ساعة وتركها تعمل من ذاتها، بل مفهوم الله الخالق كما شدد عليه الآباء دائمًا مبنى على قول المسيح لليهود ” أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل” (يو17:5)، فما زال الله يخلق ومازال يرافقنا ويضع فينا حب الإبداع والخلق لكي نستخدم إمكانيات خلقنا علي ” صورته ومثاله” أي تحقيق كل القدرات والإمكانيات التي أودعها الله فينا، فعلينا كما يؤكد الأب فرنسوا فاريون: [ أن نتمسك بطرفي السلسلة من جهة بأن الله هو الذي يخلق، ومن جهة أخري بأن ما يخلقه هو قدرة الإنسان علي خلق نفسه ][13].
2 ـ التحول من النظرة الثنائية إلى الحوارية
تأسست الفيزياء الكلاسيكية للقرن السابع عشر علي الثنائية الديكارتية، إذ أصبح الواقع يتكون من ثنائية متصارعة ومتضادة (الروح والمادة، النفس والجسد، الذات والموضوع، المكان والزمان…،) .
أما الفيزياء الحديثة فهى تنظر إلى العالم علي أنه منظومة عضوية ديناميكية، فالكهرومغناطيسية قد وحّدت الكهرباء كطاقة مع المادة المغناطيسية في وحدة واحدة، أيضا الديناميكا الحرارية قد أوجدت أشكال وقدرات مختلفة في مجال واحد. النظرية الكوانتية قد أقرت بالعلاقة الحية والديناميكية بين الذات (المراقب الإنساني) و”الموضوع”، وأيضًا النظرية النسبية قد وحدت المادة مع الطاقة، والمكان مع الزمان ولم يعد الزمان مطلق ومستقل ومنفصل عن المكان بل هو نهر متدفق يحمل تاريخ، أي حامل التغيرات من الماضي نحو المستقبل.
إن الفيزياء الحديثة، ببساطة، قد أوجدت علاقة حوارية كيانية، وبناء علي ذلك فالكون هو وحدة ديناميكية حوارية لكائنات متنوعة. وقد سبق لبولس الرسول أن أعلن هذه الحقيقة وطبقها على الإنسان حين قال: ” فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خِدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، … لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد كذلك المسيح أيضًا… فإن الجسد أيضًا ليس عضوًا واحدًا بل أعضاء كثيرة.
إن قالت الرِجل لأني لست يدًا لست من الجسد أفلم تكن لذلك من الجسد. وإن قالت الأذن لأني لست عينًا لست من الجسد أفلم تكن لذلك من الجسد… وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادًا، فوضع الله أناسًا في الكنيسة أولاً رسلاً ثانيًا أنبياء ثالثًا معلمين ثم قوات وبعد ذلك مواهب شفاء أعوانا تدابير وأنواع السنة. ألعل الجميع رسل ألعل الجميع أنبياء ألعل الجميع معلمون العل الجميع أصحاب قوات، ألعل للجميع مواهب شفاء ألعل الجميع يتكلمون بألسنة ألعل الجميع يترجمون “(1كو4:12ـ30).
لقد قصد الرسول أن يشرح لأهل كورنثوس بأن العمل الروحى وبالأحرى أى عمل لابد أن يكون تحت مظلة نظام، فلا مكان للموهبة الفردية في حد ذاتها إلاّ إذا خضعت لنظامٍ ينسقها مع بقية المواهب. وإن كان يحلو للبعض أن يتحدث عن العبقرية الفردية ومدى تأثيرها في تقدم البشرية، إلاّ أنها اليوم تراجعت وحلت محلها مناهج البحث المتطورة واستقرار طرائق التفكير العلمى. والدليل على ذلك هو التفوق اليابانى الذي لم يكن نتيجة بزوغ عبقرية طاغية ولكن نتيجة التنظيم والمحاكاة اللذين قامت عليهما الأسطورة اليابانية الحديثة والتي صنعت من أمة فقيرة الموارد دولة ذات تأثير قوى في العالم المعاصر.
لذا يستكمل الرسول بولس كلامه بعد هذا العرض العظيم لسيمفونية المواهب قائلاً: ” ولكن جِدوا للمواهب الحسنى وأيضًا أريكم طريقًا أفضل” (1كو31:12)، وابتدأ يتحدث إليهم عن الفضيلة التي توّحد البشر مع تنوع مواهبهم، إنها المحبة التي ” المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدًا“(1كو4:13ـ8).
هكذا فالمحبة هى الوقود اللازم لدفع المجتمع البشرى نحو التقدم والرقى والحياة الفُضلى، عكس الحقد والكراهية والبغضة التي هى عوامل التخلف والدمار لأى مجتمع. ولابد أن نشير إلى أن الوحدة والتناغم والمحبة بين الأشخاص لا تلغى التميز والعبقرية فهى باقية ولكن تصبح دائمًا جزء من نظام، فلا مجال لها للتسلط والتعالى والتباهى والافتخار.
3 ـ التحول من المعرفة الامتلاكية إلى التشاركية
المعرفة لدي الفيزياء الكلاسيكية، هي معرفة امتلاكية “أعرف يعني أمتلك” أي ما أعرفه امتلكه دون أن يكون هناك تفاعل أو حوار بين الذات (المراقب البشرى) والموضوع (مادة البحث). أما الفيزياء الحديثة فهي تنادي بأن المعرفة هي معرفة تشاركية (أعرف يعني أشارك)، فنحن لسنا مشاهدين بل مشاركين أو فاعلين فالمعرفة العلمية أصبحت عمل تشاركي، شركة وعلاقة متبادلة بين العلماء بعضهم لبعض. لم تعد المعرفة العلمية هي امتلاكية فردية بل جماعية تشاركية.
وما أحوجنا اليوم إلى التنسيق والتعاون فيما بيننا وذلك على مستوى الأشخاص والهيئات والمؤسسات. لقد روى أحد الكُتّاب المعروفين حديث باحثة أمريكية قامت بزيارة مكتبات الجامعة عندنا في مصر، وقالت له:
[ لقد وجدت مكتبات الكليات الجامعية كلها تشكو من نقص الاعتمادات المالية، ونقص الكتب والمراجع الحديثة، وعدم الاشتراك في المجلات والدوريات العالمية ليتابع الأساتذة وطلبة الدكتوراه والماجستير الأبحاث العلمية الجديدة في مجالات تخصصهم، ولكنها حين طافت بعدد من المكتبات (يقول الكاتب) اُكتشف أن معظم المراجع والدوريات التي يشكو من عدم وجودها أساتذة كلية موجودة في كلية أخرى في نفس الجامعة، أو في جامعة أخرى، ولكن ليس هناك وسيلة لتبادل المعلومات أو الاستفادة المشتركة والتعاون في هذا المجال.
وقالت: إن الطالب أو الأستاذ في أى كلية أمريكية يستطيع أن يطلب كتابًا من أى مكتبة في أى كلية أخرى في أى ولاية بالأنترنت فيصل إليه الكتاب على سبيل الإعارة لمدة أسبوعين يمكن مدها أسبوعين آخرين، ثم يُترك الكتاب في مكتبة كليته فيرجع تلقائيًا إلى مكتبة الكلية التي أرسلته، وهكذا فكل كتاب وكل مرجع ليس ملكًا لقسم أو كلية، ولكنه ملكًا لكل طلبة الولايات المتحدة، فالمشكلة ليست الفقر ولكن انعدام التنسيق ][14].
4 ـ التحول من الانحصار في الحاضر إلى الامتداد الأخروي
لقد نظر الغرب الأوروبي، في القرن السابع عشر، إلى العالم من خلال العلاقة الدفاعية والصراعية بين الأيمان والعلم، لذا العالم هو “كوزموس kÒsmoj” وهي كلمة يونانية تأتي من كلمة “كوزميما kÒsmhma” وهي تعني حلية أو زينة جامدة لا يحدث فيها أى تغيير. أما الفيزياء الحديثة، فأنها نظرت للعالم، بنفس النظرة الآبائية فهو ليس “كوزموس” ولكن “خليقة” أي عالم يعتمد علي الخالق، يستمد حياته من الخالق، وهو في حالة ديناميكية وليس في حالة جمود وسكون. فالكون هو عضو حي وليس جامد، هو يسير نحو قصده النهائي والأخروى، مثلما قال بولس الرسول ” لأن الخليقة نفسها أيضًا ستُعتق من عبودية الفاسد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معًا إلى الآن ” (رو21:8ـ22).
لذا اللاهوت الآبائي الاصيل لايتكلم عن “الكوزمولوجيا kosmolg…a” بل علي “علم الخليقة”، التي هى في حالة مسيرة ديناميكية لأن ” الكل به وله قد خُلِقَ” (كو16:1)، فالمسيح ليس هو فقط وسيط الخلق ” كل شئ به كان وبغيره لم يكن شئ مما كان” (يو3:1)، ولكن هو هدف كل الخليقة ” وله قد خُلِقَ الكل“. وبناء على ذلك فإن الإنسان يرافق ويصاحب مسيرة الخليقة أثناء مسيرته الشخصية لكى يصلا معًا إلى ملء المسيح، هدف كل الخليقة. هذه المصاحبة ليست فقط روحية بل أيضًا علمية باكتشاف بنية المخلوقات وصيانة الخليقة والارتقاء بها عن طريق الدراسة والبحث، إنها مسئولية الإنسان تجاه الخليقة باستثمار كل الإمكانيات التي أودعها الله في الإنسان.
5 ـ التحول من العزلة الفردية إلى الشركة الشخصية (من الفرد إلى الشخص)
لقد أعطت الفيزياء الكلاسيكية أولوية للفردية، فقد تبنت الاعتقاد بأن الطبيعة تتكون من ذرات، كيانات فردية منعزلة ليس لها علاقة ببعض وغير مبالين بالوسط المحيط .
أما الفيزياء الحديثة فقد تبنت الأفضلية الكيانية المتصلة ذات العلاقات المشتركة. فالطبيعة تتكون من ذرات، ولكن هذه الذرات متعلقة ببعض ولها صلة بالوسط المحيط. الإنسان يشارك دون أن يمتلك. لكن الفردية تؤدي إلى عدم الشركة والانفصال والانعزال. أما المراقب البشري، كما نادت الفيزياء الحديثة، فله دور تفاعلي مع موضوع بحثه. فالإنسان كشخص يصنع شركة وعلاقة بينه وبين الأشياء والأشخاص الآخرين. وكما نجد في اللاهوت الآبائي: من يصنع علاقة فهذا يخلص فالشخص يعني شركة وعلاقة، وعلى العكس من ذلك نجد أن فالفرد يعني العزلة والاستقلال والاكتفاء، وهذا يقوده إلى الهلاك أما الشخص فيخلُّص[15].
إن الوجود الحقيقى هو في الشركة ولا وجود بلا شركة لذا يقول الأسقف يوحنا زيزولاس: [ وإذا كان الوجود شركة فإننا لا نفهم الوجود بل لا نستطيع أن نفهمه إلاّ من خلال علاقة وبالتالى لا يمكننا أن نفهم الوجود كوجود في حد ذاته لأن كل كائن لا يوجد في حالة عزلة ولا يحيا كفرد. ولا يوجد كائن قائم بذاته يمكن فهمه كما هو في ذاته وهذا ما أنكره الآباء على أرسطو، فهو يطلب فهم الوجود وكيان كل الموجودات كما هى (فى حد ذاتها) وليس كما هى في علاقة وشركة مع غيرها. وشكرًا لله الكائن في شركة مع ذاته ومع الخليقة] [16].
إننا في احتياج إلى ممارسة الشركة فيما بيننا، ليس فقط على المستوى الروحى ولكن أيضًا في حياتنا اليومية مع الآخرين، فمثلاً على مستوى العمل نجد أنفسنا من الصعب أن نعمل عملاً جماعيًا ونميل دائمًا إلى الفردية. والعمل كفريق واحد هو أحد المظاهر البارزة لما يُوصف علميًا بـ”منظومة العلم والتكنولوجيا”. لقد سأل كاتب مصرى معروف صديقه اليابانى البروفيسور يوزو إيتاجاكى الخبير في الشئون العربية: [ لماذا وُفقتم أنتم وأخفقنا نحن؟.. فلقد كنا ـ في عصر ثورة الميجى لديكم، وعصر الخديجوى إسماعيل لدينا ـ متساويين تقريبًا في درجة التقدم.. وأين أنتم الآن؟ وأين نحن ؟]
قال إيتاجاكى : [ العالِم المصرى عندما يعمل منفردًا يساوى خمسة علماء يابانيين .. وهذا واضح من نبوغ علمائكم في الخارج، ولكن عندما يعمل اليابانيون كفريق فإن خمسة يابانيين يساوون خمسة أضعافهم من الخبراء المصريين]. ويعلق الكاتب قائلاً: [وهكذا أراد أن يقول الصديق اليابانى إن اليابانيين بفضل القدرة على العمل كفريق، قادرون على جعل “الكل” يتجاوز حاصل جمع الأجزاء المكونة له، بينما يتعرض المصريون عندما يعملون كفريق لخطر أن يلغى بعضهم أثر عمل البعض الآخر، وينتهى الأمر إلى محصلة هى أقرب إلى الصفر!!][17]. إن الكلام واضح جدًا، أننا نفتقد إلى العمل الجماعى المؤسس على التنسيق والتعاون والعمل كفريق واحد.
6 ـ التحول من الحتمية (الإجبارية) إلى الحرية (إمكانية الفعل)
تشير الفيزياء الكلاسيكية إلى أن الطبيعة محرومة من الحرية، إذ تخضع لناموس صارم دون أن يوجد هامش للاحتمال أو حتي للحظ. أما الفيزياء الحديثة فهي تتبني الامكانية الحرة بدلاً من الإجبارية. فالمعرفة تتميز بالاحتمالية (الإمكانية) وهذا يعني أن الكون يوصف بالديناميكية وليس بالسكونية .
فالعالم ليس آلة ولكن عضو يتطور ديناميكيًا تطورًا عضويًا تصاعديًا. لم يعد مكان للسببية المحددة التي كانت تسيطر علي الفيزياء الكلاسيكية والتي كانت تؤمن بأن وراء كل نتيجة سبب واحد فقط فقد حلت محلها الاحتمالية التي نادت بها النظرية الكوانتيه.
يتوافق هذا مع لاهوت الحرية وليس الاعتقاد بالجبرية والقدرية. الحرية لا تعني العصيان بل الاستقلال والنضوج. الجبرية والحتمية ينتج عنهما قوانين جامدة. أما الحرية فهي تتطلب ذات تتجه بحرية وعن اختبار ووعي نحو الحق ” الذي رأيناه وسمعناه ولمسناه” (1يو1:1).
إن الحرية هي المحبة، فالله خلق العالم بدافع المحبة وليس الإجبار، أيضًا تجسد وتألم بدافع المحبة لأجل الانسان، فالخليقة من هذا المنطلق، تئن وتتمخض (رو8 :22) وذلك منتظرة حريتها التامة من الإنسان الذي اختبر المحبة ويمارسها في حياته اليومية. والمسيحية تحرر الإنسان داخليًا ” وتعرفون الحق والحق يحرركم” (يو32:8).
وبالرغم من أن البشرية دخلت عصرًا جديدًا صارت فيه حرية التعبير ملمحًا أساسيًا من ملامح هذا العصر وصارت فيه المعرفة حقًا لكل الناس وانتهى فيه احتقار المعلومة والحجر عليها بتفجر ثورة المعلومات، إلاّ أنه تظل الحرية المسيحية ستظل هى الأساس للحفاظ على كل أشكال الحريات. فالتحرر الداخلى من الأهواء والشهوات واختبار الولادة الثانية، تجعل الإنسان يسلك سلوكًا جديدًا فيه الحرص على نبذ كل أشكال القهر والاستبداد والظلم، والانحياز الدائم للحرية والمحبة.
7 ـ التحول من الزمن المطلق المنعزل إلى الزمن الحامل للتاريخ
إن الفيزياء الكلاسيكية فصلت المكان عن الزمان، كل الكائنات الطبيعية لها خواص ومقاييس (مكانية) والزمن قد فُصل عن المكان، واُعتبر تابع وخاضع ويُفهم علي أنه بلا زمن بلا تاريخ ولا يحمل حوادث تاريخية ولا يمثل سوى مجري يسري من الماضي إلى المستقبل. وللأسف هذه النظرة قد أثرت علينا، فالزمن عندنا في حالة استرخاء، ومرور الزمن بدون استفادة قصوى مشكلة مجتمعية وليست فردية.
فالمجتمع الذي يتلكأ في إعطاء الحق لأحد أفراده أو يُطالب بإجراءات روتينية تطول لمدد زمنية كبيرة، حتى يوافق على علاج مريض، لا يُنتظر منه أن ينجز شيئًا ذى قيمة في أقل زمن ممكن. هكذا فاسترخاء الزمن يجعل حياة الأفراد تبدأ وتنتهى دون إنجازات تتفق مع المعنى المطلوب لحياته. أما الفيزياء الحديثة فقد وحّدت الزمان بالمكان بفضل النظرية النسبية لأينشتاين، لقد أصبحت الطبيعة تحمل تاريخ أي تغييرات بفعل الزمن[18].
لذا قول يعقوب الرسول: ” ما هى حياتكم إنها بخار يظهر قليلاً ثم يضمحل ” (يع14:4) يحفز الشخص على ضرورة الاستفادة بكل لحظة بل علينا أن نفتدى الوقت كما ينصحنا بولس: ” لأن الأيام شريرة ” (أف16:5).
إن العالم يتميز بالتطور الديناميكى نحو المستقبل وهذا يعني أنه في الطريق إلى التكامل، وأن المعرفة الآن لم تستنزف مسيرة العالم. فالطبيعة هي خليقة في حالة تحول وصيرورة نحو العتيدة الأخروية، لذا مهمة الإنسان عند الآباء هو تجديد العالم، وتجليه وتغييره في مسيرته هذه، لكي يصل إلى الهدف المرسوم له من قِبل (الله) وهو الاتحاد به في المسيح الذي هو بداية وهدف الخلق ” الكل به وله قد خُلق” (كو17:1). وهكذا بالتركيز علي الزمن التاريخي تتقابل الفيزياء الحديثة مع اللاهوت الآبائى الكتابي.
خاتمة
لقد تتبعنا مسيرة علم الفيزياء من الكلاسيكية (فى العصور الوسطى) إلى الحداثة (من بدايات القرن العشرين إلى اليوم) ورأينا كم كان هناك تأثير من هذا العلم على العلوم الأخرى الطبيعية والإنسانية والاجتماعية. أيضًا رأينا أن اللاهوت الغربى في العصور الوسطى كان على نفس مستوى الفيزياء الكلاسيكية للقرن السابع عشر. وعندما تطور علم الفيزياء مع بدايات القرن العشرين كشف عن حقائق تتمشى مع التعاليم اللاهوتية الأصيلة لكنيستنا الشرقية.
قد كشف البحث عن زيف الصراع الذي كان بين العلم والإيمان، وأن جذور هذا الصراع نشأ من اعتقاد الكنيسة الغربية آنذاك بوجود هوة عظيمة بين “الطبيعى” وما هو “فوق الطبيعى”، أى بين “الكون” و”الله”، بين “الأرضى” و”السماوى”، وبالتالى بين كل ما ينتمى إلى دائرة “الطبيعى”: (الكون والإنسان) وبين ما ينتمى إلى دائرة “ما هو فوق الطبيعى”: (الله والإيمان والتعاليم اللاهوتية). هذا الاعتقاد يفسر لنا التصادم الذي حدث ـ كما رأينا ـ بين الكنيسة الغربية والعلماء في العصور الوسطى.
أما كنيستنا فتبنت العلاقة الاعتمادية بين الخليقة والخالق، فالخليقة تستمد حياتها من الخالق، وانفصالها عنه يعنى رجوعها للعدم. لذا لا يوجد لدى آباء الكنيسة ما يسمى بالصراع بين ” الخليقة ” وكل ما ينتمى إليها وبين “الخالق”، بل العكس إن ارتقاء الإنسان والكون معه يعود ـ كما رأينا ـ إلى الشركة الحية بين الله والمخلوقات.
إن التأثيرات التي أحدثتها الفيزياء الحديثة كشفت عن رؤية ناضجة تجاه الله والكون والإنسان، وقد رصدنا بعض التطبيقات في حياتنا اليومية إيمانًا منا بأن التعاليم الروحية لها مردود في حياتنا اليومية، إذ هى غير منفصلة عن هموم المجتمع وآماله وطموحاته، لأنها تهدف لخلق إنسان جديد ومجتمع جديد.
[1] العظة الأولى عن ستة أيام الخليقة فقرة6 P.G. 29، 16BC.
[2] أنظر ندره اليازجي، مدخل إلى المبدأ الكلي، دار الغربال ـ دمشق المنشورات الجامعة ـ طرابلس ص 113ـ114.
3 أنظر الأسقف يوحنا زيزيولاس: “الوجود شركة”، ترجمة مركز دراسات الآباء، مايو 1989 ص 14.
[4] أنظر ماريوس بيغزوس، الأخلاق الشرقية والتقنية الغربية، إصدار غريغوري، أثينا 1993، ص28ـ37.
5 القديس كيرلس الأسكندرى، شرح إنجيل يوحنا، الجزء الأول، مركز دراسات الآباء 1989، ص 80.
6 القديس كيرلس الأسكندرى، المرجع السابق، ص 105.
7 القديس كيرلس الأسكندرى، المرجع السابق، ص 106.
8 القديس كيرلس الأسكندرى، المرجع السابق، ص 104.
9 أنظر ندرة اليازجي، المرجع السابق .
[10] أنظر ندرة اليازجي، المرجع السابق .
[11] علي هذا النحو نستطيع أن نفهم اكتشاف الدكتور زويل الذي حاز علي جائزة “نوبل” للكيمياء عن عام1999. لقد استطاع ملاحظة سلوك الجزئيات وتصويرها بسرعة فائقة، وتتبع التحولات التي تحدث بعد أي نشاط كيميائي، مما سهل متابعة التفاعلات لحظة ولادتها ومشاهدة بناء الفراغ البلوري للعناصر، وهكذا يمكن تعديل وإصلاح أي أخطاء قد يحدث وينعكس ذلك علي المجالات الاستراتيجية ذات التطبيقات الحيوية المهمة للإنسانية” أنظر الأهرام ص13، 14/10/1999 وتتبع آثار هذا الاكتشاف علي الهندسة الميكانيكية والاحتراق الداخلي، والطب وعلاج السرطان والعقم وأيضا الاندماج النووي .
[12]هذه التأثيرات قد ذكرها بالتفصيل البروفيسور ماريوس بيغزوس في كتابه الأخلاق الشرقية والتقنية الغربية، أثينا 1993
13 أنظر الأب فرنسوا فاريون، فرح الإيمان بهجة الحياة، دار المشرق بيروت، 1988، ص166 (باللغة اليونانية).
14 الأستاذ رجب البنا: ” الجزر المستقلة في الجامعات ” جريدة الأهرام 5/3/2000.
15 يقول الأسقف يوحنا زيزيولاس في كتابه “الوجود شركة”: [ إن الآباء من رعاة الكنيسة كان لاهوتهم رعائى وهؤلاء مثل أغناطيوس الأنطاكى وايريناوس وأثناسيوس قد استوعبوا حقيقة وجود الله وجوهره من خلال الاختبار الكنسى أى الوجود الكنسى أو من خلال اختبار الحياة الجديدة في المسيح التي تؤهل الإنسان لأن ينال الكيان الكنسى. وأدرك هؤلاء الآباء من خلال هذا الاختبار حقيقة هامة وهى أن كيان الله ووجوده إنما يُعرف من خلال العلاقة الشخصية والمحبة الشخصية فالوجود يعنى حياة والحياة تعنى الشركة]. الأسقف يوحنا زيزيولاس، الوجود شركة، ترجمة مركز دراسات الآباء مايو 1989 ص 3.
16 الأسقف يوحنا زيزولاس، المرجع السابق، ص 18.
17 الأستاذ محمد سيد أحمد: ” تحديات النهضة التكنولوجيا”، جريدة الأهرام 14/10/1999م.
[18] ومن هذا المنطلق نستطيع أن ندرك مدي أهمية نظرية ” الفيمتو ثانية ” للدكتور زويل، والتي بمقتضاها يستطاع مشاهدة التفاعلات والتغيرات علي مستوي حركة الذرات والأجزاء الداخلة في التفاعل أثناء حدوثه وذلك في آلة الاحتراق الداخلي بمعدل سرعات قد تصل إلى ألف مليون صورة كل ثانية (بينما قبل هذا الاكتشاف كانت السرعة مليون صورة في الثانية) مما يعطينا تفهما أكثر لطبيعة هذه التفاعلات وكيفية التحكم في النواتج الضارة. أنظر مقال الدكتور/ مصطفي محمد كامل أستاذ الهندسة الميكانيكية والاحتراق الداخلي بجامعة القاهرة، الأهرام 14/10/1999 ص 13 .