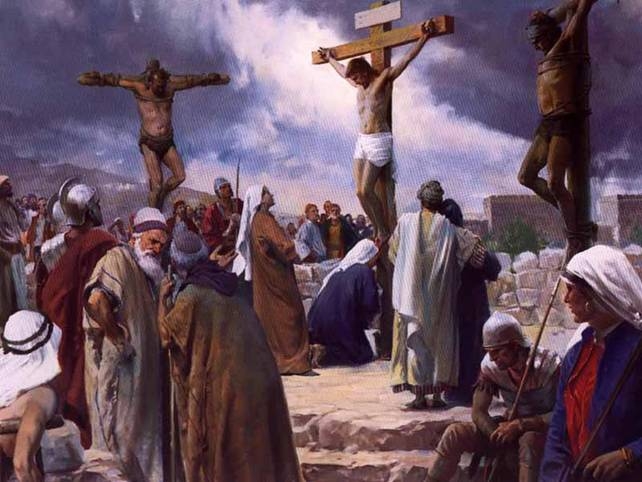ما يكمن وراء القانون – سي إس لويس
ما يكمن وراء القانون – سي إس لويس

ما يكمن وراء القانون – سي إس لويس
هذه المقالة هي جزء من كتاب “المسيحية المجردة” لسي أس لويس، ولقراءة كل مقالات الكتاب مفرغة على موقع فريق اللاهوت الدفاعي فإضغط هنا:http://goo.gl/hy23Rm ولقراءة المقالة السابقة إضغط هنا: http://www.difa3iat.com/31155.html
لنُلخص ما قد توصلنا إليه حتى الآن. في حالة الأحجار والأشجار وما يشابهها، ربما لا يكون ما ندعوه قوانين الطبيعة مجرد أسلوب في الكلام. فعندما نقول إن الطبيعة تحكمها قوانين معينة فقد لا يعني ذلك سوى أن الطبيعة تتصرف فعلاً، في الواقع، بطريقة معينة. وعليه، فما ندعوه قوانين ربما لا يكون أمراً حقيقياً، أو أمراً مستقلاً عن الحقائق الفعلية التي نلاحظها وقائماً بذاته. لكننا رأينا أن هذا ينطبق على الإنسان. فلا بد أن يكون قانون الطبيعة الإنسانية، أو قانون الصواب والخطأ، شيئاً مختلفاً ومستقلاً عن الحقائق الفعلية المتعلقة بالسلوك البشري. وفي هذه الحالة فضلاً عن الحقائق الواقعة، لدينا شيء آخر: قانون حقيقي لم نخترعه نحن، ونعلم أن علينا الخضوع له.
والآن أُريد أن ننظر فيما يقوله ذلك العالم الذي نعيش فيه. فمنذ صار البشر قادرين أن يفكروا، استمروا يتساءلون ماهية هذا الكون حقاً وكيف خرج إلى الوجود. وقد انقسم الناس كلهم تقريباً بين رأيين اعتنقوهما. فأولاً، هناك ما يسمى الرأي المادي. ويعتقد معتنقو هذا الرأي أن المادة والفضاء انوجدا صدفة فحسب، وأنهما تواجدا دائماً، ولا أج يعرف لماذا؛ وأن المادة إذ تصرفت بطرق معينة ثابتة، اتفق أنها بنوع من المصادفة انتجت مخلوقات نظيرنا نحن قادرة على التفكير. فبمصادفة واحدة من ألف، ضرب شيء ما شمسنا وجعلها تُنتج الكواكب.
وبمصادفة أُخرى من ألف، صدف أن وُجدت على واحد من تلك الكواكب المواد الكيماوية الضرورية للحياة الحرارة الملائمة، وهكذا دبّت الحياة في بعض المادة على هذه الأرض. ثم بسلسلة طويلة جداً من المصادفات تطورت الكائنات الحية إلى مخلوقات مثلنا. أما الرأي الآخر فهو الرأي الديني، وبحسبه أن ما هو وراء الكون إنما هو أشبه بعقل منه بأي شيء آخر نعرفه. معنى ذلك أنه كائن مدرك واع، وله مقاصد، ويُفضل أمراً على أمر. وعلى أساس هذه الرؤية، صنع هو الكون، جزئياً لأغراض لا نعرفها، ولكن جزئياً، على أية حال، كي يُنتج خلائق تشبه، أعني أنها تشبهه من حيث حيازتها عقولاً.
رجاء، لا تحسب أن واحداً من هذه الرأيين تم اعتناقه منذ زمان طويل ثم حل الآخر محله تدريجياً. فحيثما تواجد ناس مفكرون، كان كلا الرأيين موجودين. ولاحظ أيضاً هذا: أنك لا تستطيع أن تتبين أي الرأيين هو الصائب بواسطة العلم بمعناه المألوف. فالعلم يشتغل بالاختبارات، وهو يراقب الأشياء كيف تتصرف. وكل تصريح علمي، في نهاية المطاف، مهما بدا معقداً، يعني بالحقيقة شيئاً مثل هذا: “لقد وجهت التلسكوب نحو الجزء كذا وكذا من الفضاء، في الساعة الثانية والثلث بعد نصف الليل، في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير، ورأيت كذا وكذا” أو “وضعت قليلاً من هذه المادة في إناء، وغليته حتى درجة الحرارة كذا وكذا ففعل كذا وكذا”.
لا تظنوا أني أقول أي شيء ضد العلم، فأنا إنما أقول ما هي وظيفة العلم. وكلما ازداد المرء علماًن قويت في اعتقادي موافقته لي على أن هذه هي وظيفة العلم. وهي فعلاً وظيفة نافعة كثيراً وضرورية جداً. أما لماذا يخرج إلى الوجود أي شيء من الموجودات، وهل يوجد وراء الأشياء التي يلاحظها العلم شيء، شيء ما من نوع مختلف، فليس هذا سؤالاً علمياً. وإن كان وراء الكون “كائن ما”، فعندئذ ينبغي إما أن يبقى مجهولاً لدى الإنسان كلياً وإما أن يُعلن ذاته بطريقة من الطرق مختلفة. ثم إن التصريح بأن كائناً كهذا موجود، والتصريح بأن كائناً كهذا غير موجود، كلاهما ليس تصريحاً يمكن أن يُصدره العلم. والعلماء الحقيقيون عادة لا تصدر عنهم تصريحات من هذا النوع.
إنما هم الصحافيون وكتاب الروايات الشعبيون الذين عادة من يلتقطون نثريات قليلة من العلم غير المدروس من بطون الكتب ثم يبادرون إلى إطلاق تصريحات كهذه. وبعد، أفليست هذه مسألة فطرة سليمة؟ وعلى فرض أن العلم صار ذات يوم كاملاً بحيث بات يعلم كل أمر بمفرده من أمور الكون كله، أفليس واضحاً تماماً أنه لن يطرأ أي تغيير البتة على هذه الأسئلة: “لماذا الكون موجود؟”، “لماذا يدوم على حاله؟”، “ألَهُ أي معنىً؟”
وكان من شأن الوضع أن يكون موئِساً تماماً لولا هذا الأمر: أن في الكون بكامله شيئاً واحداً فقط لا غير نعرف عنه أكثر مما يمكننا أن نتعلمه من الملاحظة الخارجية، وذا الشيء الواحد هو الإنسان. ونحن لا نلاحظ البشر فحسب، بل إننا بشر أيضاً. ففي هذه الحالة لدينا معلومات داخلية. إذا جاز التعبير، لكوننا في قلب المعرفة. وبسبب ذلك نعلم أن البشر يجدون أنفسهم تحت قانون خلقي أو أدبي، لم يصنعوه هم، ولا يمكنهم نسيانه تماماً حتى حين يحاولون ذلك، ويعلمون أنه ينبغي لهم أن يخضعوا له.
ولنلاحظ النقطة التالية: إن أي شخص يدرس الإنسان من خارج، مثلما ندرس الكهرباء أو الملفوف، وهو لا يعرف لغتنا ولا يقدر تالياً أن يحصل منا على أية معرفة داخلية، بل يلاحظ فقط ما يقوم به، لن يحصل البتة على أدنى بينة على وجود هذا القانون الخُلقي لدينا. وأنّى له ذلك فيما تُبين له ملاحظاته ما نفعله فقط، والقانون الخُلقي يدور حول ما ينبغي لنا أن نفعله؟ وعلى المنوال عينه، لو كان في حال الحجارة أو الطقس أي شيء مستقل عن الحقائق الملحوظة أو وراءها، لما كان في وسعنا قطعاً أن نرجو اكتشافه بدراسة تلك الأشياء من خارج.
ومن ثم كان لب المسألة شبيهاً بهذا: أننا نريد أن نعرف عن الكون أهو موجود بالمصادفة على ما هو عليه فحسب، أم وراءه قوة تجعله على ما هو عليه؟ وبما أن تكل القوة، في حال وجودها، لن تكون واحدة من الوقائع الملحوظة بل حقيقة توجد تلك الوقائع، فلا يمكن عموماً لمجرد الملاحظة أن تهتدي إليها. ولكن ثمة حالة واحدة فقط يمكننا فيها أن نعرف بوجود شيء إضافي أو بعدم وجوده، ألا وهي حالتنا نحن البشر. وفي هذا الحالة يتبين لنا وجود شيء نظير ذلك.
أو لنعبر عن القضية بأسلوب معاكس: إذا كان خارج الكون قوة ضابطة، فلا يمكن أن تُظهر لنا ذاتها كواحدة من الحقائق الواقعة داخل الكون، كما لا يقدر مهندس منزل ما أن يكون في الواقع جداراً أو درجاً أو موقداً في ذلك المنزل. فالطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أن نتوقع من تلك القوة إظهار ذاتها ستكون داخل أنفسنا، بصورة سُلطة مؤثرة أو وصية ثابتة تحاول أن تحملنا على التصرف بطريقة معينة. وذلك تماماً هو ما نجده داخل أنفسنا.
أفليس مؤكداً أن هذا الأمر ينبغي أن يثير تساؤلاتنا؟ في الحالة الوحيدة التي فيها يمكننا أن نحصل على جواب يتبين أن الجواب هو “بلى”. أما في الحالات الأخرى، حيث لا تحصل على جواب، فتدرك سبب عدم حصولك عليه. هب شخصاً سألني عندما أرى رجلاً لابساً زياً أزرق يسير في الشارع ويترك عند باب كل بيت ظرف ورق صغيراً: “لماذا تفترض أن تلك الظروف تحتوي على رسائل؟” فيكون جوابي:
“لأنه عندما يترك لي هذا الرجل ظرفاً صغيراً مشابهاً، يكون محتوياً على رسالة بالفعل!” وإذا اعترض بعدئذ قائلاً: “ولكنك لم تر قط كل تلك الرسائل التي تحسب أن الناس يتلقونها”، فلا بد أن أقول له: “طبعاً لم ارها، ولكن لا ينبغي لي أن أتوقع رؤيتها، لأنها غير موجهة إلي.
فأنا أفسر الظروف التي لا يحق لي أن أفتحها من خلال تلك التي يحق لي فتحها”. والأمر نفسه ينطبق على هذا المسألة. فالظرف الوحيد المسموح لي بأن أفتحه هو الإنسان. وحين أفعل ذلك، ولا سيما حين أفتح ذلك الإنسان المخصوص المدعو أنا، أجد أنني غير موجود مستقلاً بذاتي، وأنني تحت قانون ما، وأن شخصاً ما أو شيئاً ما يريد مني أن أتصرف بطريقة معينة.
ولست أحسب بالطبع أني إذا استطعت بلوغ داخل حجر أو شجرة فسأجد الأمر عينه تماماً، مثلما لا أحسب أن جميع الناس الآخرين في الشارع يتلقون الرسائل عيناها التي أتلقاها أنا. ينبغي لي مثلاً أن أتوقع الاهتداء إلى أن على الحجر أن يخضع لقانون الجاذبية، وأنه بينما يكتفي باعث الرسائل بأن يطلب مني إطاعة قانون طبيعتي الإنسانية، يُجبر الحجر على إطاعة قوانين طبيعته الحجرية، ولكن ينبغي لي أن أتوقع الاهتداء إلى أن وراء الحقائق الواقعة، إن صح التعبير، مُرسلاً للرسائل في كلتا الحالتين: قوة أو مدبراً أو مرشداً.
لا تتصور أنني أسير أسرع مما أنا سائر فعلاً. فأنا لم أصل بعد إلى نطاق مئة ميل بالقرب من إله اللاهوت المسيحي، بل كل ما وصلت إليه الآن شيء ما يُدبر الكون ويظهر فيَّ بصورة قانون يحثني على فعل الصواب ويجعلني أشعر بالمسؤولية والقلق حين أفعل الخطأ.
وأعتقد أن علينا أن نفترض أنه اشبه بعقل منه بأي شيء آخر نعرفه: لأن الأمر الوحيد الآخر الذي نعرفه، رغم كل شيء، إنما هو المادة، وأنت لا تكاد تتصور قطعة من المادة مُصدِرة للتوجيهات! ولكن بالطبع لا داعي لأن يكون ذلك الشيء كثير الشبه بعقل، ولا ضئيل الشبه بشخص. وسنرى في الفصل التالي هي يمكننا أن نهتدي إلى المزيد بشأنه. إنما لا بد من كلمة تحذير. لقد حفلت المئة سنة الأخيرة بمقدار كبير من كلام المداهنة أو الاسترضاء عن الله. فليس هذا مما أقدمه في هذا الكتاب. وفي وسعك أن تصرف نظرك عن ذلك كله.
ملاحظة: توخياً لإبقاء هذا الجزء قصيراً على نحو كاف عند إذاعته على الهواء، لم أذكر سوى الرأي المادي والرأي الديني. لكن تكميلاً للموضوع، ينبغي لي أن أذكر الرأي الوسيط المدعو فلسفة قوة الحياة (Life-Force Philosophy)، أو التطور الخلاّق (Creative Evolution)، أو التطور الطبيعي (Emergent Evolution). وأذكر الشروح لهذا الرأي وردت في آثار برناد شو (Bernard Shotw)؛ أما أعمقها فقد تضمنتها آثار برغسون (Bergsn).
ويقول معتنقو هذا الرأي إن التحولات الصغيرة التي بها “تطورت” الحياة على كوكبنا هذا من أدنى أشكالها إلى الإنسان لم تكن من جراء الصدفة، بل بفعل “كفاح” قوة الحياة أو “غائيتها”. فحين يقول قوم هذا القول، يجب أن نسألهم: أيقصدون بقوة الحياة شيئاً ذا عقل، أم لا؟ فإذا كان جوابهم “نعم”، فعندئذ يكون “العقل الموجد للحياة والموجه لها إلى الكمال” إلهاً بالحقيقة، ويكون رأيهم من هذا القبيل موفقاً للرأي الديني تماماً. وإذا كان جوابهم “لا” فأي معنى عندئذ للقول إن شيئاً بلا عقل “يكافح” أو “تكون له غاية”؟ يبدو لي أن هذه ضربة قاضية لرأيهم.
ومن الأسباب الكامنة وراء اعتبار كثيرين من الناس “التطور الخلاق” جذاباً جداً أنه يؤتي المرء كثيراً من الراحة العاطفية المقترنة بالإيمان بالله دون أية عاقبة من العواقب الأقل استساغة. فعندما تشعر بأنك في أحسن حال وتكون الشمس مشرقة، ولا تريد أن تصدق أن الكون كله مجرد رقص آلي للذرات، يحسن بك أن تتمكن من التفكير في هذا القوة الغامضة العظيمة وهي تجري عبر العصور حالمة إياك على متنها.
أما إذا أردت أن تفعل شيئاً أقرب إلى الخفة، فإن قوة الحياة، لكونها مجرد قوة عمياء بلا أخلاق ولا عقل، لن تتدخل في شؤونك أبداً على غرار ذلك الإله “المزعج” الذي تعلمنا عنه لما كنا صغاراً. إن قوة الحياة أشبه بإله أليف: يمكنك أن تُشغلها عندما تريد، ولكنها لن تزعجك. وهكذا تحصل على مباهج الدين كلها بغير أن تدفع شيئاً من الثمن! أتكون قوة الحياة إنجاز شهده العالم حتى الآن في مجال التفكير الرغبيّ، أو التفكير الذي تُمليه الأماني؟
وإلى المقال التالي: قلقنا مبرر – سي إس لويس