الشك والإيمان – العدوان كلاهما على حق | تيموثي كلر
الشك والإيمان – العدوان كلاهما على حق | تيموثي كلر
الشك والإيمان – العدوان كلاهما على حق | تيموثي كلر
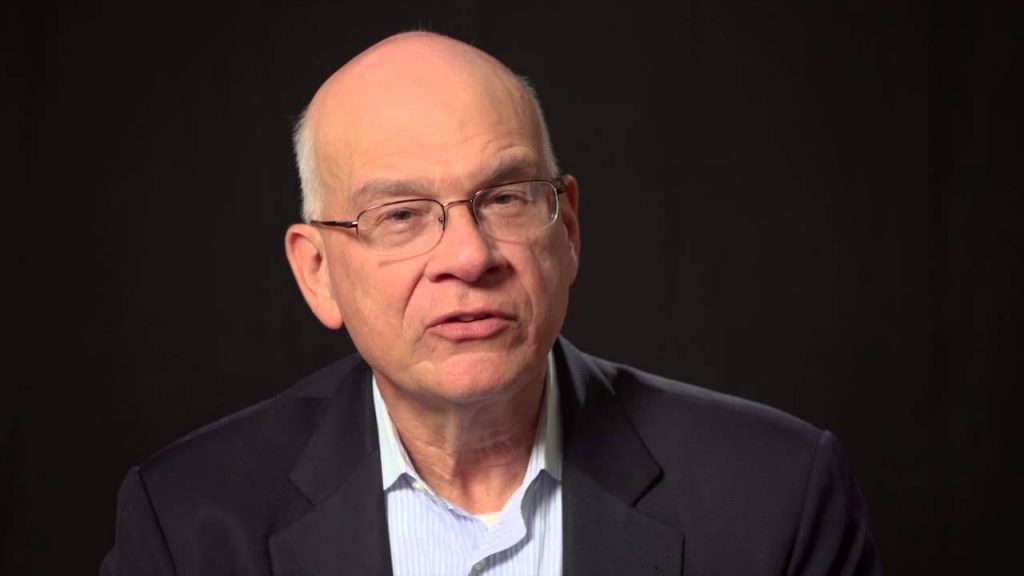
ثَمَّة ثغرةٌ واسعةٌ اليومَ بين ما يُدعى عمومًا اللِّيبراليَّة والمُحافَظة. ولا يُطالِبك كلا الجانبَين بأن تُخالِفَ الآخرَ فحسب، بل بأن تَزدريَهُ أيضًا باعتباره (في أفضل الحالات) ضعيفًا، أو (في أسوأها) شرًّا. وهذا صحيحٌ على الخصوص حين يكونُ الدِّين هو المسألةَ الجاريَ بحثُها. فالتقدُّميُّون يُجاهرون بأنَّ الأصوليَّة تنمو بسرعةٍ وعدمَ الإيمان يُوصَم بالعار. وهم يُنوِّهون بأنَّ السياسة قد تحوَّلت نحو اليمين المتطرِّف، تدعمُها الكنائس الكُبرى ويَحدوها المؤمنون المُحفَّزون المتمسِّكون بالعقيدة القويمة. والمُحافِظون يُندِّدون دون انقطاع بما يَرَونه مُجتمَعًا ينحو باتِّجاه الشُّكوكيَّة والنِّسبيَّة على نحوٍ مُتفاقِم. وهم يقولون إنَّ الجامعاتِ الكبرى والشركاتِ الإعلاميَّة والمؤسساتِ الممتازةَ دُنيَويَّةٌ إلى الحدِّ الأقصى، وهي تُسيطِر على الثقافة.
فما واقع الحال؟ ألِلشُّكوكيَّة الهيمَنَةُ في العالَم اليوم، أم للإيمان؟ الجواب هو نعم بالنسبةِ إلى كِلَيهما. فالعَدوَّان كلاهما على حقّ. ذلك أنَّ الشكَّ والخوفَ والغضبَ تُجاه الدِّين التقليديِّ تَتَعاظمُ قوَّةً وتأثيرًا. ولكنْ في الوقت نفسه يتنامى أيضًا الإيمانُ القويُّ القويمُ بمعتقدات الدِّين العريقة.
إنَّ عددَ الذين لا يرتادون الكنائسَ في أميركا وأوروبا يزداد باطِّراد.[1] وفي أثناء العقد الأخير، ازدادَ عددُ الأميركيِّين الذين يُدْلون في الاستطلاعات بعدم وجود تفضيل دينيٍّ لديهم ازديادًا صاروخيًّا، إذ تَضاعفَ مرَّتين أو حتَّى ثلاثًا.[2] وقبل قرنٍ من الزمان، تحوَّلتْ معظمُ جامعات أميركا عن أساسٍ مسيحيٍّ رسميٍّ إلى أساسٍ دنيويٍّ علنيّ.[3] ونتيجةً لذلك، فإنَّ لأصحاب المعتقدات الدينيَّة التقليديَّة مَوطئَ قَدمٍ صغيرًا في المؤسَّسات ذات النُّفوذ الثقافيّ. ولكنْ رُغمَ تَزايُد عدد الذين يُعرِّفون بأنفسُهم باعتبارهم لا يملكون أيَّة خِيارات دينيَّة، فإنَّه تنمو في الولايات المتَّحدة الأميركيَّة – وتنفجرُ في أفريقيا وأميركا اللاتينيَّة وآسِيا – كنائسُ مُعيَّنةٌ ذاتُ عقائدَ يُفتَرَضُ أنَّها مَهجورة بكتابٍ مقدَّس معصوم ومُعجِزاتٍ بائدة. حتَّى إنَّ قسمًا كبيرًا من أوروبا يَشهدُ شيئًا من الارتفاع في نسبة حضور الكنائس.[4] وعلى الرُّغم من دًنيويَّة معظم الجامعات والكلِّيَّات، فإنَّ الإيمانَ الدينيَّ ينمو في بعض الأركان في الجامعات. ويُقدَّرُ أنَّ ما بين 10 25% من جميع مُعلِّمي الفلسفة وأساتذتها في أميركا هم مسيحيُّون مُلتزِمون، بعدما كانَتِ النِّسبة قبل ثلاثين سنة فقط أقلَّ من 1%.[5] وربَّما كانت عّينُ الجامعيِّ البارز ستانلي فِش (Stanley Fish) على هذا الاتِّجاه السائد لمَّا أفادَ قائلاً: “حين تُوِفِّيَ جاك دِريدا (Jacques Derrida) في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، هاتَفَني مُراسلُ صحيفةٍ أراد ان يعرفَ ما الذي سيَعقبُ النظريَّة العالية وثالوثّ العِرق والجنس والطِّبقة ليكونَ بؤرةً للنشاط الفكريِّ في الدوائر الجامعيَّة، فقلتُ حالاً وبغير تردُّد: الدِّين”.[6]
وبالاختصار، إنَّ العالَمَ يُستقطَبُ حَول الدِّين. وهو صائرٌ أكثر تَديُّنًا وأقلَّ تَديُّنًا في الوقت نفسه. ولقد سادَ حينًا اعتقادٌ وثيقٌ أنَّ البلدانَ الأوروبيَّة اللَّادينيَّة كانت رائدةَ باقي العالَم. وقد عمَّ التفكيرُ بأنَّ الدِّين سوفَ يَضمرُ عن أشكاله الأكثر قوَّةً وفوطبيعيَّةً (شكلاً خارقًا للطبيعة)، أو يتلاشى كلِّيًّا. غير أنَّ النظريَّةَ القائلةَ إنَّ التقدُّم التكنولوجيَّ يأتي بالعَلمنة الحتميَّة يجري التخلُّص منها، أو يُعاد النظر فيها جذريًّا.[7] حتَّى إنَّ أوروبا قد لا تُواجِه مُستقبلاً لا دينيًّا، فيما المسيحيَّة تَتَنامى باعتدال والإسلامُ يتزايدُ أنصارُه.
المُعَسكران
إنِّي أتكلَّمُ من نُقطة استشراف استثنائيَّة لهذه الظاهرة ذاتِ الحدَّين. فقد تربَّيتُ في كنيسةٍ لوثريَّة مُحافِظة شرقَ ولاية پنسلفانيا الأميركيَّة. ولمَّا بلغتً سنَّ المُراهقة في ستِّينيَّات القرن العشرين، حان وقتُ حضوري صفَّ التثبيت، حيثُ درستُ مُقرَّرًا دام سنين وشملَ مُعتقداتِ المسيحيَّة وممارساتِها وتاريخَها. وكان الهدفُ من ذلك تزويدُ الناشئة بِفَهمٍ اوفى للإيمان المسيحيِّ حتَّى يُمكنّهم التِزامه علنيًّا. وقد كان مُعلَّمي في السنة الأولى خادمًا متقاعدًا. وكان تقليديًّا ومُحافِظًا جدًّا، يتكلًّم أغلبَ الأحيان بشأن خطر جهنَّم ووجوبِ حيازةِ إيمانٍ فعَّال. أمَّا في السنة الثانية من الدُّروس، فكان الملِّم أكليريكيًّا (رجل دينٍ) شابًّا تخرَّج توًّا في معهد اللاهوت. وقد كان ناشطًا اجتماعيًا ساورَته شكوكٌ عميقةٌ كثيرة بشأن العقائد المسيحيَّة العريقة.
ففي السنة الأولى وقفْنا أمام إلهٍ قدُّوس وعادل لا يمكن أن يُصرَف غضبُه عنَّا إلَّا بجهد وكلفةٍ عظيمَين. وفي السنة الثانية، سمعنا عن روحِ مَحبَّةٍ في الكون تطلُبُ منَّا بصورةٍ رئيسيَّة أن نعمل في سبيل حقوق الإنسان وتحرير المظلومين. فكأنَّنا عُلِّمنا مبادئَ ديانتين مختلفتين تقريبًا. وكان السؤال الرئيسيُّ الذي أردتُ أن أطرحه على مُعلِّمَينا: “أيُّ واحدٍ منكما يكذب؟” ولكنَّ أبناء الرابعةَ عشرةَ يُعوِزُهم شئٌ من الجُرأة، فما كان منَّي إلَّا أن أبقَيتُ فمي مُطبّقًا.
بعد ذلك انتقلَتْ عائلتي إلى كنيسة أكثرَ محافَظةً تنتمي إلى طائفةٍ ميثوديَّة صغيرة. وعلى مدى بضعة أعوام قوَّى هذا الأمر ما يمكن أن يُدعى باسْم “طبقة نار جهنَّم” في تكويني الدينيّ، مع أنَّ الخادم والمخدومين هناك كانوا ألطفَ ما يكون على الصعيد الشخصيّ. ثُمَّ انتقلتُ للدراسة في إحدى تلك الجامعات الجيِّدة المُتحرِّرة الصُّغرى الواقعة في الشمال الشرقيّ، وسرعان ما بدأتْ تَصُبُّ الماءَ على جهنَّمَ المُضطرِمة في مُخيِّلتي.
لقد شهدتْ دوائرُ التاريخ والفلسفة ثورةً على الصَّعيد الاجتماعيِّ وتأثَّرتْ كثيرًا بالنظريَّة النَّقديَّة الماركسيَّة المُحدَثة (The Neo-Marxist Critical Theory) التي تبنَّتها مدرسةُ فرانكفورت. وكانت تلك بضاعةً خلَّابة في سنة 1968. وكان مذهبُ الفعَّاليَّة الاجتماعيُّ (The Social Activism) جذَّابًا على نحو خاصّ، كما كان نقدُ المجتمع الأميركيِّ البورجوازيِّ آسِرًا، غير أنَّ أُسُسَه الفلسفيَّة كانت مُربِكةً لي. وبدا لي أنِّي أرى أمامي مُعسكَرَين، وكان في كِلَيهما شيء من الخَلَل الجذريّ.
فالأشخاص الأكثرُ شغفًا بشأن العدالة الاجتماعيَّة كانوا من القائلين بالنِّسبيَّة على الصعيد الأخلاقيّ، فيما لم يبدُ أنَّ المُستقيمين خُلُقيًّا يَعنيهم الطُّغيان المُتمادي في جميع أنحاء العالم. وقد انجذبتُ عاطفيًّا إلى السبيل الأوَّل … وأيُّ شابٍّ لا ينجذبُ إليه؟ حرِّرِ المظلومين ونَمْ مع مَن شِئت! غير أنِّي ما توقَّفتُ عن طَرْح السؤال: “إذا كانتِ الأخلاقيَّات نسبيَّة، فلِمَ لا تكونُ العدالةُ الاجتماعيةَّ مثلَها أيضًا؟” فقد بدا هذا تَضارُبًا صارخًا في أساتذتي وأتْباعهم. ومع ذلك لَفَتَني أيضًا التناقُضُ الهائل في الكنائس التقليديَّة. فكيف يُمكنني أن أركِن من جديد إلى نوع المسيحيَّة المألوفة ذاك الذي يؤيِّدُ العزلَ العرقيَّ في الجنوب وسياسةَ التمييز العُنصريِّ في جنوب افريقيا؟ إذ ذاك بدأتِ المسيحيَّةُ تبدو مصطنعَّةً جدًّا في نظري، رُغم أنِّي لم أستطعْ أن أميِّز حياةٍ وفِكرٍ بديلةً قابلة للتطبيق.
ورُغم عدم معرفتي بواقع الحال آنذاك، فإنَّ هذه الروحيَّة “المُصطنَعة” نجمَتْ عن ثلاث عوائقَ اعترضَتْ سبيلي. وفي أثناء دراستي الجامعيَّة، تآكلتْ هذه العوائق الثلاثة، وغدا إيماني أكثر حيويَّةً وتأثيرًا في الحياة. وقد كان العائق الأوَّل فكريًّا. إذ واجهَتني جَمهرةٌ من الأسئلة الصعبة بشأن المسيحيَّة: “ماذا نقول في الأديان الأخرى؟ وماذا عن الشرِّ والمُعاناة؟ كيف يُمكن أن يَدينَ إلهٌ مُحبٌّ البشرَ ويُعاقبَهم؟ ولماذا عليَّ أن أعتنق أيَّ إيمانٍ أصلًا؟” ثُمَّ بدأتُ أقرأ كُتبًا ودراسات جدليَّةً في كلا جانبَي هذه المسائل. وبِبطءٍ لكنْ بِثَبات، بدأتِ المسيحيَّةُ تعني لي أكثرَ فأكثر. وباقي هذا الكتاب يَبسطُ الدواعيَ التي تجعلني أعتقدُ ما أعتقدَهُ بعد.
أمَّا ثاني العوائق فكان عائقًا داخليًّا شخصيًّا. فعندما يكون المرء صغيرًا يمكن أن تعتمدَ معقوليَّةُ إيمانٍ ما (إيمانٍ مقبولٍ ظاهريًّا) على سُلطة الآخرين، ولكنْ حين نبلُغُ سنَّ الرُّشد تدعو الحاجة إلى اختبار شخصيٍّ مباشر أيضًا. وبينما كنتُ قد واظبتُ سنين على “تلاوة صلواتي”؛ وكان يأخذُني أحيانًا ذلك الشعورُ الإلهاميُّ الجماليُّ بالرَّهبة والرَّوعة حِيالَ منظر بحرٍ أو جَبَل، لم أكُن قطُّ قد اختبرتُ حضورَ الله شخصيًّا. ولم يتطلَّب هذا معرفةً وافيةً للتِّقنيَّات المتعلِّقة بالصلاة، بل تطلَّب عمليَّةً أدَّت بي إلى إدراك احتياجاتي ونقائضي ومشاكلي. وقد كانت عمليَّةً مؤلمة، أطلقتْ شرارَتها خَيباتٌ وسَقطات – كما هي الحال وكما يحدُثُ نموذجيًّا. ومن شأن الغوص في هذه كلِّها أن يستدعيَ كتابًا آخرَ مختلفَ النَّوع. ولكنْ لا بدَّ من القول إنَّ رحلاتِ الإيمان ليستِ البتَّة مجرَّدَ اختباراتٍ فكريَّة.
وأمَّا العائقُ الثالث فكانَ عائقًا اجتماعيًّا. ذلك انِّي احتجتُ أمسَّ احتياج إلى العثور على “مُعسكَر ثالث” – إلى جماعة من المؤمنين بالسيِّد المسيح لديهم اهتمامٌ بالعدالة في العالَم، ولكنَّهم يؤسِّسونَه على طبيعة الله، لا على مشاعرهم الذاتيَّة الخاصَّة. ولمَّا عثرتُ على تلك المجموعة المؤلَّفة من إخوة – ومن أخوات (بالأهمِّيَّة نفسها تمامًا!) – بدأَتِ المور تتغيَّر بالنِّسبة إليَّ. ولم تسقطْ هذه العوائقُ سريعًا، ولا وَفقًا لترتيبٍ معلوم، بل كانتْ بالأحرى مُتضافرة ومتوافقة. ولم أتَصدَّى لهذه العوائق بأيَّة طريقةٍ مَنهجيَّة. إنَّم بالإدراك المُتأخِّر وحدَه (أي بعد انقضاء الأمر) أرى الآن كيف عملَتْ هذه العواملُ الثلاثة معًا. ولأنِّي كنتُ دائمًا أفتِّش عن ذلك المُعسكَر الثالث، بِتُّ مَعنيًّا بتشكيل جماعات مسيحيَّة جديدة ومَعنيًّا بإطلاقها أيضًا. وقد عنى ذلك انخراطي في الخدمة، وهكذا دخلتُها بعد بضع سنواتٍ من إنهاء دراستي الجامعيَّة.
المشهدُ من مَنهاتن
في أواخر ثمانينيَّات القرن العشرين، انتقلتُ إلى مَنهاتن، مع زوجتي كاثي (Kathy) وأولادنا الثلاثة الصِّغار لإنشاء كنيسة جديدة في حيِّ لا يرتادُ مُعظم سكَّانه الكنائس. وفي أثناء مرحلة البحث قال لي الجميع تقريبًا إنَّها كانت مُغامرةً سخيفة. فالكنيسة تعني الاعتدال أو المحافظة؛ والمدينة كانت ليبراليَّة وسيِّئة الخُلُق مهتاجة. والكنيسة تعني العائلات؛ ومدينة نيويورك كانت تغصُّ بالعازبين الشُّبان والشابَّات و “الأسَر غير التقليديَّة”. والكنيسة أوَّلَ كُلَّ شئ تعني الإيمان؛ غير أنَّ مَنهاتن كانت بلد الشكوكيِّين والنُّقَّاد والساخرين. وكان أهلُ الطبقة الوسطى – وهي السُّوق المألوفة لقيام كنيسة – يُغادرون المدينة هربًا من الجريمة وغلاء المعيشة. فلم يبقَ إلّا المُتأنِّقون والغوغاء، الأغنياء والفُقراء. ومُعظم هؤلاء القوم يكتفون بالضَّحك حيالَ فكرة وجود كنيسة/ كما قيل لي. فإنَّ رعايا الكنائس في المدينة كانوا يتضاءلون، وكان معظمهم يكافحون لمجرَّد صيانة مبانيهم.
وقد قال كثيرون ممَّن استقَيتُ منهم معلوماتي الأوَّليَّة إنَّ الكنائسَ لقليلة التي حافظتْ على مُرتاديها فعلتْ ذلك بتكييف التعليم المسيحيِّ لتقليديِّ وَفقًا لمزاج المدينة الذي يميلُ إلى التَّعدُّديَّة. “لا تقلْ للناس إنَّه ينبغي لهم أن يؤمنوا بالسِّد المسيح؛ فذلك يُعدُّ تزمُّتٍا هنا”. وعبَّروا عن شكِّهم لمَّا أوضحتُ انَّ معتقداتِ الكنيسة الجديدة ستَكونُ عقائدَ المسيحيَّة التاريخيَّةَ العريقة – عصمةَ الكتاب المقدَّس وألوهيَّةَ السيِّد المسيح ووجوبَ الولادة الجديدة – وهي كلُّها عقائدُ تُعدُّ عتيقةَ الطِّراز عند أكثريَّة النِّيويوركيِّين. لم يقُلْ لي أحدٌ قطُّ بصوتٍ عالٍ “أنتَ حالِمٌ واهم”، ولكنَّ ذلك ارتسمَ دائمٍا على سيمائهم.
على الرُّغم من ذلك اطلَقنا “كنيسة الفادي المَشيَخيَّة”. وفي أواخر سنة 2007 كان عددُ الحضور قد تخطَّى 5000 شخص، وقد أفرخَتِ الكنيسة بضعَ عشرةَ رعيَّةً تابعةً لها في مناطق مجاورة من المدينة. وهذه الكنيسةُ مُتعدِّدةُ الأعراق، ونسبةُ الشباب فيها كبيرةٌ (متوسِّط العُمر فيها ثلاثون سنة تقريًبًا)، يُشكِّل العازبون أكثرَ من ثُلثَيها. وفي أثناء ذلك نشأتْ عشراتُ الكنائس ذات العقائد العريقة المُماثِلة، ومئاتٌ غيرها، في أنحاء الأقسام الإداريَّة الأربعة الأخرى من المدينة. وقد بيَّنتْ إحدى الدِّراسات أنَّه في بضعة الأعوام الخيرة تأسَّست أكثرُ من مئة كنيسة في مدينة نيويورك على أيدي مسيحيِّين من افريقيا وحدَها، الأمرُ الذي أذهلَنا كما أذهل سوانا.
وليست نيويورك وحدَها في ذلك. ففي خريف عام 2006، أدرجت مجلَّة “ذي إيكونومِست” (The Economist) تقريرًا عنوانُهُ الفرعيُّ “المسيحيَّة تنهار في كلِّ مكان ما عدا لندن” (Christianity is Collapsing Everywhere but London). وكان بَيت القصيد في تلك المقالة أنَّه على الرُّغم من حقيقة كَونِ حضور الكنائس والاعتراف بالإيمان المسيحيِّ آخذَين في الهُبوط عموديًّا عبر بريطانيا وأوروبا، كان كثيرون من أصحاب المِهَن الشباب (والمُهاجرين الجُدد) في لندن يَتقاطرون إلى كنائس إنجيليَّة.[8] وذلك تمامًا هو ما أزالُ أشهدُه هنا.
هذا الأمر يؤدِّي إلى استنتاج غريب. فقد وصلْنا إلى لحظةٍ حضاريَّة فيها يشعر الشُّكوكيُّون والمؤمنونَ جميعًا بأنَّ وجودَهم في خَطَر؛ لأنَّ الشُّكوكيَّة الدُّنيويَّة والإيمان الدينيِّ يشهدان كلاهما تقدُّمًا مُطَّردًا على أصعدة قويَّة بارزة. وليس لدينا الآن مسيحيَّةُ[9] اوروبا الماضيَّةُ ولا المجتمعُ الدُّنيويُّ الَّلادينيُّ الذي سبقَ التنبُّؤُ بنشوئه مُستقبلاً، بل إنَّ لدينا شيئًا آخر مختلفًا كلَّ الاختلاف.
ثقافة منقسِمة
قبل ثلاثة أجيال، كان معظم الناس يَرِثون إيمانَهم الدينيَّ بدلَ أن يختاروه بأنفسهم. وكان السَّواد الأعظم من الناس ينتمون إلى واحدةٍ أو غيرها من الكنائس البروتستانتيَّة التاريخيَّة العريقة. أو إلى الكنيسة الكاثوليكيَّة ومثيلاتها. أمَّا اليوم؛ فإنَّ الكنائس البروتستانتيَّة ذات الإيمان المتوارث والثقافة المُتَّبعة، تلك التي باتَ يُطلَق عليها تعبيرُ “كنائس الخطِّ القديم”، تَهرمُ وتخسرُ أعضاءَها بسرعة. والناس يختارون، بدلاً من ذلك، حياةً لا دينيَّة، أو روحانيَّة مُنشأةً ذاتيًّا وغير تابعة للمؤسسات القائمة، أو جماعات دينيَّةً عريقةً تُشدِّد على الالتزام الدقيق وتتوقَّع من اعضائها حُصولَهم على اختبار “التجديد”، أو الولادة الجديدة. وعليه، فإنَّ الناس صائرون – على طرفَي نقيض- إمَا أكثر تديُّنًا وإمَّا أقلَّ تديُّنًا في آنٍ معًا.
ولمَّا كان الشكُّ والإيمان كلاهما آخِذَين في التقدُّم، فإنَّ حديثَنا السياسيَّ والعامَّ في شؤون الإيمان والأخلاق قد بات في ورطةٍ ومُنقسمًا في العُمق. والحروبُ الثقافيَّة حاميةُ الوطيس، حيث المشاعرُ مُتأجِّجة والخُطَب ناريَّة، بل هستيريَّة أيضًا. فاللذين يؤمنون بالله والمسيحيَّة مُنطلقون كي “يفرضوا معتقداتهم على الآخرين” و “يرجعوا عقارب الساعة بالعكس” إلى زمان أقلَّ تنويرًا. والذين لا يؤمنون هم “أعداء الحقّ” و “الممَوِّنون الرئيسيُّون للنِّسبيَّة والإباحيَّة”. ونحنُ لا نحاجُّ الفريقَ الآخر بل نشجبُ ونُندِّد.
لدينا طريقٌ مسدودٌ بين قوى الشكِّ والإيمان المُزدادة قوَّةً، ولن يُحَلَّ هذا بمجرَّد الدَّعوة إلى مزيدٍ من الكياسة والحوار. فإنَّ المُجادلات تتوقَّف على حيازة نقاطٍ مرجعيَّة مقبولة عمومًا يستطيع كِلا الفريقَين أن يُحيلَ الآخر إليها. وحين تتضاربُ مفاهيمُ الحقيقةِ الجوهريَّةُ، يَصعبُ العثورُ على أيِّ شئ يُعوَّل عليه. وخير تعبيرٍ عن ذلك عُنوانُ كتابِ ألسدَير ماكإنتاير (Alasdair Macintyre) “عدالةُ مَن؟ أيَّةُ عقلانيَّة؟” (Whose Justice? Which Rationality?). فمشاكلنا لن تَتبدَّد بسهولة.
كيف يَسَعُنا أن نجدَ طريقًا نمضي فيه إلى الأمام؟
أوَّلاً، ينبغي لكِلا الطَّرفَين أن يُقِرَّا بأنَّ الإيمانَ الدينيَّ والشُّكوكيَّة كلَيهما يتعاظمان. فعلى الكاتب المُلحِد سام هَرِس (Sam Harris) وقائد حركة اليمين الدينيِّ المتطرِّف (Religious Right) پات روبرتسون (Pat Robertson) يعترفا كلَيهما بأنَّ جماعتَه قويَّةً ومُزدادةً في التأثير. ومن شأن هذا أن يُقصيَ الحديث الذاتيَّ المُستشري في المُعَسكرَين كلَيهما، وأعني القولَ إنَّ المعسكر ذاك سيَصير بائدًا عن قريب إذ يَكتسحه المُعسكرُ المُعارِض. إنَّما لا شيء من ذلك مُمكنٌ بصورة وشيكة. وإن كفَفنا عن قول أمورٍ من هذا النَّوع لأنفسنا، فقد يجعلُ ذلك كلَّ واحدٍ أكثر لُطفًا وسعةَ صدرٍ تُجاهَ الآراء المُناقِضة.
ثُمَّ إنَّ إقرارًا كهذا ليس مُطَمئنًا فحسب، بل يدفعُ إلى الاتِّضاع ايضًا. فما زال كثيرون من ذوي العُقول ذات المنحى الدُّنيويِّ يقولون واثقين إنَّ الإيمانَ المستقيمَ يحاولُ عبثًا “مقاومةَ مدِّ التاريخ”، رُغمَ عدم وجود أيِّ دليلٍ تاريخيِّ على أنَّ الدِّين يتلاشى. وعلى المؤمنين بالدِّين أيضًا أن يكونوا أقَلَّ نبذًا للشكوكيَّة والدُّنيويَّة. إذ ينبغي للمسيحيِّين أن يتفكَّروا في حقيقة كَون قِطاعات كبيرةٍ جدًّا من المُجتمعات التي غلبَتْ عليها سابقًا الصبغة المسيحيَّة قد أدارَتِ القَفا للإيمان. ولا بُدَّ أن يؤدِّي ذلك إلى فَحْصِ الذات. فقد ولَّى زمانُ التلميح المُتأدّب بِرَفض الفريق الآخر. وبِتنا الآن في حاجةٍ إلى ما يتخطَّى ذلك … لكنْ ما هو؟
نظرةٌ ثانيةٌ إلى الشكّ
أودُّ أن أقدِّمَ اقتراحًا لمستُ ما آتاه من ثمرٍ كثير في حياةِ الشباب النيويوركيِّين على مرِّ السِّنين. فأنا أوصي كِلا الفريقَين بالنَّظر إلى الشكِّ بطريقةٍ جديدة جَذريًّا.
ولْنَبدأْ بالمؤمنين. إنَّ إيمانًا لا تُساوِرُه بعضُ الشُّكوك يُشبِهُ جسمًا بشريًّا ليست فيه أجسام مُضادَّة. فالأشخاصُ الذين يسلُكونَ سبيلهم في الحياة بابتهاج؛ وهُم أكثرُ انشغالاً أو لا مُبالاةً من أن يطرحوا أسئلةً صعبةً عن أسباب إيمانهم بما يؤمنون به، سيَجدون أنفُسهم بِلا دفاع عندما يُواجِهون إمَّا اختبارًا مأساويًّا وإمَّا أسئلةً فاحصة من قِبَل شكوكيّ ذكيّ. ورُبَّما انهار إيمانُ شابَّةٍ بين عشيَّةٍ وضُحاها تقريبًا إنْ كانتْ قد أخفقَتْ على مرِّ السنين في الإصغاء برَوِيَّةٍ إلى شكوكها الخاصَّة التي لا ينبغي نَبذُها إلَّا بعد كثير من التفكير.
فعلى المؤمنين أن يعترفوا بالشُّكوك ويُكافحوها – ليس شكوكهم فقط بل شكوك أصدقائهم وجيرانهم أيضًا. إذ لم يعُدْ كافيًا ووافيًا أن تَتَمسَّك بمُعتقداتٍ فقط لأنَّك ورثْتَها. وحين تخوضُ صراعًا طويلاً ومريرًا مع الاعتراضات الموجَّهة إلى إيمانك، حينئذ فقط تغدو قادرًا على بَسْط أسُس لمعتقداتك أمام الشَّكَّاكين – بِمَن فيهم أنت نفسُك – تكون معقولةً ظاهريًا، لا سخيفةً أو مزعجة. ومُهمٌّ كذلك أيضًا بالنِّسبة إلى وضْعٍنا الحاليِّ أنَّ عمليِّةً كهذه ستُؤدِّي بك إلى احترامِ الذينَ يَشكُّون وإلى تفهُّمهم، حتَّى بعدَ بُلوغكَ مَوقعَ إيمانٍ قويّ.
ولكنْ مثلما ينبغي للمؤمنين أن يتعلَّموا التفتيشَ عن أسبابٍ كامنةٍ وراءَ إيمانهم، كذلك يجب على الشَّكَّاكين أيضًا أن يتعلَّموا البحثَ عن نوعٍ من الإيمان مَخبوءٍ داخلَ تعليلاتهم. ذلك أنَّ جميع الشُّكوك هي في الواقع مجموعةُ معتقداتٍ بديلة، مهما بَدَتْ شُكوكيَّةً وساخرة.[10] فليس في وُسعك أن تشكَّ في المُعتقَد “أ” إلّا من مَوقع إيمانٍ بالمُعتقد “ب”. مثلاً، إذا شككتَ في المسيحيَّة لأنَّه “لا يمكن أن تُوجَد فقط ديانةٌ حقيقيَّة واحدة”، وجبَ أن تُدركَ أنَّ تصريحَك هذا هو بحدِّ ذاته فِعلُ إيمان. فلا أحدَ يستطيع البرهنة على هذه المقولة تجريبيًّا، وهي ليست حقيقةً شاملةً يقبلُها كلُّ إنسان. وإن ذهبتَ إلى الشَّرقِ الأوسط مثلاً وقُلت: “لا يُعقَل أن توجَدَ ديانة حقيقيَّة واحدة فقط”، فمن شأن كلِّ إنسان تقريبًا أن يقول: “ولِمَ لا؟” فإنَّ السبب الذي يحملك على الشكِّ في مُعتقَد المسيحيَّة “أ” هو أنَّك تعتنقُ المعتقدَ “ب” غير المُبَرهَن. من هنا كان كلُّ شَكٍّ مؤسَّسًا على قفزة إيمان.
يقولُ بعضُهم: “لستُ أومن بالمسيحيَّة لأنِّي لا أستطيعُ أن أقبلَ وجودَ مُطلَقاتٍ أخلاقيَّة. فينبغي لكلِّ فرد أن يُحدِّد الحقيقةَ الخُلُقيَّةَ لنَفسه”. فهل تلك مَقولةٌ يستطيعون برهنَتها لشخص لا يُشارِك فيها؟ لا، بل هي قفزةُ إيمان، اعتقادٌ راسخٌ أنَّ الحقوق الفرديَّة لا تعملُ فقط في الدائرة السياسيَّة بل أيضًا في الدائرة الخُلُقيَّة. فليس من برهانٍ تجريبيٍّ لموقفٍ كهذا. وهكذا، فإنَّ الشكَّ (في المُطلَقات الأخلاقيَّة) هو قفزة إيمان.
ومن شأن بعضهم أن يُجاوِبوا عن هذا كلِّه بالقول: “إنَّ شكوكي ليسَت مؤسَّسةً على قفزة إيمان. فلا مُعتقدات لديَّ بشأن الله في هذا الاتِّجاه أو ذاك. وأنا إنَّما أشعرُ بعدم الاحتياج إلى الله، ولستُ مَعنيًّا بالتفكير في الأمر”. ولكنْ يختبئُ وراءَ هذا الشعور الاعتقاد الأميركيُّ الحديثُ جدًّا والقائلُ إنَّ وجودَ الله مسألةُ لا مُبالاةٍ إلاَّ إذا تقاطَعتْ مع حاجاتي العاطفيَّة. فالمُتكلِّم يُراهِن بحياته على عدم وجود إلهٍ يُحاسبُك على معتقداتك وسلوكك إن كنتَ لا تشعر بالاحتياج إليه. وقد يكون هذا صحيحًا أو لا يكون. ولكنَّه أيضًا قفزةُ إيمان بكلِّ ما تحمل الكلمة من معنى.[11]
إنَّ الطريقةَ الوحيدةَ للشك في المسيحيّةَ بحقٍّ وإنصاف هي أن تُميِّز المُعتقَد البديلَ في ضوء كلًّ من شكوكك، ثُمَّ أنْ تسألَ نفسَك أيَّةُ أسبابٍ لديك تدعوك إلى الإيمان به. وكيف تعرفُ أنَّ عقيدتَك صحيحة؟ إنَّه يكون أمرًا غير مُتناغِم أن تطلبَ لأجل العقيدة المسيحيَّة تبريرًا يفوق ما تطلُبه لأجل عقيدتك الخاصَّة، ولكنَّ ذلك هو ما يحدث أغلبَ الأحيان. فبالإنصاف يجب أن تشكَّ في شكوكك. وقَولي هو إنَّك إذا بتَّ تُميِّز المعتقداتِ التي تؤسِّس عليها شكوكَكَ بشأن المسيحيَّة؛ وإذا طلبتَ لهذه المعتقدات مثل ما تطلُبه للمسيحيَّة من براهين، فسيَتَبيَّن لك أ نَّ شكوكَك ليست صُلبةً كما بَدَت للوَهلة الأولى.
إنِّي أعهدُ إلى قُرَّائي بعمليَّتَين. فأنا أحثُّ الشكَّاكين على خَوض الصِّراع في مواجهة “الإيمان الأعمى” غير المُمتحَن ذاك الذي أسَّستِ الشُّكوكيَّة عليه، وعلى رؤية مدى الصعوبة البالغ في تبرير تلك المُعتقدات للَّذين لا يُشاركون فيها. كما أحثُّ المؤمنين أيضًا على خَوض الصِّراع في مواجهة اعتراضاتهم الشخصيَّة واعتراضات حضارتهم على الإيمان. وعند انتهاء العمليَّتين كلتَيهما، فحتَّى لو بقيتَ ذلك الشكَّاك أو المؤمن الذي كُنتَه، ستَكونُ مُتَمسِّكًا بموقفك بمزيدٍ من الوضوح والإتِّضاع معًا. ثُمَّ سيَكونُ لديك فهمٌ وتعاطُفٌ واحترامٌ تُجاه الطَّرَف الآخر الذي لم يكُن مَوجودًا من قبلٍ. فالمؤمنون وغير المؤمنين سيَرتَقون إلى مستوى الاختلاف في الرأي، بدلاً من مُجرَّد التَّنديد بعضهم ببعض. ويحصلُ هذا بعد أن يتعلَّمَ كلُّ طرَفٍ تمثيلَ حُجَّةِ الآخر في شكلِها الأقوى والأكثر إيجابيَّة. عندئذٍ فقط يكونُ عدمُ الاتِّفاق معها مأمونًا ومُنصِفًا. وهذا يُنشئُ الكياسةَ في مجتمع تَعَدُّديّ، وهي ليست أمرًا يسيرًا.
طريقٌ ثالثٌ روحيّ
إنَّ باقيَ هذا الكتاب هو تَقطيرٌ للمُحادَثات الكثيرة التي جرت بيني وبين الشَّكَّاكين على مرِّ السِّنين. وفي وعظي ومُقابلاتي الشخصيَّة على السواء، حاولتُ أن أساعِد الشُّكوكيِّين باحترامٍ على النَّظر إلى أساسات مُعتقداتهم الخاصَّة، فيما أبسِّط قدَّامهم في الوقت نفسه أساسات إيماني ليَتَناوَلوها بأقوى انتقاداتهم. ففي النِّصف الأوَّل من هذا الكتاب سنُراجع أكبرَ سبعة اعتراضات وشكوك بشأن المسيحيَّة سمعتُها من الناس على مرِّ السِّنين. وسوف أتبيَّن باحترامٍ المعتقداتِ البديلَة وراء كلًّ منها. ثُمَّ في النصف الثاني من الكتاب ننظر في الأسباب الكامنة في أساس المعتقدات المسيحيَّة.
يُشكِل الحوارُ المتَّسمُ بالاحترام بين المُحافظين التقليديِّين المُتحصِّنين والليبراليِّين اللَادينيِّين خيرًا عظيمًا، وأرجو أن يُعزِّزه هذا الكتاب. ولكنَّ اختباري بصفتي راعيًا لكنيسةٍ في نيويورك أمدَّني بحافز آخر على كتابة هذا المُجلَّد. فما إن قَدِمتُ إلى نيويورك حتَّى تبيَّن لي أن وَضْع الإيمان والشَّكِّ لم يكن كما اعتقدَه الخُبَراء. إذ إنَّ البِيضَ الأكبرَ سنًّا، والذين كانوا يُديرون الشأنَ الثقافيَّ في المدينة تحديدًا، كانوا لا دينيِّين إلى أقصى الحدود. ولكنِ انتشَرت بين المِهَنيِّين الأصغر سنًّا، المتعدِّدي الأعراق والذين تتزايد أعدادهم، ومُهاجري الطبقة العاملة، تشكيلةٌ غنيَّة من المعتقدات الدينيَّة القويَّة تتخطَّى التَّصنيفات. وقد كانت المسيحيَّة، على وجه الخُصوص، آخذةً في النُّموِّ بسرعة بين هؤلاء.
أعتقد أنَّ هؤلاء المسيحيِّين الأكثر شبابًا هم طليعةُ تشكيلاتٍ دينيَّة واجتماعيَّة وسياسيَّة جديدة يمكن أن تجعلَ الشَّكل القديمَ من الحروب الحضاريَّة بائدًا. فبعدَ أن يخوضَ الكثيرون صراعًا مع الشكوك والاعتراضات التي تتعرَّض لها المسيحيَّة، يخرجون من الجهة الأخرى بإيمانٍ قويم لا يخضعُ للتَّصنيفات الجارية التي تفصلُ بين ديمقراطيٍّ ليبراليٍّ وجمهوريٍّ مُحافِظ. ويرى كثيرون أنَّ الطَّرفَين كليهما في “الحرب الحضاريَّة” يجعلان الحرِّيَّة الفرديَّة والسعادة الشخصيَّة هُما القيمةَ القُصوى بدلاً من الله والخير العامّ. فإنَّ فَردانيَّة الليبراليِّين تَبرزُ في آرائهم بشأن الإجهاض والجنس والزَّواج.
فيما تبرز فردانيَّة المُحافظين في عدم ثقتهم البالغ بالقطاع العامّ، وفي فهمهم للفقر باعتباره مجرَّد إخفاقٍ في المسؤوليَّة الشخصيَّة. أمَّا المسيحيَّة القويمة المُتعدِّدة الأعراق، والآخذةُ في الانتشار بسرعة في المُدن، فهي تُعنى بالفقراء والعدالة الاجتماعيَّة عنايةً تفوق كثيرًا جدًّا ما درج الجمهوريُّون عليه، كما تُعنى في الوقت عينه بإعلاء شأن الأخلاقيَّات المسيحيَّة المعهودة والأخلاق المُتعلِّقة بالجنس عنايةً تفوقُ كثيرًا جدًّا ما درجَ عليه الديمقراطيُّون.
وبينما يعرضُ النِّصفُ الأوَّل من الكتاب سبيلاً سلَكَه كثيرون من هؤلاء المؤمنين بالسيِّد المسيح عبرَ الشَّكّ، يُشكِّلُ النِّصف الثاني من الكتاب عَرضًا أكثر إيجابيَّةً للإيمان الذي يعيشونه في العالَم. وإليك تعرفًا بثلاثةِ أشخاصٍ في الكنيسة الآن.
كانت جُون (June) خرِّيجةَ إحدى جامعات آيڤي لِيغ (Ivy League)[12]، تُقيم وتعمل في مَنهاتن. وقد استحوذ عليها هاجسُ صورتها البَدَنيَّة جدًّا حتَّى نشأت لديها اضطراباتٌ تغذويَّة وإدماناتٌ مادِّيَّة. وباتت تُدرك أنَّها مُتَّجهة نحو الانتحار، ولكنَّها أدركتْ أيضًا عدمَ وجودِ سببٍ مُعيَّن لديها يحملها على الإقلاع عن تدمير حياتها. وبَعدُ، ماذا كانت حياتُها تعني؟ ولماذا لا تسلكُ سبيل الانتحار؟ ثُمَّ بعد ذلك، أقبلَتْ إلى الكنيسة والْتَمسَتْ فَهمًا لِرَحمةِ الله واختبارًا لحقيقته. وقد قابلَتْ مُرشدًا في الكنيسة ساعدَها على إقامة رابطٍ بين رحمة الله وحاجتِها إلى القبول التي يبدو أنَّها لا تنفَذُ. وفي الأخير تأتَّتْ لها الثقة لالتِماس لقاءٍ بالله نفسِه. ورغم أنَّها لا تستطيعُ أن تُحدِّدَ بدقَّةٍ لحظةً معيَّنة، باتت تشعر – وللمرَّة الأولى في حياتها – بأنَّها “محبوبةٌ محبَّةً غير مشروطة بِوَصفها ابنةً حقيقيَّةً لله”. وبالتدريج، نالتِ التَّحرُّر من هواجسِها الانتحاريَّة.
وكان جَفري (Jeffrey) موسيقيًّا من مدينة نيويورك، تربَّى في بيت يهوديٍّ مُحافِظ. وقد عانى أبواه كلاهما معاناةً رهيبة من جرَّاء السَّرطان، ثُمَّ ماتتْ أمُّه بعد مدَّة بالسَّرطان.
وبسبب بضعة أمراضٍ صحِّيَّة ابتُلى بها منذ حداثته، لجأ إلى ممارسات فنون الشِّفاء الصِّينيَّة، فضلاً عن التأمُّل التاويَّ والبُوذيّ (في بعض الديانات الشرقيَّة)، وصار بالغَ التركيز على الصِّحَّة الجسديَّة. ولم يَكُنْ في حالةِ “احتياج روحيّ” لمَّا بدأ أحد أصدقائه باصطحابه إلى كنيسة الفادي.
وقد راقَتْه العظات، حتَّى “إذا جرى التطرُّق في آخرها إلى الشأن المتعلِّق بالسيِّد المسيح” كان يكفُّ عن الاستماع إذ ذاك. ولكنَّه سرعانَ ما صارَ إلى حدٍّ ما يَغارُ من أصدقائه المسحيَّين لفَرحهم ورجائهم المستقبليِّ اللذين لم يَعهدْهما قبلاً. ثَمَّ بدأ يُصغي إلى خاتمة كلٍّ من العِظات، فأدركَ أنَّها تطرحُ تحدِّيًا عقلانيًا لم يكُنْ يريدُ أن يواجهَه. وممَّا أدهشَهُ أخيرًا أنَّه في أثناء أوقات تأمُّله تبيَّن له أنَّ “لحظاتِ صفائه وهدوئه الخالصةَ عادةً كانت تُقاطعُها باستمرار رؤًى يظهر فيها السيِّد المسيح مصلوبًا”. فبدأ يُصلِّي إلى إله المسيحيَّة، وأدركَ سريعًا أنَّ قصَّةَ حياته المُهيمنةَ ما تزال تدورُ حول الفرار من الألَم وتجنُّبه كلِّيًّا. آنذاك أدرك مدى عُقمِ مثلِ هذا الهدف في الحياة. ولمَّا أدركَ أنَّ السيِّد المسيحَ قد سلَّم صحَّته وحياته لأجل خلاص العالَم – وخلاص جَفري نفسِه أيضًا – أثَّر فيه ذلك أعمقَ التأثير. وهكذا رأى سبيلاً إلى الحصول على الشجاعة لمواجهة مُعاناة المستقبل التي لا مفرَّ منها، وإلى التيقُّن بأنَّ دربَ اجتيازها سيَكونُ متاحًا. ومن ثَمَّ قَبِلَ إنجيلَ يسوع المسيح وأخبارَه السارَّة.
وكانت كَلي (Kelly) مُلحِدةً تعتنق مبادئ آيڤي لِيغ. ولمَّا كانت في الثانيةَ عشرةَ من عمرها، راقبَتْ جدَها يموت بالسَّرَطان، وأختَها ابنةَ السنتَين تخضع للجراحة والعلاج الكيمياويِّ والإشعاعيِّ بسببِ وَرَم دماغيّ. ولمَّا صارتْ طالبةً للشهادة الأولى في جامعة كولومبيا، كانت قد فقدَتْ كلَّ أملٍ بوجود أيِّ معنىً للحياة. وقد حدَّثَها بعضُ أصدقائها المؤمنين في الجامعة بشأن إيمانهم، ولكنَّ قلبَها كان “أرضًا صخريَّة” بالنسبة إلى بذار شهاداتهم. غير أنَّه لمَّا أصيبتْ أختُها بسكتةٍ دماغيَّة وصارت مشلولةً وهي في الرابعةَ عشرة، لم يدفعْها ذلك للاستسلام من جهة الله، بل بالأحرى إلى مباشرةِ مزيدٍ من البحث الهادف. ولكنَّها كانتْ آنذاك تُقيمُ وتشتَغلُ في المدينة، حيثُ التَقَتْ زَوجها المستقبليَّ كيڤن (Kevin)، وكان قد تخرَّج في جامعة كولومبيا، كما كان مُلحِدًا، يعمل في وول ستريت لدى جاي. پي. مورغَن (J. P. Morgan). وقد كانت شكوكُهما بشأن الله مُستعصِيةً جدًّا، ومع ذلك ساورَتْهما شُكوكٌ بشأن شُكوكِهما، وهكذا بدأ يحضران خدماتِ كنيسةِ الفادي. وكانت رحلتُهما نحو الإيمان بطيئةً وشاقَّة. إنَّما كان من الأمور التي أبقَتهما على الخَطِّ ذلك العددُ الكبير الذي قابلوه من المسيحيِّين المؤمنين الذين لم يكونوا يَقلُّون في شئٍ عن أيِّ مثقف ذكيٍّ آخر قابلوه في المدينة.
وأخيرًا اقتَنَعا ليس فقط بصدقيَّة المسيحيَّة فكريًّا، بل جذبَتْهما أيضًا رؤياها بشأن الحياة. وقد كتَبت كَلي: “لمَّا كنتُ مُلحدةً، خُيِّل إليَّ أنِّي أعيشُ نوعَ حياةٍ خُلُقيًّا موجَّهًا بمُقتضى مَصلحة الجماعة ومَعنيًّا بالعدالة الاجتماعيَّة، ولكنِّي وجدتُ في المسيحيَّة معيارًا أسمى بَعدُ، يمسُّ أعماقَ أفكارنا وحالةَ قلوبنا. فقبلْتُ غفرانَ الله ودَعَوتُه إلى داخل حياتي”. وكتب كيڤن: “بينما كنتُ جالسًا في مقهى أقرأ “المسيحيَّة المجرَّدة”[13] (Mere Christianity) بقلم سي. أس. لويس (C. S. Lewis)، وضعتُ الكتابَ جانبًا وكتبتُ في مفكِّرتي “إنَّ البيِّنات التي تحيطُ بدعاوى المسيحيَّة دامِغةٌ حقًّا”. لقد تبيَّنَ لي أنَّ إنجازاتي كانت غير مُرضِيةٍ كلِّيًّا، واستحسانَ الإنسانِ عابرٌ وزائل، وأنَّ حياةَ الاستمتاع الوقتيِّ التي نعيشها فقط في سبيل المغامرة هي مجرَّدُ شكلٍ من أشكال النَّرجسيَّة[14] وعبادةِ الأصنام. وهكذا صرتُ مؤمنًا بالسِّد المسيح”.[15]
السيِّدُ المسيحُ وشُكوكُنا
ثُمَّ إنَّ شهادةَ كَلي تَستَذكرُ كيف كان المقطعُ الذي يتحدَّثُ بشأن تُوما في العهد الجديد تعزيةً لها، وهي التي خاضَتْ صراعها في مواجهة الشكِّ والإيمان. هناك رسمَ السيٍّدُ المسيحُ نموذجًا لنظرةٍ في الشكِّ أغنى معنًى من نظرات الشُّكوكيِّين العصريِّين والمؤمنين المعاصرين على السَّواء. فلمَّا واجه السيِّد المسيحُ “تُوما الشَّكَّاك” حثَّه على عدم الإذعانِ للشَّكِّ (“لا تكُن غير مؤمنٍ بل مؤمنًا!” يوحنَّا 20: 27)، إلاَّ أنَّه استجابَ أيضًا لِطَلبه بتقديم دليلٍ إضافيّ. وفي حادثةٍ أخرى، قابَلَ السِّد المسيحُ رجلاً اعترَفَ بأنَّه مُمتلئٌ شكوكًا (مرقس9: 24) إذ قال له: “أعِنْ عدم إيماني” – ساعِدْني على شكوكي! وتجاوُبًا مع هذا الاعتراف الصادق، بارَكَه السيِّدُ المسيحُ وشفى ابنه. فسواءٌ حسبتَ نفسَك مؤمنًا أم شكَّاكًا، فإنِّي أدعوكَ إلى توخِّي هذا النَّوع من الصِّدق، وإلى النُّموِّ في فَهْم طبيعةِ شكوكِكَ الخاصَّة. ولَسَوفَ تَفوقُ النتيجةُ كلَّ شئٍ تستطيعُ أن تَتَصوَّرَه.
[1] See the report” One in Three Adults Is Unshurched” (March 28, 2005) At The George Barna Group في أوروبا، انخفض عدد الذين لا يحضرون اجتماعات الكنائس انخفاضاً أكثر حدة، فيما حل معدل حضور الكنائس في إنكلترا في مرتبة وسط. See Grace Davie, “Europe: The Exception that proves the Rule?” In Peter L Berger, ed. The Desecularaization of the world: Resurgent Religion and world politics (Eerdmans, 1999) and peter Brierly, The Tide is Running Out (Christian Research,2000).
[2] Ross Douthat, “Crises of Faith,” The AtlanticMonthly, July/Agust 2007
[3] George Marsden, The Soul of the American University; From Protestant Establishment to Established Non-belief (oxford University press, 1999).
[4] Source: Peter Berger at the pew Fortum Faith Angle Conference, “Religion in a Globalizing World,” December 4, 2006, Key West, Florida. Transcript accessed at http://pewfortum.org/events/index.php?Event ID=136. See alsoDouthat, “Crisesof Faith, The Atlantic Monthly (July/Augst2007). يعتمد داوتاهات المعطيات عينها التي يلحظها برغر مبيناً على خلاف الانطباعات الواسعة انتشاراً أن أوروبا آخذة أن تصير أكثر تديناً، في حين تصير أمريكا أعمق انقساماً بين الديني والدنيوي. وهو يقول إن كلتا النزعتين هاتين تعنيان الاستمرار الصراع الثقافي والسياسي والتطرف في كلا الجانبين.
[5] .”Defending the Faith,” by Douglas G roothuis, Books and Culture (July/Augst2003): 12. See Quentin Smith, “The Metaphilosophy of Naturalism,”philo 4, no.2 atwww.philosoonline.org/library/smith_4_ 2.htm. (The Society of Christian philosophers) اليوم، جمعية فلاسفة المسيحيين، وقد أسست سنة 1978، تضم أكثر من10% من جميع معلمي الفلسفة وأساتذتها في أمريكا For more on this K.Clark, philosophers Who Believes (oxford university press).
[6] One University Under God?” The Chronicle of Higher Education: Careers, January 7, 2005.
[7] For a good Overview, read the entire transcript of the peter Berger led pew Fortum referenced above.
[8] .”A New Jerusalem, “The Economist, September 21, 2006.
[9] تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ المؤلِّفَ استخدَم الكلمةَ الإنكليزيَّة (Christendom) والتي تحمل معنى المسيحيَّة كنظام مؤسَّسيّ، وليس الكلمةَ الإنكليزيَّة (Christianity) والتي تعبِّر عن المسيحيَّة كإيمانٍ ومُعتقداتٍ جوهريَّ (الناشر).
[10] من المتفق عليه غالباً أن ” الحقيقة” هي إما شيء جلي بذله للجميع تقريباً (مثلاً،” في الطريق صخرة” ) وإما شيء لا تدركه الحواس ولكن يمكن إثباته علمياً. فإن اعتقدنا شيئاً لا تمكن برهنته بإحدى هاتين الطريقتين، فهو عندئذ “معتقد ” أو فعل إيمان.
[11] For a good short Summary of why we are all” believers,”see Christian Smith, “Believing Animals,” Moral Believing Animals: Human person hood and Culture (oxford University press, 2003).
[12] هو تجمُّعٌ لثَماني مؤسَّساتٍ أكاديميَّةٍ مَرموقةٍ في الشمال الشرقيّ للولايات المتَّحدة منها جامعتَا هارڤارد (Harvard) ويال (Yale). يتضمَّن هذا المصطلحُ أيضًا التميُّزَ الأكاديميَّ، والشروطَ الصارمةَ في اختيار الطلَّاب، كما يعكسُ كَونَ خرّيجيها من النُّخَبِ الاجتماعيَّة (الناشر).
[13] كتابُ “المسيحيَّة المجرَّدة” أحدُ منشورات أوفير للطباعة المتخصِّصة والنشر (الناشر).
[14] نسبة إلى نارسيس (Narcissus) في الميثولوجية الإغريقيَّة الذي كان مغرِقًا في الإعجاب بنفسه حتَّى إنَّه غرقَ في بحيرةٍ كان يرى فيها انعكاسَ صورته، بينما كان يُحاولُ الاقتراب من تلك الصورة. ويُقال إنَّ شخصًا ما نرجسيِّ حين يكون مُعجَبٍا بِذاته جسديًّا، ويُقال ذلك مجازًا في المعجَب بأفكاره وآرائه أيضًا (الناشر).
[15] Each Easter at redeemer we ask members to share the personal accounts of their faith journeys. These are a selection from Easter 2006 .Used with permission.


